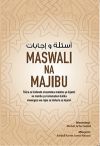المفاهيم الأخلاقيّة قيم مشتركة بين الديانات

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾[1] .
يمثّل الاهتمام بالفضائل والأخلاق قاسماً مشتركاً بين جميع الديانات، فالديانات على اختلافها، ومنها الديانات السماويّة المعروفة، كاليهوديّة، والمسيحيّة، والإسلام، والذي هو آخر الأديان وخاتمها، وكذا الديانات الأخرى كأديان الحضارات القديمة نظير: ديانة المصريين القدامى، أو الأديان الهنديّة كالهندوسيّة والبوذيّة، وكذا أديان الشرق الأقصى كالطاويّة والكونفوشيوسية في الصين والشنتوية في اليابان، في كل هذه الديانات يشكلّ موضوع الاهتمام بالفضائل والأخلاق قاسماً مشتركاً بين جميع هذه المنظومات الأربع من الديانات حسب تصنيف مؤرخي الأديان.
فليس هناك من ديانة إلا وهي تدعو أتباعها إلى القيم الأخلاقيّة على اختلاف في التفاصيل والتطبيقات سعةً وضيقاً، لكن ذلك يشكّل قاسماً مشتركاً، فلا توجد ديانة تبيح قتل النفس المحترمة، ولا توجد ديانة تبيح الكذب والخيانة، كما لا توجد ديانة تسمح بالظلم والجور، بل إن كلّ الديانات بغض النظر عن أصل صحّتها وبطلانها، تمجّد القيم الأخلاقيّة، وتحذّر من القبائح والعدوان وتشيد بالفضائل والقيم الأخلاقيّة بشكل عام، وهذا يدلّ على أن هناك منبعاً مشتركاً لهذه الديانات، رغم لحوق التحريف لبعضها أو عدم اتيانها من مصدر سماويّ مباشر، وإنما جاءت من بقايا ديانة سماويّة سابقة، كل هذا الأمر يدلّ على أن المنبع واحد هو الفطرة والوجدان، والوحي الإلهيّ؛ حيث لم يشأ الله سبحانه وتعالى لخلقه أن يعيشوا الضلال والتيه والضياع، ولذلك بعث إليهم الأنبياء والرسل.
إن معظم هذه الديانات قد جاءت على أيديّ الأنبياء والرسل، لكن لحق بها تشويه وتحريف، وبعض الديانات هي من بقايا آثار الوحيّ والرسالات السماويّة السابقة، ولأن المنبع مشترك نلاحظ الاهتمام بالفضائل والقيم الأخلاقيّة.
لقد أنكر البعض من مؤرخيّ الأخلاق العلاقة والارتباط بين القيم الأخلاقيّة والوحيّ، وأبرزهم الفرنسي (جيمس هنري برستيد) فقد نصّ في كتابه «فجر الضمير» على إنكار كون الوحيّ مصدراً للقيم الأخلاقيّة، مستدلاً على ذلك بما يوجد في الديانات المصريّة القديمة مثلاً من تعاليم أخلاقيّة، مع إنها سابقة لنزول التوراة بألفيّ سنة، وسابقة لميلاد السيد المسيح بأربعة آلاف سنة، وبالتالي سابقة لنزول الإنجيل[2] .
لكن هذا الاستدلال ليس دقيقاً؛ لأن الديانات لم تبدأ من التوراة والانجيل، بل الصحيح حسب اعتقادنا إن أوّل البشر ـ وهو آدم عليه السلام ـ كان نبيّاً، وإن الأنبياء توالوا في المجتمعات البشريّة كما يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا منهم أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...﴾[3] ، وقال تعالى: ﴿ وَإنْ مِنْ امَّةٍ الاَّ خَلا فيها نَذير﴾[4] .
فالأنبياء والرسل كانوا في الأمم القديمة، نعم غاية ما هناك عدم ذكر جميع الأنبياء في القرآن أو في الكتب السماويّة، ولعل بعض من تنتسب إليهم بعض الأديان هم أنبياء في واقع الأمر ربما، ولعل دياناتهم كانت من تراث الأنبياء في أممهم، ومن تاريخهم في عصورهم، وما هذه المشتركات بين الأديان إلا دليلاً على إن هناك منابع مشتركة، ومن هنا أشار القرآن الكريم إلى هذه النقطة بقوله تعالى:
﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[5] .
وقال تعالى:
﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾[6] .
كلّ هذا يؤشّر على وجود مشتركات بين الأديان ينبغي على معتنقيها البحث عنها، والتعاون فيها، والتمحور حولها، بدل أن يدخلوا فيما بينهم حروباً وصراعات ونزاعات.
إن الفضائل والقيم الأخلاقيّة تمثّل قاسماً مشتركاً بين الديانات، ولأن التزام الإنسان بالقيم الأخلاقيّة غالباً ما يصطدم بأهوائه وشهواته، فيكون متمرّداً ساحقاً لهذه القيم الأخلاقيّة ومتجاوزاً لها؛ لأنه ينطوي على رغبات وشهوات تدفعه لتجاوز الالتزام بالفضائل والقيم، وهذا هو المنشأ الأساس للتمرّد عليها، وليس ذاك نابعاً من عدم معرفته بها؛ بل إن وجدانه وضميره يهديه إليها، فلا يوجد من يجهل قبح الظلم والكذب، وحسن العدل والصدق، جميع الناس يعرفون ذلك بفطرتهم ووجدانهم، وإنما المشكلة في التطبيقات والتفاصيل، والموانع الشهوانيّة، التي تحول دون الالتزام بالقيم الأخلاقيّة.
من هنا جاءت الديانات للاهتمام بالبرامج «الترويضيّة والتهذيبيّة» التي تطوّع رغبات الإنسان، بحيث يكون مسيطراً على رغباته وشهواته، ولا تكون الرغبات والشهوات مسيطرة عليه؛ لأن خضوعه لذلك يعني الدفع به لتجاوز القيم والأخلاق.
ومن الوسائل المتبّعة في مختلف الديانات لترويض الإنسان للسيطرة على رغباته وشهواته هي: «الصوم»، فهو برنامج تدريبي ترويضيّ للشهوات والرغبات، إذ يمتنع الإنسان اختياراً أثناءه عن الأشياء التي يرغب فيها ويميل إليها، بل يحتاجها كالطعام والشراب.
ولذلك أشارت الآية الكريمة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ إلى أن الصوم ليست فريضة خاصّة بالمسلمين، بل يشمل أصلها جميع الديانات السابقة، ونشير هنا إلى أن الدين في الأصل واحد، وإنما الشرائع تختلف من نبيّ إلى آخر، ومن باب المجاز نعبّر بالديانات، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ...﴾؛ وقال تعالى:﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾[7] . نعم يستفاد من بعض النصوص الشريفة إن تخصيص شهر رمضان بهذه الفريضة هو من خصوصيّات الأمّة الإسلاميّة، يقول ابو عبدالله  : إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل الله به هذه الأمة، وجعل صيامه فرضاً على رسول
: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل الله به هذه الأمة، وجعل صيامه فرضاً على رسول وعلى أمته[8] .
وعلى أمته[8] .
والترويض النفسي عبر الصوم لا ينحصر في الديانات السماويّة فقط، بل حتى الديانات الأخرى نظير الهنديّة والصينيّة تجد فيها حضوراً لبرنامج الصوم؛ حيث تشجّع معتنقيها على ممارسته.
وخلاصة القول: قد تختلف أوقات الصوم وتشريعاته بين الديانات، إلا أن أصل الموضوع وهو الامتناع اختياراً عن الرغبات لزمن معين، فهو مشترك بين الديانات عموماً، والهدف منه هو التدرّب والترويض للسيطرة على الرغبات والشهوات.
إن صوم الإنسان عن الأكل والشرب والجنس والمفطرّات الأخرى، إنما يكون اختياريّاً، فنلاحظ العمّال المسلمين مثلاً، وصومهم في أيام الحرّ والصيف، إنما هو ترويض حقيقي للنفس، وهيمنة على الرغبات، أو نلاحظ صوم المسلمين في البلدان التي يطول فيها النهار فيحتاجون مقاومة شديدة للرغبات وصبراً على الصوم.
وقد أوضحت الحسابات الفلكيّة في هذا العام، إن مسلميّ أوربا هم الأعلى في عدد ساعات الصيام، حيث تصل إلى واحد وعشرين ساعة في بعض مناطقهم، وبذلك يكون الليل ثلاث ساعات فقط، بينما أقل عدد الساعات يكون في الأرجنتين، حيث تقدّر ساعات الصوم بتسعة ساعات ونصف فقط، أمّا في مناطقنا فالصوم يتراوح بين الاربعة عشر إلى خمسة عشر ساعة.
فالإنسان الذي يحبس نفسه عن جميع اللذائذ الشهوانيّة المفطرّة طيلة أحدى وعشرين ساعة، وفي تلك البلدان، التي ربما لا تساعد أجواؤها على الصوم، كما هو الحال في بلداننا؛ حيث لا يعيش الصائم هناك في إطار مجتمع صائم، يمنحه القوّة والاستمراريّة من خلال الأجواء المشجعة، أقول من يصوم طيلة هذه الفترة لا شكّ بأنّ له أجراً وثواباً عظيماً عند الله عزّ وجلّ، وفي مثل هذه الأجواء يتمظهر الغرض الأساس من الصوم، وهو السيطرة على الرغبات والشهوات، وإن الإنسان لا يكون مندفعاً مع رغباته وشهواته.
لذلك ورد في خطبة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عن حكمة الصيام، بأن فرضه: «تَثْبِيتاً لِلْإِخْلَاصِ»[9] .
وعن عليّ عليه السلام: «وَالصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ»[10] .
ومن هنا جاءت النصوص في فضل الصوم لكونه ينميّ في الإنسان هذه الملكة.
وأشارت الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ إلى هذا الهدف السامي؛ حيث جعلت التقوى مقصداً وملاكاً لعل الإنسان من خلال الصوم وحبس نفسه عن الملذات وترويضها يتوفر على تلك الملكة.