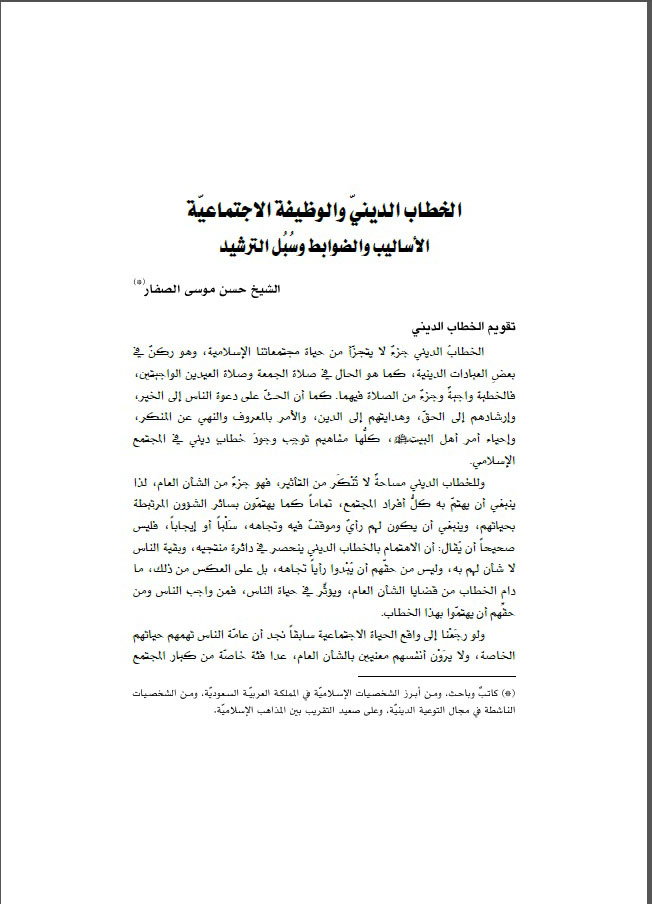الخطابُ الديني والوظيفة الاجتماعية
تقويم الخطاب الديني
الخطابُ الديني جزءٌ لا يتجزأ من حياة مجتمعاتنا الإسلامية، وهو ركن في بعضِ العبادات الدينية، كما هو الحال في صلاة الجمعة وصلاة العيدين الواجبتين، فالخطبة واجبة وجزءٌ من الصلاة فيهما. كما أن الحث على دعوة الناس إلى الخير، وإرشادهم إلى الحق، وهدايتهم إلى الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء أمر أهل البيت ، كلُّها مفاهيم توجِب وجودَ خطابٍ ديني في المجتمع الإسلامي.
، كلُّها مفاهيم توجِب وجودَ خطابٍ ديني في المجتمع الإسلامي.
وللخطاب الديني مساحةٌ لا تُنكر من التأثير، فهو جزءٌ من الشأن العام، لذا ينبغي أن يهتم به كلُّ أفراد المجتمع، تماماً كما يهتمون بسائر الشؤون المرتبطة بحياتهم، وينبغي أن يكون لهم رأيٌ وموقفٌ فيه وتجاهه سلباً أو إيجاباً، فليس صحيحاً أن يقال: أن الاهتمام بالخطاب الديني ينحصر في دائرة منتجيه، وبقية الناس لا شأن لهم به، وليس من حقّهم أن يبدوا رأياً تجاهه، بل على العكسِ من ذلك، ما دامَ الخطاب من قضايا الشأن العام، ويؤثر في حياة الناس، فمن واجب الناس ومن حقهم أن يهتموا بهذا الخطاب.
ولو رجعنا إلى واقع الحياة الاجتماعية سابقًا، نجد أن عامة الناس تهمهم حياتهم الخاصة، ولا يرون أنفسهم معنيين بالشأن العام، عدا فئة خاصة من كبار المجتمع وزعامته، فإنهم يرون أنفسهم المعنيين بذلك، أمّا الآن فقد تغيّر الواقع الاجتماعي، وأصبحنا نرى أنّ الاهتمام بالشأن العام اتسعت رقعته في المجتمعات، بسبب ارتفاع مستوى التعليم، وانتشار المعرفة، وزيادة ثقة الناس بأنفسهم، وقدرتهم على التعبير عن آرائهم، عبر وسائل الأعلام والتواصل الحديثة، التي أتاحت لكلّ إنسان أن يعبّر عن رأيه وينشره في أوسع نطاق، وهذا يعني أنّه من الطبيعي حصول حالة النقد والتقويم للخطابِ الديني.
إضافةً لذلك: هناك قِوىً وتياراتٌ مخالفة للاتجاه الديني، تترصد ما تراهُ أخطاءً وثغراتٍ في الخطاب الديني، وتبثها في المجتمع، من أجل إضعاف تأثيره وإضعاف ثقة الناس به، وهذا أمرٌ طبيعي في ساحات الصراع والمنافسة بين التوجهات والتيارات.
وأساسًا فإن الخطاب الديني أداءٌ بشري في مضمونه وأسلوبه، وما دام كذلك فهو غير معصوم عن الخطأ والضعف، لأن العصمة محصورةٌ في القرآن الكريم، والنص الثابت عن المعصوم، أمّا مَن ينتج الخطاب الديني فهو يجتهد، وحسب اجتهاده ورأيه يتحدث ويخطُب ويكتُب، وكل أداءه بشري مُعرّض للنقص والخطأ، لذلك يُخطّئ العلماء بعضهم بعضاً في مختلف المسائل العَقدية والفقهية. ومن الأمثلة على ذلك نجد ان الشيخ المفيد رأى عدم صحة رأي الشيخ الصدوق في ثلاث وأربعين مسألة عقدية، ذكرها في كتابه «الاعتقاد»، فكتب المفيد كتابًا بعنوان «تصحيح الاعتقاد»، ونجد ذلك أيضاً في تعليقات الفقهاء على كتب الفتاوى الفقهية، ككتاب «العروة الوثقى» وهي فتاوى السيد محمد كاظم اليزدي، حيث يسجل كل فقيه في حاشيته على الكتاب موارد مخالفته لآراء السيد اليزدي، بمعنى عدم تصويبه لتلك الآراء، وان كان كل فقيه معذورًا فيما يذهب إليه، انطلاقًا من مشروعية الاجتهاد. بل قد يكتشف الفقيه أنه كان مخطئًا في رأيه العقدي أو الفقهي فيعدل عنه الى رأي جديد.
من جهةٍ أخرى، وبعيداً عن مسألة الخطأ والصواب، فإن الخطاب الديني بحاجةٍ الى التطوير ومواكبة التغيرات الثقافية والاجتماعية، خصوصاً مع تطوّر الحياة وتقدُّم العلم، وبالنقد والتقويم يحصل التطوير والتغيير، فقد يكون خطاب ديني صحيحًا ومناسبًا في وقتٍ من الأوقات وزمنٍ من الأزمنة، إلا أنه قد لا يكونُ كذلك في زمنٍ آخر، نظرًا لحصول تطوّر وتغيير في الواقع الاجتماعي.
ويشير الشيخ مرتضى مطهري إلى ملاحظة مهمة إذ يقول في أحدِ كتُبِه: (قد يكون شيء ما وسيلة للهداية، ثم قد يصبح الشيء نفسه في مكان آخر وسيلة للضلالة والضياع. إن المنطق الذي جعل امرأة مؤمنة، قد يُضلّ المثقف، وربّ كتاب متناسق مع ذوق عصر من العصور، ومنسجم مع مستواه الفكري، كان وسيلة في حينه لهداية الناس، ثم كان في وقت آخر سبباً لضلالهم، لدينا كتب سبق لها أن أدَّت وظيفتها في الماضي، وأرشدت إلى سبيل الهداية آلاف الناس. إلا أن هذه الكتب نفسها فضلاً عن كونها لم تعد تهدي أحداً، فإنها أصبحت سبباً لضلال عدد من الناس وشكهم وحيرتهم)[1] .
لذا ينبغي أن يكون هناك تقويم ومراجعة للخطاب الديني، وهذا ما ينسجم مع تعاليم وتوجيهات الدين، التي تحثنا على النقد الذاتي والمحاسبة في مختلف المجالات، من أجل الارتقاء إلى الأفضل، ففي الرواية الواردة عن الإمام جعفر الصادق  : «مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ خَيْرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ لَمْ يَرَ اَلزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ، وَمَنْ كَانَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ اَلْحَيَاةِ»[2] .
: «مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ خَيْرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ لَمْ يَرَ اَلزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ، وَمَنْ كَانَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ اَلْحَيَاةِ»[2] .
لماذا يرفضون النقد والتقويم؟
نرى في بعض أوساط المتدينين مَن يزعجهم النقد والتقويم لكل ما يرتبط بالخطاب الديني، أو أي شأن من الشؤون الدينية، وكأن كل شيء فيها من الثوابت والمقدسات.
فنجد على سبيل المثال: أنَّ أحد العلماء يحذّر من نقد أي شيء يتعلق بالمجالس الحسينية، ويؤيد قوله بنقل قصةٍ عن الأثر الخطير لذلك في الآخرة، مفادها: أنّ إنسانًا مؤمنًا حضر مجلسًا حسينيًا، ولما خرج من المجلس انتقد شيئًا مما دار في المجلس، وفي الليل رأى كأنّ القيامة قد قامت، وكان هو من المؤهلين لدخول الجنة، وحين نظر الملائكة في صحيفته تركوه آخر الناس، ولم يسمحوا له بالدخول إلى الجنة إلا بعد انتظار طويل. وقالوا له: هذا بسبب نقدك لشيءٍ في المجلس الحسيني!!، إن هذا التحذير فيه مبالغة شديدة، كما أن الاستدلال بأطيافٍ وأحلامٍ منقولةٍ ليس منهجية علمية موضوعية.
وقد يكون التخوّف من نقد الخطاب الديني راجعًا إلى احتمال أنه يتم بتحريضٍ من الأعداء، الذين يتّخذون النقد وسيلةً لإضعاف الدين، ولا ننكر وجود أعداءٍ يسعون بمختلف الطرق لإضعاف الدين، وإضعاف ثقة الناس بالمؤسسة الدينية، ولكن مع ذلك لا يمكن منع النقد والتقويم، وانما ينبغي أن نتعامل معه تعاملاً إيجابياً مهما كانت جهتهُ ومصدرُه، وذلك بسدِ الثغراتِ والأخطاء في الخطاب والممارسات الدينية، وكشف المغالطات الموجودة في مقولات الناقدين.
كما أنه لا يصح اتهام كل ناقد بأنه ينطلق من خلفية عدائية، فهناك ناقدون من داخل الوسط الديني، ينطلقون من دافع الحرص على سمعة الدين، والإخلاص للحقيقة والمعرفة.
وجديرٌ بالذكر استحضار ما جاء في خطبةٍ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ، يحثُ فيها من حوله على النقد والتقويم تجاه سياساته ومواقفه، يقول
، يحثُ فيها من حوله على النقد والتقويم تجاه سياساته ومواقفه، يقول  : «فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَلَا تَظُنُّوا بِيَ اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَلَا الِتمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَو الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فلا تكفوا عن مقولةٍ بحق»[3] .
: «فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَلَا تَظُنُّوا بِيَ اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَلَا الِتمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَو الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فلا تكفوا عن مقولةٍ بحق»[3] .
ونستنتج من ذلك: أنَّ على المتدينين ليس فقط أنْ لا يرفضوا النقد، وإنما أنْ يبادروا إلى النقد الذاتي، وتقويم الخطاب الديني، في كل مناسبة وكل موسم، وأن يشجعوا من حولهم على ممارسته والترحيب به، كما جاء في كلام الإمام علي  .
.
ونستحضر هنا بعض المبادرات النقدية الجريئة التي قام بها علماء أجلاء لهم مكانتهم في الساحة الشيعية، ومنهم:
- المحدث الشيخ حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل، والذي ألّف كتابًا بعنوان (اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر) سلط فيه الأضواء على الممارسات الخطابية الرائجة المخالفة للضوابط الشرعية، وفنّد كل مبرراتها الزائفة.
- السيد محسن الأمين في كتابه (المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية)، وهو من عدة أجزاء، ويسجل السيد الأمين في مقدمة هذا الكتاب نقدًا شديداً لخطابة كثير من الذاكرين في مناسبات أهل البيت
 ويصفها أنها مخالفة لنهج أهل البيت وتعاليمهم[4] .
ويصفها أنها مخالفة لنهج أهل البيت وتعاليمهم[4] . - الشيخ محمد جواد مغنية الذي قدّم نقداً لكثيرٍ من مجالات الحالة الدينية، والخطاب الديني، في عددٍ من مؤلفاته وكتاباته.
- الشيخ مرتضى مُطهّري نجد في عددٍ من كتبه نقدًا مفصّلًا للمؤسسة الدينية، وقد طبعت محاضراته النقدية حول ما يطرحه الخطباء من السيرة الحسينية في ثلاثة مجلدات بعنوان (الملحمة الحسينية)، وله كتابات في نقد بعض أوضاع الحوزات العلمية، وممارسات المنتمين إلى سلكها، مثل: (إحياء الفكر الديني في الإسلام، نقد الفكر الديني، محاضرات في الدين والاجتماع).
- الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي نقد الرسائل العملية للفقهاء، ورأى أنَّ الأسلوب المتداول فيها لم يعد يناسب لغة العصر، وثقافة الناس المكلّفين، فعرض رأيه صريحًا في مقدمة رسالته (الفتاوى الواضحة)، وله أيضاً نقد عميق تجاه مناهج الحوزة العلمية ودروسها، كتبه في مقدمات حلقاته في علم الأصول، كما انتقد أسلوب تعامل الحوزة العلمية مع المجتمع في محاضرات سجلها في آخر أيام حياته، وصدرت في كتاب بعنوان (المحنة).
وهكذا سائر العلماء الذين بادروا إلى نقد الخطاب الديني كلٌّ في مجاله، وضمن الزاوية التي نظر اليها.
ولا يعني ذلك أنّ كلَّ رأيٍ من الآراء الناقدة صحيح بالمطلق، فآراء هؤلاء العلماء تقبل النقاش، والمجال مفتوح للبحث، والمبادرات قائمة. وخلاصة القول إن النقد والتقويم للخطاب الديني مشروعٌ ومفيدٌ للحالة الدينية.
ونُشيد هنا ببيان المرجعية الدينية العُليا لسماحة السيد علي السيستاني "حفظه الله" الذي صدر بمناسبة قرب حلول شهر المحرم 1441هـ كوصايا للخطباء والمبلّغين، تضمنت اثني عشر حكمة، فيها توجيهات مهمة وملاحظات دقيقة، تعالج بعض ثغرات الخطاب الديني المعاصر، ومن اهم نقاط الضعف التي عالجها هذا البيان المهم، وسلط عليها الأضواء، ما ننقله من النص الصادر من مكتب سماحته فقد جاء في الحكمة السادسة:
(تجنّب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم وتآزرهم والتوادّ بينهم. ومن وجوه ذلك تجنّب التركيز على جهات التمايز بينهم مثل اختلافهم في التقليد، وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات، بل كلّ خلاف بينهم لا يـُخرِج بعضهم عن التمسّك بالكتاب والعترة، حتّى لو نشأ عن الاختلاف في درجات إيمانهم أو بصيرتهم، أو التزامهم أو رشدهم، بل حتّى لو كان عن زلّة صادرة من بعضهم.
ولا ينبغي إشهار الزلّة والتشهير بصاحبها فإنّ في ذلك ما يؤدّي إلى مزيد اشتهارها، وإلى إصرار صاحبها ومن قد يتأثّر به عليها، ويوجب وهن الحقيقة التي يُراد الحفاظ عليها فضلاً عن عدم جواز التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلّة صدرت منه لا سيّما فيما أوحى ذلك بعدم تقدير سائر خصائصه ومزاياه، ورُبّ زلّة خمدت بالسكوت عنها وترك ذكرها، واتّقدت ببيانها والحديث عنها، ورُبّ صمت عن شيء خير من كلام.
بل ينبغي تجنّب ما يثير الفرقة بين المسلمين ويوجب الضغينة وسوء الظنّ فيما بينهم، فإنّ ذلك خلاف تعاليمهم وسيرتهم حيث كانوا (صلوات الله عليهم) يحرصون فيها على حسن التعامل مع الآخر وعدم إبراز الاختلاف على وجه يوجب وهن الإسلام أو تشويه الحقّ، حتّى وردت التوصية بالصلاة معهم والكفّ عنهم وحضور مجالسهم وتشييع جنائزهم، وذلك أمر مؤكّد وواضح في التاريخ بالنظر إلى أحاديثهم وسيرتهم، ومن ثَمّ كانوا (عليهم السلام) موضع احترام الآخرين وثنائهم بل اهتمّوا بالتعلّم منهم والتفقّه لديهم).
ومما جاء في الحكمة السابعة: (تجنّب القول بغير علم وبصيرة، فإنّ ذلك محرّم في الدين أيّاً كان مضمون القول، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[سورة الإسراء، الآية: 36]، وليس في حسن قصد المرء وسلامة غايته ما يبيح ذلك، كما لا يقيه من محاذير ذلك ومضاعفاته.
وليحذر المرء من الابتداع والبدع، وهي إضافة شيء إلى الدين ليس منه ولا حجّةً موثوقةً عليه فيه، فإنّ الابتداع في الدين من أضرّ وجوه الضلالة فيه، وهي تؤدّي إلى تشعّب الدين إلى عقائد متعدّدة وانقسام أهله إلى فرق وأحزاب مختلفة ومتقاطعة ـ كما نشهده في كثير من الأديان والمذاهب ـ، وقد جاء عن النبيّ)صلى الله عليه وآله وسلم) التحذير من البدعة وأنّ شرّ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار.
ومن القول بغير علم وبصيرة المبالغة في الشيء والتجاوز به عن حدّه، كأن يجعل الأمر النظريّ المتوقّف على الاجتهاد واضحاً وبديهيّاً، أو يجعل الأمر المختلف فيه بين وجوه أهل العلم متّفقاً عليه بينهم تصريحاً أو تلويحاً وينزّله منزلته، أو يجعل المظنون مقطوعاً، أو يجعل المحتمل مظنوناً، أو يجعل بعض الوظائف الشرعيّة فوق درجاتها فيبلغ بالمستحبّ درجة الواجب ـ من غير عنوان ثانويّ واجب ينطبق عليه ـ وبالواجب من غير الدعائم درجة دعائم الدين أو يعكس ذلك، فإنّ ذلك كلّه أمر غير مقبول شرعاً.
وجاء في الحكمة الثامنة: (ليحذر المبلّغون والشعراء والرواديد أشدّ الحذر عن بيان الحقّ بما يوهم الغلوّ في شأن النبيّ وعترته (صلوات الله عليهم)، والغلوّ على نوعين: إسباغ الصفات الألوهيّة على غير الله سبحانه، وإثبات أمور ومعانٍ لم تقم حجّة موثوقة عليها، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام) خالٍ عن الغلوّ بنوعيه، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإنّما يشتمل على الإذعان للنبيّ وعترته (صلوات الله عليهم) بمواضعهم التي وضعهم الله تعالى فيها من دون زيادة ولا إفراط، بل مع تحذّر في مواضع الاشتباه، وورعٍ عن إثبات ما لم تقم به الحجّة الموثوقة)[5] .
معاييرُ النقد والتقويم
لا بُدّ للنقد والتقويم من معايير موضوعية صحيحة، فهناك من يستخدم التهريج والتجريح والألفاظ المسيئة في نقده لآراء الآخرين، أو يعمّم الأخطاء، وهذا أسلوب خطأ، يضر ولا ينفع، ويُفقد صاحبه المصداقية، وقد يُظن بصاحب هذا الأسلوب أنَّه يريد إلفات الناس إلى ذاته، أو تصفية حسابات مع هذه الجهة أو تلك، ويُشغل الناس بقضايا جانبية هامشية، ويُشوّه عملية الإصلاح والتطوير، فالنقد بهذه الكيفية ليس في محلّه ولا يُعدُّ أسلوباً سليماً.
من الجانب الآخر هناك تقويم ونقد على أساس علمي، ينطلق من حالة فكرية علمية، فكل إنسان لديه فكر ومعرفة فيما يحدث حوله، من حقه أن ينتقد ويُقوّم.
ومهم جداً في مسألة التقويم أن نلتفت إلى مسألة الاتفاق على المرجعية الفكرية، إذ حين تختلف المرجعية، من الطبيعي أن تختلف الآراء والمواقف، فكل اتجاه له مرجعيته الفكرية، فإذا جاء شخص من خارج الفضاء الديني يريد أن يحاكم الخطاب الديني وفق مرجعيته العلمانية مثلاً، فهذا خطأ، لأنّ محاكمة الخطاب لا بُدّ أن تنطلق من المرجعية التي يقبلها، أو من خلال المبادئ العقلية والإنسانية العامة المتفق عليها، دون فرض مرجعية وقناعة أُخرى على الخطاب الديني.
انعكاسات الخطاب الديني ومخرجاته الاجتماعية
إن من أهم مناهج النقدِ والتقويم لأي خطاب، قراءة المخرجات والنتائج، وملاحظة انعكاس الخطاب على المجتمع سلباً وإيجاباً. فمثلاً: حين نجد أنّ الخطاب الديني ساهم في انتاج مجتمعٍ متقدمٍ متحضّرٍ، فهذا يدل على سلامة ورقي هذا الخطاب، بينما حين نجد أنَّ النتيجة كانت تكريس واقعٍ متخلّفٍ ووضعٍ سيء، هنا لا يُمكن أن نحكم بصوابية ذلك النهج من الخطاب. فعلى أساس النتائج والانعكاسات التي صنعها الخطاب في المجتمع يكون النقد والتقويم.
وحين ننظر إلى الواقع الاجتماعي في عالمنا الإسلامي، نجد واقعاً ليس إيجابيًا، فيه ظواهر سلبية خطيرة، ومن أبرزها:
أولاً: عدم رسوخ القيم الأساس للدين في نفوس أبناء المجتمع، وغياب الالتزام بها في سلوكهم، كقيمة الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وضعف الالتزام بالأخلاق الفاضلة كالصدق والأمانة، ومراعاة النظام، فهذه القيم غير راسخة في النفوس، وغير منعكسة على السلوك في مساحة واسعة من هذه المجتمعات.
ثانياً: ضعف الاهتمام العلمي والثقافي، وغياب الإبداع في علوم الطبيعة والحياة، فالعالَم يتقدَّم كل يوم في مختلف مجالات العلوم، ومساهمة مجتمعاتنا الإسلامية في هذا التقدم العلمي لا تكاد تذكر، وحين نُسلّط الضوء على بعض المبادرات العالمية للإشادة بالمبدعين والمتميزين في إنتاجهم العلمي، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، نجد أنه قد فاز بالجائزة في مجال العلوم المختلفة حتى 2019م، 59 عالماً من 14 جنسيّة، وليس فيهم من يحمل جنسية بلد إسلامي، عدا الفائزين في مجال الأدب وخدمة الإسلام.
نعم نجد في المسلمين من حصل على جائزة نوبل لكنهم يعدّون على الأصابع، ولا يُقاسون عددًا بمن فازوا بالجائزة من اليهود والمسيحيين والديانات الأخرى، فلماذا نجد ضعف الاهتمام العلمي، والإبداع المعرفي في مجتمعاتنا الإسلامية؟
ثالثاً: انخفاض مستوى الفاعلية والإنتاج ومستوى جودة الحياة، كالإنتاج الصناعي والزراعي والتكنولوجي، وفي مختلف المجالات. وقد أصبح لجودة الحياة معايير ومقاييس عالمية فيما يرتبط بالخدمات الصحية، وفرص التعليم، والعمل، والأمن الاجتماعي، والتخطيط العمراني، والحوكمة والشفافية، ومجالات الترفيه.. وتتنافس الدول والمجتمعات الأخرى على تحقيق أعلى الدرجات فيها، بينما لا تزال معظم مجتمعاتنا الإسلامية تحتل أدنى المراتب في المؤشرات والتقارير الدولية لجودة الحياة.
رابعاً: ضعف المشاركة والاقبال على العمل التطوعي الإنساني، في مقابل الإقبال الأكثر على الأعمال الدينية، كبناء المساجد والحسينيات، وأداء الحج والعمرة، وزيارة العتبات المقدسة، وحضور المآتم وإقامة الشعائر، وهي أعمالٌ حسنة مرضيّة عند الله تعالى، إلا أننا نتطلع لمثل هذا الإقبال والتفاعل مع الجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية، ولجان الاهتمام بالبيئة، وبذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز البحث العلمي والإبداع الفني، فالإقبال على هذه المجالات ضعيفٌ جداً مقارنةً بالمجتمعات الأخرى، حيث تشير مثلاً الإحصائية التي صدرت قبل سنوات قليلة في المملكة العربية السعودية عن العمل التطوعي، إلى أن عدد المسجلين رسميًا كمتطوعين في المملكة لا يتجاوز 23 ألفًا فقط في وطن تعداد سكانه يقارب الثلاثين مليوناً!!، وهناك الآن تطلع لرفع عدد المتطوعين على مستوى المملكة إلى مليون متطوع بحلول سنة 2030م في سياق الرؤية المعتمدة.
خامساً: كثرة الخلافات والنزاعات في المجتمعات الإسلامية وخاصةً في الأوساط الدينية، حتى أن البعض يستخدم الخطاب الديني والأمور العبادية في إذكاء حالة الصراع والخلاف، ومما يُنقل في التاريخ الماضي: أنه حصل نزاعٌ بين قريتين، فأوقف أحدهم مزرعة نخيل من أجل استخدام (جريد النخل) في النزاع قربة الى الله تعالى؛ وكأنّ النزاع والصراع في بعض الأوساط جزء من الحالة الدينية والأعمال العبادية التي يتقرب بها إلى الله تعالى.
هذه بعضُ الظواهر الموجودة في معظم مجتمعاتنا الإسلامية، على سبيل المثال لا الحصر، وقد تجد من يُقوّم الخطاب الديني من خلال هذا الواقع الاجتماعي.
مدى مسؤولية الخطاب الديني
وهنا نتساءل عن مدى مسؤولية الخطاب الديني عن هذا الواقع؟
يبدو جلياً أنّ هناك من يحمّل الخطاب الديني فوق طاقته وقدرته، فالتخلف في المجتمعات الإسلامية نتاج عدة عوامل وأسباب، سياسية واقتصادية وتعليمية واجتماعية، ولا يصح أبداً ترك كل هذه العوامل جانباً، وتحميل الخطاب الديني والمؤسسة الدينية مسؤولية الواقع الذي تعيشه هذه المجتمعات، لأن هذا الواقع انما يُعالج ضمن مسار سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، وهذه المشاكل تحتاج إلى مؤسسات ذات قدرة وسلطة للتصدي لمعالجتها.
نعم إن الخطاب الديني يتحمل مسؤولية بحجم إمكاناته ضمن حدودٍ معينة، ولا يُمكن تحميله كل مآسي الأمة والمجتمع، لذا نجد أن الله تعالى لم يكلّف الأنبياء بتغيير مجتمعاتهم، لأن عملية التغيير تحتاج إلى استجابة الناس في مختلف مجالات الحياة، وآيات القرآن الحكيم في مواضع عديدة تؤكد أنّ الأنبياء ليسوا مسؤولين عن واقع مجتمعاتهم، إلا ضمن حدود التبليغ وتوجيه الناس الى طريق الهداية والصواب، أما التغيير الفعلي فهو رهن بمدى استجابة المجتمع وانقياده، يقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [سورة المائدة، الآية: 92]، ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾. [سورة المائدة، الآية: 99]
فانطلاقاً من الآيات الكريمة تتجلى لنا مسؤولية الخطاب الديني وهي البلاغ المبين، بإيصال التعاليم والرسالة الإلهية بوضوح للمجتمع، ودعوة الناس إلى مواجهة الانحراف والفساد في حياتهم، وإرشادهم إلى طريق الخير والصلاح، وبذلك يكون تقويم الخطاب الديني على أساس مدى تحمله لهذه المسؤولية وأدائها، أما تحميل الخطاب الديني واقع المجتمع ومآسيه ومشاكله فهذا ليس نقدًا موضوعياً.
ترشيد وتطوير الخطاب الديني
الخطاب الديني مؤثر في المجتمع، بل ليس هناك خطابٌ أكثر منه تأثيراً في نفوس المتدينين، ويمكن للخطاب الديني أن يؤدي دوراً كبيراً في نهوض مجتمعاتنا، وإنجاز التنمية في أوطاننا، لأنه يحرك الدوافع الذاتية للإنسان، ويجعله أكثر التزاما بالقيم والمبادئ، وأكثر حرصاً على العمل والعطاء، ويتوقف ذلك على مستوى هذا الخطاب وتوجهاته واهتماماته، بأن يكون في مستوى الاستجابة للتحديات والهموم التي تعيشها هذه المجتمعات، وأن يكون رشيداً، وبلغة معاصرة يفهمها ويتفاعل معها إنسان اليوم، وبذلك يستحق هذا الخطاب صفة (البلاغ المبين) حسب تعبير القرآن الكريم.
ويكون للخطاب الديني دور سلبي خطير حين يصدر من جهات متطرفة متزمتة، وقد عانت الأُمّة منذ بداية تاريخها من دور هذه الجهات المغالية في الدين، وهو ما حذر منه القرآن الكريم يقول تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾[سورة النساء، الآية: 171]، ومن هؤلاء الغلاة: الخوارج في الماضي، والجماعات المتطرفة المنتسبة للدين في الحاضر، فقد كان خطابهم مدمّراً للمجتمعات والأوطان.
وتكمن المشكلة أن بعض مَن يُنتجون الخطاب الديني يركزون على بعض النصوص الدينية، بعيداً عن المنظومة المتكاملة للدين، فتتضخم لديهم بعض الجوانب في الفكر الديني، ويفهمونها بخلاف حقيقتها وخارج سياقها، ويركزون عليها، متغافلين عن الجوانب الأخرى في الدين، لذلك ورد عن النبي  : «لَيْسَ يَقُومُ بِدِينِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ»[6] ، وعنه
: «لَيْسَ يَقُومُ بِدِينِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ»[6] ، وعنه  : «إنَّ دينَ اللّهِ تَعالى لَن يَنصُرَهُ إلّا مَن حاطَهُ مِن جَميعِ جَوانِبِهِ»[7] .
: «إنَّ دينَ اللّهِ تَعالى لَن يَنصُرَهُ إلّا مَن حاطَهُ مِن جَميعِ جَوانِبِهِ»[7] .
فتجد مثلًا من يهتم بموضوع الآخرة مركزاً عليه اهتمامه، وفي كلِّ مجلسٍ يتحدث عن الموت والقبر والحساب والصراط، دون التطرُّق لأمور الدنيا التي يوليها الدين اهتماماً موازيًا، يقول تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [سورة القصص، الآية:77]
وورد عن الإمام موسى الكاظم : «اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً، وَاِعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً»[8] .
: «اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً، وَاِعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً»[8] .
وحين نتحدث عن حقوق الله على العباد، ينبغي ألا نغفل حقوق الناس لأنها من الدين أيضاً، فهذا أمير المؤمنين علي  يقول: «جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقَدِّمَةً لِحُقُوقِهِ، فَمَنْ قَامَ بِحُقُوقِ عَبَّادِ اَللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّياً إِلَى اَلْقِيَامِ بِحُقُوقِ اَللَّهِ»[9] .
يقول: «جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقَدِّمَةً لِحُقُوقِهِ، فَمَنْ قَامَ بِحُقُوقِ عَبَّادِ اَللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّياً إِلَى اَلْقِيَامِ بِحُقُوقِ اَللَّهِ»[9] .
إن ديننا الحنيف شاملٌ لكلِّ مناحي الحياة بتوازن واعتدال، كما أكد على التوحيد لله تعالى أكدّ على حرية الإنسان، وحين فرض الجهاد وضع أساس السلم والسلام، وحين حثَّ على التبري من أعداءِ الله وأعداء رسوله، وأعداء أهل البيت، حثَّ على حفظ وحدة الأمة، وعلى التقيّة والمداراة، والتعامل بعدل وإحسان مع الآخرين، وكما أكدَّ على الاهتمام بالآخرة فقد أكد على إصلاح شؤون الدنيا.
لذا ينبغي على الخطاب الديني التركيز على المواضيع التي ترتقي بحياة الناس، ومن ذلك التركيز على طلب العلم والمعرفة، فأول ما نزل من القرآن ليس الأمر بالصلاة أو الصوم أو الحج، بل الأمر بالمعرفة، في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [سورة العلق، الآية:1]، فالمعرفة هي الأساس ويجب التركيز عليها قبل التركيز على العبادة.
ونسوق هنا مثالًا: ما نقله الشيخ عباس القمي في كتابه (مفاتيح الجنان) عن أفضلية التفكير وطلب العلم في ليلة القدر على سائر الأعمال العبادية المستحبة، وينقل ذلك عن الشيخ الصَدُوق ففي آخر حديثه عن الصلوات والأدعية الواردة في أعمال ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان وهي الليلة الثانية من ليالي القدر، يقول: "وقد قال شيخنا الصَدُوق إن إحياء هاتين الليلتين - واحد وعشرين وثلاثة وعشرين- بمذاكرة العلم أفضل من كل ذلك"[10] .
ومثالٌ آخر: ما جاء في الحديث عن صلاة ليلة الدفن في العروة الوثقى حيث نقل الحديث المروي عن رسول الله : «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرًا»، ثم عقّب السيد اليزدي بقوله: (ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به)[11] ، والشاهد هنا أولوية العطاء والصدقة، والاهتمام بحاجات الناس.
: «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرًا»، ثم عقّب السيد اليزدي بقوله: (ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به)[11] ، والشاهد هنا أولوية العطاء والصدقة، والاهتمام بحاجات الناس.
ومهم جدًّا التركيز على هذه التوجهات، وعلى النخب في المجتمع أن تساعد في ترشيد وتطوير الخطاب الديني، وعلى الجمهور التفاعل مع الخطاب التوعوي التنويري.
وفي بعض الأحيان لا يميل مزاج الجمهور إلى الخطاب الإصلاحي التغييري، ويراه ثقيلًا عليه، لتذكيره بالمسؤوليات الاجتماعية، فيبحث هذا الجمهور عن خطاب يدغدغ عواطفه، ويسلّيه بقصص التاريخ الماضي، لكن في المقابل تفيدنا التجارب المعاصرة أن مِن العلماء مَن استطاعوا بخطابهم الديني الواعي أن يغيروا حياة مجتمعاتهم، وأن يوجهوهم للاهتمام بطلب العلم والمعرفة، ومضاعفة الفاعلية والانجاز، والسير في طريق التنمية والتقدم.
اتجاه طقوسي
يتعاطى البعض مع الخطاب الديني كطقس و(بروتوكول) في المناسبات الدينية.
والطقس الديني: مصطلح يطلق عند غير المسلمين على أفعال العبادة التي يؤديها أعضاء جماعة دينية.
ولمعظم الأديان طقوسها الدينية الخاصة بها.
(والطقوس هي مجموعة من الإجراءات التي يؤديها بعض الأشخاص، والتي تُقام أساسًا لقيمتها الرمزية، وقد يحدد تلك الطقوس أو المراسم تراث الجماعة المشتركة، وتعتبر المراسم والطقوس بأنواعها المختلفة أحد سمات المجتمعات الإنسانية، سواء في الماضي أو الحاضر، وتشمل إلى جانب طقوس العبادة مختلف العادات والتقاليد الاجتماعية، كقسم الولاء ومراسم التتويج، ومراسم الزواج والجنازات، وتقاليد الدراسة والتخرج، والاجتماعات، والأحداث الرياضية)[12] .
وهناك رأي فقهي يظهر منه تبني ما يقارب هذا الاتجاه الطقوسي بعنوان (التعبدية في توجيه الخطاب الديني)، حتى وإن لم يكن له فائدة للمستمعين، كما إذا كان بغير لغتهم، حيث ناقش الفقهاء من السنة والشيعة شرط العربية في خطبتي صلاة الجمعة، (فذهب جمهور فقهاء السنة إلى اشتراط كون خطبة الجمعة بالعربية تعبدًا للاتباع، ولأنها ذكر مفروض، فاشترط فيه ذلك، كتكبيرة الإحرام ولو كان الجماعة عجماً لا يعرفون العربية)[13] .
كما ذهب مشهور فقهاء الشيعة أيضاً إلى اعتبار العربية في خطبتي الجمعة[14] .
ومنع أكثرهم إجراء الخطبة بغير العربية للتأسي.
وفرّق صاحب الجواهر بين الحمد والصلاة وبين الوعظ، ففيه يجوز بغيرها اختيارًا، بخلاف الحمد والصلاة فلا يجوز بغيرها؛ لظهور الأدلة في إرادة اللفظ فيها، والمعنى في الوعظ، وإن كان الواقع منه عليه السلام العربية في الوعظ أيضاً، لكن لعله لأنه عليه السلام عربي يتكلم بلسانه لا لوجوبه[15] .
ويرى الشيخ يوسف البحراني لزوم العربية في خطبة الجمعة، وإن لم يفهمها المستمعون، لأنها عبادة توقيفية، قال في (الحدائق الناضرة): يمكن أن يقال إن يقين البراءة موقوف على ذلك وأنها عبادة والعبادات توقيفية يتبع فيها ما رسمه صاحب الشريعة، وهذا هو الذي جاء عنهم (عليهم السلام).
والتعليل بأن المقصود من الخطبة فهم العدد لمعانيها مع تسليم وروده، لا يقتضي كونه كليًا، فإن علل الشرع ليست عللًا حقيقة يدور المعلول مدارها وجودًا وعدمًا، وإنما هي معرفات وتقريبات إلى الأذهان. على أن البلدان التي فتحت من العجم والروم ونحوهما وعينت فيها الأئمة للجمعات والجماعات لم ينقل أنهم كانوا يترجمون لهم الخطب، ولو وقع لنقل، ومنه زمان خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكيف كان فالأحوط الخطبة بالعربية وترجمة بعض الموارد التي يتوقف عليها المقصود من الخطبة[16] .
الطقوسية والمضمون
وهناك حديث عن مضمون الخطبة فإن البعض يقرأ خطبته من كتب خطب الجمعة القديمة.
ذكر أحد الكتاب السوريين في مقال له ما يلي: وفي بلدتي التي عشت فيها طفولتي، كان الإمام يخطب من كتاب (ابن أبي نباتة) من أيام السلطان قلاوون (المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي ـ توفي سنة 689هـ). وهناك 52 خطبة على مدار السنة، وحسب المواسم، وكنا صياماً فتحدث عن الحج، ثم انتبه إلى أنه بدل المواسم، فبدأ يقلب على عجل عن الخطبة المناسبة، بعد أن ضل طريقه إليها[17] .
ونجد مثل هذه الطريقة عند البعض في إحياء المناسبات المرتبطة بأهل البيت  ، فالمطلوب أن يكون الخطاب بنفس الصيغة والأسلوب والطريقة المتوارثة، وأي تطوير أو تغيير فهو تحريف للغرض وتمييع لهوية المناسبة.
، فالمطلوب أن يكون الخطاب بنفس الصيغة والأسلوب والطريقة المتوارثة، وأي تطوير أو تغيير فهو تحريف للغرض وتمييع لهوية المناسبة.
فالمطلوب في موسم عاشوراء مثلاً هو السيرة فقط، وضمن رواية معينة، وقد قرأنا بعض الكتابات التي تعترض على طرح مواضيع ثقافية واجتماعية في موسم عاشوراء، وترى أن ذلك مشروع واضح المعالم في الحرب على الشعائر، لا مبرر للمشاركة فيه ولا دعمه ولا إضفاء الشرعية عليه، وأن محرم موسم عزاء لا موسم ثقافة.
وكأن هؤلاء أحرص على المناسبة والولاء لأهل البيت  من الأئمة أنفسهم، الذين يؤكدون أن إحياء (أمرهم) هو ببث علومهم، كما ورد عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال: سَمِعتُ أبَا الحَسَنِ الرِّضا عليه السلام يَقولُ: «رَحِمَ اللّهُ عَبدا أحيا أمرَنا!» فَقُلتُ لَهُ: فَكَيفَ يُحيي أمرَكُم؟
من الأئمة أنفسهم، الذين يؤكدون أن إحياء (أمرهم) هو ببث علومهم، كما ورد عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال: سَمِعتُ أبَا الحَسَنِ الرِّضا عليه السلام يَقولُ: «رَحِمَ اللّهُ عَبدا أحيا أمرَنا!» فَقُلتُ لَهُ: فَكَيفَ يُحيي أمرَكُم؟
قالَ: «يَتَعَلَّمُ عُلومَنا ويُعَلِّمُهَا النّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَو عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لَاتَّبَعونا»[18] .
أما الاستشهاد بالروايات التي تتحدث عن بعض مشاهد العزاء عند الأئمة  كخبر أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد اللّه: «أنشدني في الحسين عليه السلام» فأنشدته.
كخبر أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد اللّه: «أنشدني في الحسين عليه السلام» فأنشدته.
قال: «أنشدني كما تنشدون»، يعني بالرقّة، فأنشدته:
أُمْرُرْ عَلَىْ جَدَثِ الحُسَيْنِ وُقُلْ لِأَعْظُمِهِ الزَّكِيَّةْ[19]
فهو يفيد أمرًا جوهريًا هو مواجهة التعتيم على مظلومية أهل البيت بذكرها وتداولها، ولكن ذلك لا يقيدها بأسلوب معين، ولا يحصرها في هذ الدائرة فقط.
حين تكون الخطابة مهنة:
لأن خطيب المناسبات الدينية في مجتمعاتنا الشيعية لا يعتمد على جهة في تامين نفقات حياته وحاجات أسرته، فقد جرى العرف أن تقدم له مكافأة في مقابل خطاباته وقراءاته. وذلك أمر طبيعي ومشروع، لا إشكال فيه من الناحية الشرعية.
روى حمزة بن حمران: سَمِعتُ أبا عبد اللّه (جعفر الصادق) عليه السلام يقولُ: «مَنِ استَأكَلَ بِعِلمِهِ افتَقَرَ»، قُلتُ: إنَّ في شيعَتِكَ ومَواليكَ قَومًا يَتَحَمَّلونَ عُلومَكُم، ويَبُثّونَها في شيعَتِكُم، فلا يُعدَمونَ مِنهُمُ البِرَّ والصِّلَةَ والإكرامَ، فقالَ عليه السلام: لَيسَ اُولئكَ بِمُستَأكِلينَ، إنَّما ذاك الّذي يُفتي بِغَيرِ عِلمٍ ولا هُدىً مِنَ اللّه ِ؛ لِيُبطِلَ بِهِ الحُقوقَ طَمَعًا في حُطامِ الدّنيا[20] .
فالمستأكل بعلمه هو الذي يجير علمه لمصلحة من يطلب منه الخطاب، فيخالف الحق طلبًا للمال، وهو امر مذموم منهي عنه شرعًا.
أما أن يكون الانسان مرشداً وموجّهاً، يحمل علوم أهل البيت إلى الناس، فيحصل على مكافأة مالية مقابل ذلك، فلا ضير ولا إشكال فيه.
وقد ورد أن بعض الأئمة كافؤوا الشعراء على مديحهم، فقد مدح الفرزدق الامام علي بن الحسين زين العابدين  بقصيدته المعروفة:
بقصيدته المعروفة:
هَذَا الذي تَعْـرِفُ البَطْـحَاءُ وَطْـأَتَـهُ وَالبَـيْـتُ يَعْـرِفُـهُ وَالحِـلُّ وَالحَـرَمُ
فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب وحبس الفرزدق ـ بعسفان بين مكة والمدينة ـ وأنفذ له الإمام اثني عشر ألف درهمًا فردها وقال: أنا مدحته لله تعالى لا للعطاء، فقال  : «إنّا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده»، فقبلها[21] .
: «إنّا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده»، فقبلها[21] .
لكن المشكلة ان تصبح المكافأة محورًا في دور الخطيب، وعاملاً مؤثرًا في توجيه خطابته، فيقول ما ليس مقتنعا به كسبًا للمال، حينئذٍ ينطبق عليه ما ورد سابقًا عن الإمام الصادق : «يُفتي بِغَيرِ عِلمٍ ولا هُدىً مِنَ اللّه ِ عَزَّ وجلَّ؛ لِيُبطِلَ بِهِ الحُقوقَ طَمَعا في حُطامِ الدّنيا».
: «يُفتي بِغَيرِ عِلمٍ ولا هُدىً مِنَ اللّه ِ عَزَّ وجلَّ؛ لِيُبطِلَ بِهِ الحُقوقَ طَمَعا في حُطامِ الدّنيا».
الرسالة الاجتماعية
الرسالة التي يحملها الخطاب الديني للمجتمع هي رسالة الدين، ولها بعدان أساسان:
الأول: تذكير الناس بالله خالقهم وربهم، والذي إليه مصيرهم، وأن عليهم طاعته وعبادته، والتطلع إلى رضاه، وما يرتبط بهذا البعد من قضايا عقدية وعبادية ووعظية، وكذلك تعزيز الولاء والمحبة للنبي وآله الكرام بذكر سيرتهم العطرة، وما قدموا من تضحيات، وتحملوا من آلام في حماية الدين وخدمة مصالح الأمة.
الثاني: إرشاد الناس لحسن الإدارة والتدبير في حياتهم المعيشية والاجتماعية.
فالدين ليس مشروعاً للخلاص في الآخرة فقط، بل هو ـ إلى جانب ذلك ـ مشروع للحياة الأفضل في الدنيا، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾[سورة الأنفال، الآية: 24].
ويقول تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾[سورة البقرة، الآية: 201].
ولعل من أهم أولويات رسالة الدين في الحياة الاجتماعية التي يجب أن يؤكد عليها الخطاب الديني هو تعزيز القيم الأخلاقية في التعامل الاجتماعي. حيث يؤكد القرآن الكريم أن هدف بعثة الأنبياء وإنزال الشرائع الإلهية، هو إقامة العدل بين البشر، وتبادل الإحسان فيما بينهم، يقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[سورة الحديد، الآية: 25].
ويقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة النحل، الآية 90].
كما يحدد النبي  مهمة رسالته الأساس بالارتقاء بمستوى الالتزام الأخلاقي في المجتمع الإنساني، حيث ورد عنه
مهمة رسالته الأساس بالارتقاء بمستوى الالتزام الأخلاقي في المجتمع الإنساني، حيث ورد عنه  : «إنَّما بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ»[22] ، من هذا المنطلق فإن الخطاب الديني يجب أن يركّز على موضوع التعامل بين الناس، والتزام القيم الأخلاقية في الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية.
: «إنَّما بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ»[22] ، من هذا المنطلق فإن الخطاب الديني يجب أن يركّز على موضوع التعامل بين الناس، والتزام القيم الأخلاقية في الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية.
وهذا ما يمكن استنتاجه من قوله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ [سورة النساء، الآية: 114].
ويؤكد الإمام علي  ما سمعه من رسول الله
ما سمعه من رسول الله  من أن الاهتمام بإصلاح العلاقات بين الناس هو خير من سائر العبادات، قال
من أن الاهتمام بإصلاح العلاقات بين الناس هو خير من سائر العبادات، قال  في وصيته للحسن والحسين: (أُوصِيكُمَا وجَمِيعَ وَلَدِي وأَهْلِي ومَنْ بَلَغَه كِتَابِي - بِتَقْوَى اللَّه ونَظْمِ أَمْرِكُمْ وصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ - فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا
في وصيته للحسن والحسين: (أُوصِيكُمَا وجَمِيعَ وَلَدِي وأَهْلِي ومَنْ بَلَغَه كِتَابِي - بِتَقْوَى اللَّه ونَظْمِ أَمْرِكُمْ وصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ - فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ - صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ والصِّيَامِ)[23] .
يَقُولُ - صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ والصِّيَامِ)[23] .
إن إغفال الخطاب الديني موضوع حقوق الناس، يؤدي إلى وجود أشخاص متدينين يهتمون بأمور الصلاة والوضوء إلى حد الهوس، لكنهم يتهاونون بحقوق الآخرين ضمن حياتهم العائلية والاجتماعية، وذلك خلاف رسالة الدين.
وكما ورد أنه قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ  : امْرَأَةٌ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «لاَ خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»[24] .
: امْرَأَةٌ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «لاَ خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»[24] .
والأمر الآخر الذي يجب التركيز عليه في الخطاب الديني هو الاهتمام بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة.
حيث يبدو من النصوص والتعاليم الدينية، أن الدين لا يريد للإنسان أن يعيش في أدنى مستوى للحياة، بل يريد له العيش في المستوى الأفضل والأرقى، بخلاف النظرة التي يتداولها البعض، بتفسير بعض المفاهيم الأخلاقية كالزهد، والقناعة، والرضا، بأنها تعني تجنب الاستمتاع بالحياة، وإهمال الاستفادة من خيراتها!
وبسبب هذه النظرة ترى أن بعض المتدينين يعيشون حياة الفقر والتخلف والفوضى!!
فإذا ذهبت إلى بلد فيه مسلمون وغير مسلمين، قد تجد أن حياة غيرهم أكثر ترتيباً وتقدمًا من حياتهم.
إن الله تعالى يقول: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سورة النحل، الآية:97]، فأين الحياة الطيبة في واقع كثير من مجتمعاتنا؟
لقد أصبح مفهوم جودة الحياة مفهوماً واسعاً، له مؤشرات شاملة معتمدة عالمياً، كمراجع أساسية: منها (التصنيف العالمي لقابلية العيش)، وهو مؤشر سنوي، يصنف المدن في 140 دولة، حسب جودة الحياة فيها، بناءً على تقييم الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والرياضة والبنية التحتية.
ومنها (مؤشر السعادة العالمي) الذي وضع سنة 2017م، والذي يصنف 155 دولة، وفقًا لمستويات السعادة، وذلك بناءً على الجوانب الآتية: الفساد وحرية الاختيار، ومتوسط العمر المتوقع، وإجمالي الناتج المحلي للفرد، والدعم الاجتماعي، والعطاء.
إن جودة الحياة مقصد ديني تدعو له النصوص الدينية، يقول تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[سورة الأعراف، الآيتان: 31-32].
يريد الله تعالى للإنسان المؤمن أن يستمتع بحياته، ويعيش الرفاهية، ويبدو من الآيات القرآنية أن الأصل في المؤمن أن يكون ثرياً، فحين تتحدث عن الصلاة غالبًا ما تردفها بالزكاة.
مثل: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾[سورة البقرة، الآية: 277]، ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[سورة الحج، الآية: 78]، ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾[سورة المائدة، الآية 55].
وذلك يعني أن الأصل في المؤمن أن يكون غنيًا؛ لأن الزكاة ليست واجبة على الفقراء.
وفي نص ورد عن الإمام علي  في نهج البلاغة، يؤكد أن حياة المتدينين المتقين في سكنهم وأكلهم واستمتاعهم بالحياة هي في درجة أرقى من حياة المترفين والمتجبّرين، حيث يقول
في نهج البلاغة، يؤكد أن حياة المتدينين المتقين في سكنهم وأكلهم واستمتاعهم بالحياة هي في درجة أرقى من حياة المترفين والمتجبّرين، حيث يقول  : «واعْلَمُوا عِبَادَ اللَّه - أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وآجِلِ الآخِرَةِ - فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ - ولَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ - سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ وأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ - فَحَظُوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِه الْمُتْرَفُونَ، وأَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَه الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ - ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّغِ والْمَتْجَرِ الرَّابِحِ - أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ - وتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللَّه غَداً فِي آخِرَتِهِمْ - لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ ولَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ»[25] .
: «واعْلَمُوا عِبَادَ اللَّه - أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وآجِلِ الآخِرَةِ - فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ - ولَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ - سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ وأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ - فَحَظُوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِه الْمُتْرَفُونَ، وأَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَه الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ - ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّغِ والْمَتْجَرِ الرَّابِحِ - أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ - وتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللَّه غَداً فِي آخِرَتِهِمْ - لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ ولَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ»[25] .
فرسالة الدين الارتقاء بالحياة وإصلاح المجتمع، والإمام الحسين  جعل الإصلاح عنوانًا لحركته ونهضته، ففي أول بيان صدر عنه في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية يقول
جعل الإصلاح عنوانًا لحركته ونهضته، ففي أول بيان صدر عنه في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية يقول  : «إنّي لم أَخرجْ أَشِراً ولا بَطِراً، ولا مُفسِداً ولا ظَالِماً، وإنّما خَرجْتُ لِطَلَبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدّي وأبي، أريدُ أن آمرَ بالمعروفِ، وأنهى عن المُنكَرِ»[26] .
: «إنّي لم أَخرجْ أَشِراً ولا بَطِراً، ولا مُفسِداً ولا ظَالِماً، وإنّما خَرجْتُ لِطَلَبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدّي وأبي، أريدُ أن آمرَ بالمعروفِ، وأنهى عن المُنكَرِ»[26] .
الخطاب الديني بين المسؤولية والشعبوية
للخطاب الموجه للجمهور تأثير على تشكيل ثقافة المجتمع، وتوجيه مواقف وسلوكيات أبنائه.
كان هذا من قديم الزمان، حيث كانت خطب الزعماء والقيادات، وقصائد الشعراء والأدباء، تلهب المشاعر، وتحرك الأحاسيس، وتصنع الرأي العام في مجتمعاتها، وتقودهم نحو التوجهات المطلوبة.
وفي المجتمعات الدينية يكون للخطاب الديني تأثير أكبر من سائر الخطابات؛ لأنه في نظر المتدينين يعبّر عن مقاصد إلهية، وأوامر دينية، والاستجابة له تحقق رضا الله وتنجي من سخطه.
من هنا كان لروايات المحدثين، وفتاوى الفقهاء، وخطب الواعظين والدعاة، نفوذ في نفوس الناس، وتأثير على أفكارهم وسلوكهم.
وفي عصرنا الحاضر فإنّ تطوّر وسائل الإعلام، وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي، أعطى للخطاب الديني أفقًا أوسع في الانتشار والتأثير، حيث الفضائيات، والبث المباشر، والشبكة العنكبوتية، والخدمات المتطورة للهواتف النقالة.
وتوفر المواسم الدينية فرصًا مميزة للخطاب الديني، حيث يُقبل الناس على الإصغاء له، والتفاعل معه، بحكم طبيعة الأجواء الجمعية الشعائرية.
إنّ تأثير الخطاب الديني هو مصدر أهميته، وفي الوقت ذاته مكمن خطورته، فإذا لم يكن في الاتجاه الصحيح، فسيصيب الدين والأمة بأضرار جسيمة، وإذا لم يقم بوظيفته المطلوبة، فسيضيِّع على المجتمع أعظم الفرص والمكاسب.
ورد عن الإمام علي أنه قال: سمعت رسول الله
أنه قال: سمعت رسول الله يقول: «يا علي، هلاك أمتي على يدي كلّ منافق عليم اللسان»[27] .
يقول: «يا علي، هلاك أمتي على يدي كلّ منافق عليم اللسان»[27] .
و(عليم اللسان) أي المتحدث الذي له تأثير في مستمعيه. فإذا لم يكن مخلصًا صادقًا، فإنّ هلاك الأمة يكون على يديه؛ لأنّ توجيهه قد يأخذ الناس إلى مسار مهلك لهم.
إنّ للخطيب موقعًا خطيرًا، وهو محاسب على تعامله مع هذا الموقع، وعليه أن يدرك ذلك، ويكون حريصًا على مراعاة الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.
ضوابط المسؤولية في الخطاب
يمكن الحديث عن أهم ضوابط المسؤولية في الخطاب الديني، وهما ضابطان:
الأول:
الانطلاق من قيم الدين وتعاليمه، فلا يصح الافتراء على الدين ولا تجييره لخدمة المصالح والأهواء.
الثاني:
رعاية المصلحة العامة للدين والمجتمع، وأخذ الظروف والأوضاع الحاضرة بعين الاعتبار، واختيار الأسلوب المناسب للطرح، حتى لا يكون منفّرًا للناس من الدين.
إنّ الدين منظومة من العقائد والمفاهيم والأحكام والآداب، وفي التراث الديني قضايا ومواضيع كثيرة، لكن الخطاب يجب أن يراعي حاجات المجتمع المخاطب، وظروفه ومصالحه، فتكون هناك أولوية لاختيار المواضيع التي تعالج القضايا المهمة الحاضرة، ولا يربك المجتمع بطرح القضايا الجانبية الفرعية، أو يستغرق الخطاب في سرديات تاريخية، قد تشبع فضول المستمع لكنها لا تقدم له ما ينفعه في حياته.
ورد عن الإمامِ الكاظمِ  أنه قال: دَخَلَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه وآله المَسجِدَ فإذا جَماعَةٌ قَد أطافوا بِرَجُلٍ، فقالَ: ما هذا؟ فقيلَ: عَلاّمَةٌ، قالَ: وما العَلاّمَةُ؟ قالوا: أعلَمُ النّاسِ بِأنسابِ العَرَبِ ووَقائعِها، وأيّامِ الجاهِلِيَّةِ، وبِالأشعارِ والعَرَبِيَّةِ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: «ذاكَ عِلمٌ لا يَضُرُّ مَن جَهِلَهُ، ولا يَنفَعُ مَن عَلِمَهُ»[28] .
أنه قال: دَخَلَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه وآله المَسجِدَ فإذا جَماعَةٌ قَد أطافوا بِرَجُلٍ، فقالَ: ما هذا؟ فقيلَ: عَلاّمَةٌ، قالَ: وما العَلاّمَةُ؟ قالوا: أعلَمُ النّاسِ بِأنسابِ العَرَبِ ووَقائعِها، وأيّامِ الجاهِلِيَّةِ، وبِالأشعارِ والعَرَبِيَّةِ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: «ذاكَ عِلمٌ لا يَضُرُّ مَن جَهِلَهُ، ولا يَنفَعُ مَن عَلِمَهُ»[28] .
ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾[سورة الأحزاب، آية: 70]، أي قولًا رصينًا محكمًا، لا تكون فيه ثغرات تخلّ بمصالح الدين والمجتمع.
ويقول تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾[سورة النحل، آية: 125]، والحكمة تعني وضع الشيء المناسب في المكان المناسب.
وجاء عن علي في ذكر النبي
في ذكر النبي : «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ»[29] .
: «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ»[29] .
(مَرَاهِمَهُ) تعبير عن المداراة واللين.
(مَوَاسِمَهُ) ما يستخدم للكي، في الطب القديم، كناية عن الشدة، وكلٌّ في موضعه.
وورد عن الإمام الصادق : «لا تَكَلَّم بِما لا يَعنيكَ، ودَع كَثيراً مِنَ الكَلامِ في ما يَعنيكَ حَتّى تَجِدَ لَهُ مَوضِعًا؛ فَرُبَّ مُتَكَلِّمٍ تَكَلَّمَ بِالحَقِّ بِما يَعنيهِ في غَيرِ مَوضِعِهِ فَتَعِبَ»[30] .
: «لا تَكَلَّم بِما لا يَعنيكَ، ودَع كَثيراً مِنَ الكَلامِ في ما يَعنيكَ حَتّى تَجِدَ لَهُ مَوضِعًا؛ فَرُبَّ مُتَكَلِّمٍ تَكَلَّمَ بِالحَقِّ بِما يَعنيهِ في غَيرِ مَوضِعِهِ فَتَعِبَ»[30] .
فمقياس الحقانية ليس هو المقياس الوحيد لاختيار الكلام.
بل ينبغي التفكير والتساؤل: هل يناسب الظروف الراهنة أم لا؟!
وفي الحديث عنه : «إنَّا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نُكلّم الناس على قدر عقولهم»[31] .
: «إنَّا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نُكلّم الناس على قدر عقولهم»[31] .
قال ابن القيّم الجوزيّة: «كان رسول الله يخطب في كلّ وقت بما يقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم»[32] .
يخطب في كلّ وقت بما يقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم»[32] .
وكما قيل: ليس كلّ ما يعرف يقال، وليس كلّ ما يقال حضر أهله، وليس كلّ ما حضر أهله، حان وقته، وليس كلّ ما حان وقته صح قوله.
إنّ المسألة لا تكمن فقط في أنّ القول صحيح أم لا، فقد يكون صحيحًا، لكن توقيت الطرح قد يكون غير مناسب، فيصبح الخطاب ضارًّا بدل أن يكون نافعًا.
الاستجابة للميول الشعبية
ليس خطأ أن يفكر الخطيب في استقطاب الجمهور ونيل رضاه، ليحضروا خطابه، وليتفاعلوا مع أطروحاته، بل هو أمر مطلوب، وذلك يتم عبر معالجة همومهم وقضاياهم، واختيار اللغة الجاذبة، والأسلوب المؤثر، لكن يفترض أن تكون للخطيب رسالة يريد إيصالها للجمهور، وأن تكون لديه رؤية من وحي التزامه بضوابط المسؤولية، لا أن يكون الاستقطاب هدفًا بحدّ ذاته، لتحقيق البروز، أو كسب الجاه والنفوذ، وتحصيل المصالح، وليس الهدف إمتاع الجمهور، بل توعيته وتوجيهه.
ورد عن الإمام جعفر الصادق : «الشيعة ثلاث: محبّ وادّ، فهو منّا، ومتزيّن بنا، ونحن زين لمن تزيّن بنا، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر»[33] .
: «الشيعة ثلاث: محبّ وادّ، فهو منّا، ومتزيّن بنا، ونحن زين لمن تزيّن بنا، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر»[33] .
حيث يحذر الحديث من الارتزاق بذكر أهل البيت ، فهو رسالة وليس مصدر رزق، أو دكان تجارة، ومن تعامل مع ذكر أهل البيت بهذه الطريقة، فإنه يصاب بالفقر، وقد لا يكون الفقر المادي، بل الفقر المعنوي، أو الفقر الأخروي، لذلك لا يصح أن يكون الهم الأول للخطيب هو الحصول على المال أو النفوذ الاجتماعي.
، فهو رسالة وليس مصدر رزق، أو دكان تجارة، ومن تعامل مع ذكر أهل البيت بهذه الطريقة، فإنه يصاب بالفقر، وقد لا يكون الفقر المادي، بل الفقر المعنوي، أو الفقر الأخروي، لذلك لا يصح أن يكون الهم الأول للخطيب هو الحصول على المال أو النفوذ الاجتماعي.
ماذا تعني الشعبوية ؟
يحدد قاموس (بوتي روبير) طبعة عام 2013م بأن الشعبوية هي: (خطاب سياسي موجه إلى الطبقات الشعبية قائم على انتقاد النظام ومسؤوليه والنخب)[34] .
ويقول الباحث الأمريكي (مارك فلورباي) من جامعة برينستون: إنّ الشعبوية هي (البحث من قبل سياسيين يحظون بكاريزما عن دعم شعبي مباشر في خطاب عام يتحدى المؤسسات التقليدية والديموقراطية)[35] .
لقد بات مصطلح الشعبوية يتكرر مع كلّ عملية اقتراع.
والشعبوية في فرنسا من يتلاعب بأفكار الناس لغايات سياسية حسب مدير مجلة «كريتيك» فيليب روجيه[36] .
وأخذ مصطلح الشعبوية طريقه إلى التداول في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، إثر الاحتجاجات التي قام بها الفلاحون في روسيا لأجل تحررهم.
ويتم توصيف الخطابات بالشعبوية للدلالة على أنها تثير المشاعر العامة للناس؛ لكونها تتوجه إليهم بطريقة غير منتظمة، تتخطى العقلانية والوقائع، وتعمد إلى تضخيم بعض الأمور، للوصول إلى نتائج تناسب الرغبات أو الأهداف المطروحة.
وهناك مصطلح في مصر: «الجمهور عايز كده». للدفاع عن الانحطاط والهبوط الذي أصاب الإنتاج الفني في مصر من غناء ومسرح وأفلام، ثم سرت للكتابات والخطابات.
وبعض الإذاعات لديها برنامج (ما يطلبه المستمعون).
لكن الخطاب الديني لا يصح أن يكون شعبويًا، بمعنى استهدافه دغدغة المشاعر والعواطف على حساب الحقائق والمصالح الواقعية، ولا أن ينقاد لرغبات الجمهور على حساب الوظيفة الشرعية.
ذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة أنّ رسول الله قال: «من أرضى الله بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى الناس»[37] .
قال: «من أرضى الله بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى الناس»[37] .
أخرج الترمذي عن رسول الله أنه قال: «منِ التمسَ رضا اللَّهِ بسَخطِ النَّاسِ كفاهُ اللَّهُ مؤنةَ النَّاسِ، ومنِ التمسَ رضا النَّاسِ بسخطِ اللَّهِ وَكلَهُ اللَّهُ إلى النَّاسِ»[38] .
أنه قال: «منِ التمسَ رضا اللَّهِ بسَخطِ النَّاسِ كفاهُ اللَّهُ مؤنةَ النَّاسِ، ومنِ التمسَ رضا النَّاسِ بسخطِ اللَّهِ وَكلَهُ اللَّهُ إلى النَّاسِ»[38] .
وورد عن الإمام علي : «ما أعظم وزر من طلب رضى المخلوقين بسخط الخالق»[39] .
: «ما أعظم وزر من طلب رضى المخلوقين بسخط الخالق»[39] .
كما ورد عن الإمام الحسين : «من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس»[40] .
: «من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس»[40] .
ويمكن رصد ثلاثة أساليب للخطاب الديني الشعبوي:
الأول: أسلوب التهييج السياسي:
فللشعوب في كلّ البلدان قضايا ومطالب واهتمامات، وعادة ما يتفاعل الناس مع من يرفع صوت المعارضة والاحتجاج، وهنا لا بُدّ وأن تؤخذ الظروف والأوضاع في كلّ بلد ومجتمع بعين الاعتبار، فما يكون مفيدًا في بلد قد يكون مضرًّا في بلد آخر، وما يكون مناسبًا لظرف وزمن، قد لا يكون مناسبًا في ظرف وزمن مختلف.
الثاني: أسلوب التعبئة المذهبية
هناك أرضية خصبة في مجتمعاتنا للتفاعل مع الخطاب المذهبي والطائفي، بسبب وجود تراث تاريخي وثقافي ضخم عند كلّ طائفة في السجال المذهبي، وبسبب وجود خلل في العلاقات بين الطوائف، حيث تستعلي طائفة على أخرى، وتعاني طوائف من التهميش والإقصاء، وحيث تستعر نيران الفتن والصراعات الطائفية، فمن الطبيعي أن يتفاعل الجمهور من مختلف الطوائف مع الطروحات المذهبية، ويصبح سوقها رائجًا، وأبرز شاهد على ذلك هذه الفضائيات الطائفية، ومن يركب هذه الموجة يصبح نـجمًا وبطلًا، كما رأينا أنّ أفرادًا نكرات أصبحوا أرقامًا يحسب لهم حساب!!
لكن الخطيب الواعي هو من يجعل المصلحة العامة للدين والأمة والوطن نصب عينيه، فيتقي الله فيما يطرح ويقول، فكثيرًا ما تتأثر العلاقة بين أبناء الوطن الواحد بخطب التعبئة الطائفية، وقد يدفع ذلك للفتنة والاحتراب.
الثالث: أسلوب الإثارة العاطفية:
لا شك أنّ للعاطفة دورًا ينبغي أن يستثمر في الخطاب الديني، بإثارة الخشية من الله والشوق إلى رضاه، والحبّ لأولياء الله، والتأثر لمصائبهم ومعاناتهم.
لكن لا ينبغي الاستغراق والمبالغة في الجانب العاطفي، بحيث يتجاوز الحدود المشروعة، بسرد قصص مختلقة، أو نسبة كذب لمقامات الأنبياء والأئمة والأولياء.
قد يرى البعض أن غرض الإبكاء على الإمام الحسين مبرر لذكر ما لا أصل له، أو التصوير بلسان الحال لما لا يليق بمقام الأئمة والأولياء وهذا خطأ لا ينبغي الوقوع فيه.
ذكر السيد حسن القزويني من علماء الشيعة البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية في كتاب له عن تجربته التبليغية هناك تحت عنوان: (الشمس تشرق من المغرب) أنّ خطيبًا في مسجد للجالية الباكستانية في كاليفورنيا كان مولعًا بذكر المعاجز والكرامات ليس للأئمة الطاهرين فحسب وإنما لفرس الإمام الحسين ، ففي أكثر من ليلة تحدث وبشكل مسهب عن وجوه الإعجاز والكرامات لهذا الفرس[41].
، ففي أكثر من ليلة تحدث وبشكل مسهب عن وجوه الإعجاز والكرامات لهذا الفرس[41].
وقد صنّف العلامة الشيخ حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل (توفي 1330ﻫ) كتابه (اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر)، لمعالجة هذه المشكلة التي يعاني منها معظم الخطاب الديني في الساحة الشيعية.
ومما جاء فيه:
(في ذكر بعض الشبهات التي حملت هذه الجماعة، بل بعض أرباب التأليف، على نقل الأخبار والحكايات التي لا أساس لها، والروايات التي لا يحتمل صدقها، أو التي يكون احتمال صدقها في غاية الضعف، وعلى افتراء الكذب، وجعل الأخبار ووضعها، واختلاق الحكايات المتضمنة للمصائب التي لا واقع لها، من أجل إبكاء المؤمنين وإضفاء الرونق على مجالس العزاء).
ويتابع: (ما نقل عن بعض مختلقي الكذب من الأخبار التي تمدح الإبكاء، وترغّب فيه، وما سُطّر في هذا المجال، مما يوحي بأن كلّ ما يحمل على البكاء، وما هو وسيلة للتفجّع وإسالة الدموع ممدوح ومستحسن، ولو كان كذبًا وافتراء).
ويضيف: (ولا يخفى على كلّ ذي شعور أنّ هذا النمط من الكلام خلاف ضروريات الدين والمذهب، وخروج عن الملة والإسلام. وجواب أصل هذه الشبهة مشروح في الفقه في كتاب المكاسب، ومجمله الذي يمكن إيراده هنا: أنّ المستحب مهما كان عظيمًا، لا يمكنه أن يعارض الحرام مهما كان حقيرًا، ولا يطاع الله من حيث يعصى، ولا يكون ما يوجب عقوبة الله وسخطه داعيًا للتقرب منه، وأن مورد كلّ المستحبات ما كان جائزًا في نفسه، مباحًا بذاته، أما إذا كان حرامًا، وتترتب عليه مفسدة عظيمة، تستوجب توجه النهي عنه، لا يبقى لذلك المستحب محلّ ولا مجال)[42].
إنّ ذكر النصوص المعتبرة عن حادثة عاشوراء، وعن مصائب أهل البيت  ، تكفي لإثارة المشاعر الولائية النبيلة دون الحاجة للتلفيق والاختلاق.
، تكفي لإثارة المشاعر الولائية النبيلة دون الحاجة للتلفيق والاختلاق.
نتائج وتوصيات:
- الخطاب الديني مصدر أساس لأبناء الأمة في التعرف على مفاهيم الدين وتعاليمه، وله دور رئيس في تشكيل ثقافتهم الدينية وسلوكهم الاجتماعي.
- على القيادات الواعية المخلصة في الأمة، أن تبدي أعلى درجات الاهتمام بشأن الخطاب الديني في مجتمعاتها؛ لأن أي ضعف أو خلل يتسلل إلى هذا الخطاب ستكون نتائجه خطيرة على الدين والمجتمع.
- دفعت مجتمعاتنا ثمنًا باهظًا لرواج خطابات ـ تنتسب إلى الدين ـ كرّست التخلف، ونشرت الكراهية، وسببت الخلافات والفتن، وأعطت عن الدين صورة مشوّهة منفّرة. لكن الانصاف يقتضي الإشارة إلى أن ساحة الأمة لم تخل من وجود خطاب ديني أصيل، يبث الوعي، ويدعو إلى الوحدة ويعزز الاستقرار والسلم المجتمعي، ويحفّز للتنمية والنهوض والتقدم.
- لا بُدّ من الاهتمام بتأهيل وإعداد الخطباء والدعاة والمبلغين، علميًا وثقافيًا وتربويًا ليكونوا في مستوى الكفاءة اللازمة لأداء مهمتهم الخطيرة.
- تجب المبادرة لتقديم رؤية مدروسة لتوجّهات الخطاب الديني وأولوياته، حسب حاجة كل مجتمع ومستلزمات كل مرحلة وظرف، وذلك يقتضي وجود مراكز ومؤسسات أبحاث تهتم بهذا الشأن.
- من الضرورة بمكان وجود متابعة ورصد للأداء الخطابي في كل مناسبة وموسم ديني، من أجل التقويم، وتدوير التجارب الناجحة، ومعالجة مناطق الضعف، وسدّ الثغرات.
- تحتاج الساحة الاجتماعية لرفع مستوى الوعي بأهمية الخطاب الديني، والتعامل معه بمسؤولية والتزام، والقيام تجاهه بدور التقويم والنقد البنّاء لأدائه، انطلاقًا من المعايير والضوابط الصحيحة.