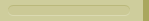الذنوب الأشدّ خطرًا
يقول تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [سورة النساء، الآية: 31].
الذنب لغة، هو: الإثم والجرم والمعصية، وأطلق عليه ذنب؛ لأنّ ضرره يتبع الإنسان، فهو من الاتباع، أخذًا من ذنب الدابة، لأنه متصل بها في مؤخرتها، وهكذا فإنّ آثار الجرم تتبع الإنسان فسمّي ذنبًا.
كما يسمى الإتباع والأراذل أذنابًا. فالذنب في الأصل، مصدر بمعنى التبعية، اسمًا لكلّ تابع دنيء متأخر[1] .
والذنب شرعًا، هو: اقتراف معصية الله تعالى ومخالفة أمره، ولأنّ ذلك يستتبع الضرر والعقوبة من الله تعالى، فقد أطلق عليه ذنب بما ينسجم مع المعنى اللغوي.
أعراض لأمراض روحية
يفترض في الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى، ويدرك نعمه وفضله عليه، ألّا يتجرّأ على عصيانه ومخالفته، انطلاقًا من أنّ له تعالى حقّ الطاعة، كما أنّ أوامر الله ونواهيه، هي لحفظ مصالح الإنسان، كفرد أو كمجتمع، في الجانب المادي أو المعنوي، ما يتعلق منها بالدنيا أو بالآخرة.
وكذلك انطلاقًا من الإيمان بمعادلة الحساب والجزاء، والعقوبة من قبل الله تعالى على المعصية، كما أخبر بذلك أنبياؤه ورسله، ونزلت به كتبه ووحيه.
ورحم الله الشيخ حسن الدمستاني[2] إذ يقول:
يا منفقَ العمرِ في عصيانِ خالقِه
أفِقْ فإنك من خَمْرِ الهوى ثَمِلُ
تَعصيهِ لا أنتَ في عُصيانِه وجلٌ
من العقاب ولا مِن مَنِّه خَجِلُ
إنّ الذنوب والمعاصي هي أعراض لأمراض روحية معنوية، وممارستها تعزّز وتعمّق وجود تلك الأمراض في كيان الإنسان، وتعرضه للشقاء في الدنيا، ولعذاب الله تعالى في الآخرة.
والإنسان بحكم طبيعته البشرية، وتأثير الأهواء والشهوات على نفسه، فإنه معرّض للوقوع في الذنوب والمعاصي، ومن كرم الله ورحمته ولطفه بالإنسان، فإنه يتجاوز عن كثير مما يصدر منه من الأخطاء والذنوب.
يقول تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [سورة الشورى، الآية: 30].
ويقول تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [سورة النساء، الآية: 99].
والآية الكريمة: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [سورة النساء، الآية: 31] تبيّن أحد مظاهر عفو الله ورحمته بعباده، حيث تؤكد على الإنسان اجتناب كبائر الذنوب، وتَعِدُهُ بعفو الله عمّا يصدر منه من سيئات، ﴿نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، أي نسترها ونمحوها فلا تعاقبون عليها.
ورد عن الإمام جعفر الصادق  : «مَنِ اِجْتَنَبَ اَلْكَبَائِرَ كَفَّرَ اَللَّهُ عَنْهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ»[3] .
: «مَنِ اِجْتَنَبَ اَلْكَبَائِرَ كَفَّرَ اَللَّهُ عَنْهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ»[3] .
الكبائر والصّغائر
على ضوء هذه الآية الكريمة، استنتج الفقهاء والعلماء أنّ الذنوب والمعاصي ليست كلّها في درجة واحدة من الخطر والشدة، فهناك مجموعة منها تشترك في درجة عالية من المفسدة، أو ضياع درجة عالية من المصلحة، تسمى كبائر، ومجموعة أخرى لا تكون بهذه المثابة تطلق عليها الآية (سيئات)، وهي صغائر الذنوب.
ويؤيّد هذا المعنى آيات أخرى في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [سورة الشورى، الآية: 37].
فمن صفات المؤمنين اجتنابهم للذنوب الكبيرة، والمعاصي الفاحشة، ولا ينافي ذلك صدور الذنوب الصغيرة منهم بحكم طبيعتهم البشرية.
ويقول تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ [سورة النجم، الآية: 32]، وتؤكد هذه الآية أيضًا أنّ من صفات المؤمنين المحسنين اجتنابهم لكبائر الذنوب والمعاصي، لكنهم قد يقعون في المعاصي الصغيرة، وتطلق عليها ﴿اللَّمَمَ﴾، أي الأشياء القليلة الصغيرة.
من هنا جاء تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر.
ورأى بعض العلماء كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي، أنه تقسيم إضافي وليس حقيقيًا، فكلّ معصية بالقياس إلى ما دونها كبيرة، وإلى ما فوقها صغيرة، وإلّا فكلّ معصية في نفسها كبيرة؛ لأنّها هتك لحرمة الله وتمرّد عليه.
لكنّ أكثر العلماء يرون أنه تقسيم حقيقي، بمعنى أنّ بعض الذنوب أشدّ خطرًا وضررًا، وتستوجب من الله عقوبة أكبر.
ونجد مثل هذا التقسيم في القوانين الوضعية التي تصنّف الجرائم إلى ثلاثة أقسام:
1/ الجنايات، وهي أشدّ وأقسى أنواع الجرائم، كالقتل العمدي والاغتصاب، وتكون عقوباتها مشدّدة.
2/ الجنحة، ويعرفها القانون بأنّها عمل إجرامي أصغر، كالسرقة البسيطة، والاعتداء البسيط، وعقوباتها أخفّ من عقوبات الجنايات.
3/ المخالفات، وهي أدنى الجرائم جسامة بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها، وعقوباتها أخفّ. كالمخالفات المرورية والتنظيمية.
التمييز بين الكبائر والصّغائر
وقد فرّق العلماء بين الكبائر والصغائر من الذنوب، بأنّ الكبيرة: ما ورد عليها تهديد بعذاب النار في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [سورة النساء، الآية: 10].
وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [سورة الفرقان، الآيتان: 68-69].
جاء عن عباد بن كثير النوا، قال: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [الإمام محمد الباقر  ] عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ
] عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ  : «كُلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ»[4] .
: «كُلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ»[4] .
وورد عن الإمام جعفر الصادق  : «اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ»[5] .
: «اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ»[5] .
وهل تشمل ما ورد عليها تهديد بعذاب النار في السنة؟
قال بذلك بعض العلماء، لكنّ آخرين من العلماء كما هو ظاهر المحقق الملا صالح المازندراني، يرون أنّ الكبائر هي خصوص ما أوعد الله عليها النار في القرآن، وهذا هو الأقرب في النظر[6] .
وبناءً على دخول ما أوعدت عليه الأحاديث والروايات النارَ في الكبائر، وصل عدد الكبائر عند بعضهم من سبع إلى السبعين وإلى السبعمائة، كما في الدرّ المنثور: أخرج جماعة عن ابن عباس أنه سُئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هِيَ إِلَى السّبْعين أقرب.
وفيه أيضًا: عن ابن جبير أنّ رجلًا سأل ابن عباس: كم الكبائر، سبع هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أَنه لَا كَبِيرَة مَعَ اسْتِغْفَار، وَلَا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار[7] .
ونشير إلى ما رصده أحد الباحثين حول اتساع رقعة الذنوب الكبيرة، وتصاعد الأرقام في قائمتها عند الفقهاء المسلمين مع مرور الزمن.
يقول: استعرضت عامة كلام العلماء وكتبهم في الكبائر، منذ جيل الصحابة، إلى البرديجي (ت ۳۰۱هـ) صاحب أول كتاب مصنف في الكبائر يصل إلينا، فقد بلغ عدد الكبائر عنده ثلاث عشرة كبيرة فقط، وزاد عليه الضياء المقدسي (ت ٦٤٣هـ) في تذييله عليه، ثلاثًا فقط، ... وكذلك الحال مع ابن جرير الطبري (الذي حصر الكبائر في تسع كبائر فقط)، ... أبو زكريا بن النحاس (ت ٨١٤هـ)، في كتابه «تنبيه الغافلين»... فقد بلغت عنده (۱۷۱) كبيرة.
وقبله ابن حجر المكي الهيثمي (ت ٩٤٧هـ)، في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»، حيث بلغت عنده (٤٦٦) كبيرة! حتى كادت أن تكون عامة المعاصي عنده كبائر[8] .
وبعضهم فرّق بينها بأنّ ما عليها حدّ شرعي في الدنيا فهي من الكبائر.
لماذا اجتناب الكبائر يكفّر الصغائر؟
ويرد هنا سؤال: ألا يعتبر التكفير عن الصغائر باجتناب الكبائر، تساهلًا وإغراءً بارتكاب الذنوب الصغيرة؟
والجواب على ذلك بأمرين:
أولًا: إنّ الحكمة الإلهية اقتضت التشديد على الزجر عن الكبائر؛ لأنّ مفسدتها أكبر، وإن كان ذلك على حساب ارتكاب الصغائر.
ثانيًا: إنّ الصغائر التي يكفّرها عدم ارتكاب الكبائر، هي التي تحصل من الإنسان بعض الأحيان، وليس التي تكون نهجًا في حياته، يصرّ عليها، ويستهين بها، فإنّها تتحول بذلك إلى كبائر.
ورد عن أمير المؤمنين عليٍّ  : «أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِه صَاحِبُه»[9] .
: «أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِه صَاحِبُه»[9] .
وجاء عن الإمام جعفر الصادق  : «لاَ صَغِيرَةَ مَعَ اَلْإِصْرَارِ»[10] .
: «لاَ صَغِيرَةَ مَعَ اَلْإِصْرَارِ»[10] .
وقد عرّف الإمام محمد الباقر  الإصرار، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ قَالَ
الإصرار، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ قَالَ  : «الْإِصْرَارُ هُوَ: أَنْ يُذْنِبَ الذَّنْبَ، فَلَا يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ، وَلَا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِتَوْبَةٍ، فَذَلِكَ الْإِصْرَارُ»[11] .
: «الْإِصْرَارُ هُوَ: أَنْ يُذْنِبَ الذَّنْبَ، فَلَا يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ، وَلَا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِتَوْبَةٍ، فَذَلِكَ الْإِصْرَارُ»[11] .
حقوق الناس كلّها كبائر
ومن المهم في هذا المجال ما نبّه إليه السيد السبزواري، بقوله: (تختصّ السيئات المكفّرة باجتناب الكبائر بحقوق الله تعالى، وأمّا حقوق الناس فلا تشملها الآية الشريفة، وتدلّ على ذلك الأخبار الكثيرة، مثل قوله  : «من ترك من أخيه حقًّا يطلبه به يوم القيامة»، مع أنّ جملة منها داخلة في الكبائر التي يكون اجتنابها شرطا للتكفير، ويشهد لما ذكرناه ما دلّ على أنّ «أوّل قطرة من دم الشهيد في سبيل الله تعالى توجب غفران ذنوبه إلّا ما كان من حقّ الناس»)[12] .
: «من ترك من أخيه حقًّا يطلبه به يوم القيامة»، مع أنّ جملة منها داخلة في الكبائر التي يكون اجتنابها شرطا للتكفير، ويشهد لما ذكرناه ما دلّ على أنّ «أوّل قطرة من دم الشهيد في سبيل الله تعالى توجب غفران ذنوبه إلّا ما كان من حقّ الناس»)[12] .
إنّ التجاوز على أيِّ حقٍّ من حقوق أحد من الناس هو في دائرة الكبائر، لأنه يعتبر ظلمًا، وقد نصّ القرآن الكريم على شدة العذاب للظالمين، فإنّ الله تعالى يعفو ويغفر التقصير في ما يرتبط بحقوقه تعالى، أما حقوق الناس فلا عفو عنها، إلّا إذا تنازل صاحب الحقّ عن حقّه، ويؤكد ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي  : «أَلَا وإِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ - فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ وظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ، وظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّه، قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه﴾، وأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ، فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَه عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ[13] ، وأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً، الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُوَ جَرْحًا بِاْلمُدَى[14] ، ولَا ضَرْبًا بِالسِّيَاطِ ولَكِنَّه مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَه»[15] .
: «أَلَا وإِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ - فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ وظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ، وظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّه، قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه﴾، وأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ، فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَه عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ[13] ، وأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً، الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُوَ جَرْحًا بِاْلمُدَى[14] ، ولَا ضَرْبًا بِالسِّيَاطِ ولَكِنَّه مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَه»[15] .
الخطاب الديني والمنهج القرآني
والمأمول من الخطاب الديني أن يؤكّد على اجتناب كبائر الذنوب، وألّا ينشغل بالحديث عن الصغائر على حساب الكبائر، فذلك خلاف غرض المنهج القرآني، ويبدو أنّ بعض الوعاظ والقصاصين السابقين، وبتوجيه من السلطات الأموية والعباسية، كانوا يتحدثون بتركيز أكبر على المخالفات الشرعية الصغيرة، ويتجاهلون الحديث عن الفساد والمظالم الاجتماعية.
لذلك نجد أمامنا تراثًا كبيرًا في سياق هذا المنهج، فهناك أحاديث وروايات تُهوّل وتُضخّم بعض المخالفات الجزئية لأحكام أو مستحبات شرعية، على حساب التشديد والتأكيد على الذنوب والمخالفات الأخطر في نظر الشرع وهي الكبائر.
وفي كتب الأحاديث التي تعنى بثواب الأعمال وعقابها، وبالترغيب والترهيب، عند السنة والشيعة نماذج كثيرة، نذكر منها:
الرواية الواردة عن الإمام جعفر الصادق  : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً مِنَ الْحَيَوَانِ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا»[16] .
: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً مِنَ الْحَيَوَانِ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا»[16] .
أي حتى ينفخ فيها روح الحياة، وذلك غير ممكن، مما يعني دوام العذاب له.
ورواية أخرى عنه  قَالَ: «أُقْعِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَخْيَارِ فِي قَبْرِهِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا أُطِيقُهَا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوا: لَيْسَ مِنْهَا بُدٌّ، فَقَالَ: فَبِمَا تَجْلِدُونِّي فِيهَا؟ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ يَوْمًا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، قَالَ: فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَارًا»[17] .
قَالَ: «أُقْعِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَخْيَارِ فِي قَبْرِهِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا أُطِيقُهَا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوا: لَيْسَ مِنْهَا بُدٌّ، فَقَالَ: فَبِمَا تَجْلِدُونِّي فِيهَا؟ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ يَوْمًا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، قَالَ: فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَارًا»[17] .
وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ [الإمام جعفر الصادق  ] يَقُولُ: «مَنْ مَضَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَقَدْ خُذِلَ، وَنَزَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ مَاتَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، كَانَ كَافِرًا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»[18] .
] يَقُولُ: «مَنْ مَضَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَقَدْ خُذِلَ، وَنَزَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ مَاتَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، كَانَ كَافِرًا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»[18] .
وعن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي  : «أما يخْشَى الَّذِي يرفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يحوّل الله رَأسه رَأس كلب»[19] .
: «أما يخْشَى الَّذِي يرفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يحوّل الله رَأسه رَأس كلب»[19] .
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ سَمِعت رَسُول الله  يَقُول: «إِذا صلى أحدكُم إِلَى شَيْء يستره من النَّاس، فَأَرَادَ أحد أَن يجتاز بَين يَدَيْهِ، فليدفع فِي نَحره، فَإِن أَبى فليقاتله، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان»[20] .
يَقُول: «إِذا صلى أحدكُم إِلَى شَيْء يستره من النَّاس، فَأَرَادَ أحد أَن يجتاز بَين يَدَيْهِ، فليدفع فِي نَحره، فَإِن أَبى فليقاتله، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان»[20] .
إنّ تداول مثل هذ الروايات في الخطاب الديني، يخلط الأوراق في أذهان المتديّنين، وقد يجعل الأولوية الحرص على تجنب المخالفات الجزئية، والتساهل في المخالفات الأشد خطرًا وضررًا.
جاء في صحيح البخاري عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لاِبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ  ، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ
، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ  يَقُولُ: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»[21] .
يَقُولُ: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»[21] .
إنّ من المهم تعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية في نفوس أبناء الجيل، ضمن المنهج القرآني والأولويات التي اعتمدها، والتأكيد على الارتباط بالله تعالى، واستهداف رضاه.