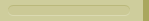الإنصاف أشدّ الفرائض على الإنسان
يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [سورة المائدة، الآية: 8].
في الحياة الاجتماعية هناك حقوق متبادلة بين الإنسان وأفراد مجتمعه، وكما يحرص الإنسان على حماية حقوقه ونيلها من الآخرين، عليه أن يحرص على احترام حقوق الآخرين وأدائها كاملة إليهم.
ويطلق على هذا النحو من التعامل عنوان الإنصاف، أن يأخذ الإنسان حقّه دون زيادة، ويعطي للآخر حقّه دون إنقاص.
لذلك جاء في تعريف الإنصاف أنه العدل، كما ورد عن أمير المؤمنين علي  في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾، قال
في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾، قال  : «الْعَدْلُ الْإِنْصَافُ، وَالْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ»[1] .
: «الْعَدْلُ الْإِنْصَافُ، وَالْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ»[1] .
وقال المناوي: الإنصاف والعدل توأمان[2] .
والإنصاف لغة: مأخوذ من النِّصْف، وهو أحد شقّي الشيء بالتساوي.
أشدّ ما فرض الله
لحب الإنسان لذاته فإنه غالبًا ما ينحاز لنفسه، ويسعى لكي يأخذ من الآخرين أكثر من حقه، ويحيف على حقوقهم بإنكارها أو إنقاصها.
ويحتاج الإنسان إلى يقظة ضمير، وقوة إرادة، حتى يكون منصفًا للآخرين، خاصة في موارد النزاع والاختلاف.
لذلك ورد عن الحسن البزاز قال: قال لي أبوعبدالله [الإمام جعفر الصادق  ]: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ؟ فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، أَوَّلُهَا إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ»[3] .
]: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ؟ فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، أَوَّلُهَا إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ»[3] .
لأنّ إنصاف الإنسان الآخرين من نفسه يحتاج إلى كثير من مخالفة الهوى ومجاهدة النفس، والتغلّب على النزعة الذاتية، وبذلك يكون أشدّ ما فرض الله تعالى على خلقه، ويكون أهم سلوك يمارسه الإنسان، كما روى الإمام جعفر الصادق  عن جدّه رسول الله
عن جدّه رسول الله  أنه قال: «سَيِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ»[4] .
أنه قال: «سَيِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ»[4] .
وأطلق القرآن الكريم على من يحيف على حقوق الآخرين، ويتجاوز الإنصاف صفة التطفيف، وسمّاهم المطففين، وهو اسم سورة قرآنية.
يقول تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة المطففين، الآيات: 1-6]
إنّ من يدفعه هواه لتجاوز إنصاف الآخرين في الدنيا، سيدفع ثمنًا باهظًا في الآخرة، ويصيبه الويل والهلاك، فكيف يحيف على حقوق الآخرين من يؤمن بالقيامة والحساب؟!
ومما جاء في عهد أمير المؤمنين علي  لمالك الأشتر: «أَنْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ [أي: أبطل] حُجَّتَهُ، وَكَانَ للهِ حَرْباً حَتَّى يَنْزِعَ وَيَتُوبَ»[5] .
لمالك الأشتر: «أَنْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ [أي: أبطل] حُجَّتَهُ، وَكَانَ للهِ حَرْباً حَتَّى يَنْزِعَ وَيَتُوبَ»[5] .
الإنصاف مع الله
يتحدّث الإمام علي  عن الإنصاف مع الله ثم مع الناس. إنّ على الإنسان أولًا أن ينصف الله من نفسه، بمعنى ألّا يحيف على حقوق الله لصالح أهواء نفسه.
عن الإنصاف مع الله ثم مع الناس. إنّ على الإنسان أولًا أن ينصف الله من نفسه، بمعنى ألّا يحيف على حقوق الله لصالح أهواء نفسه.
إنك تأخذ من نعم الله تعالى كلّ وجودك وحاجات حياتك، وكلّ ما تستمتع به، وتطلب من الله ما تريد وما ترغب، ثم لا تعطي من نفسك لله جزءًا مما أنعم الله عليك، وفاءً لحقّ شكره واستجابة لأمره، فأيّ حيفٍ أكبر من هذا؟ وأيّ تجاوز للإنصاف أوضح منه؟
إنّ الله تعالى منحك الوجود، وأعطاك القوة والقدرة، فكلّ لحظات وساعات وأيام حياتك من الله تعالى، وقد فرض عليك عبادته كأداء الصلاة اليومية، وهي لا تأخذ إلّا جزءًا من الزمن والجهد الذي أعطاك الله، فكيف تحيف على هذا الحقّ، بترك الصلاة أو الاستخفاف بها وتأخيرها عن وقتها، أو أدائها بملل وكسل وسرعة مخلّة؟ أليس ذلك تجاوزًا للإنصاف مع الله تعالى؟
ورد عن الإمام جعفر الصادق  : «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ  جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ
جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ  : نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَهَكَذَا صَلَاتُهُ، لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي»[6] .
: نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَهَكَذَا صَلَاتُهُ، لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي»[6] .
وورد عن عبدالرحمن بن شبل: «نهى رسولُ اللهِ  عن نقرةِ الغُرابِ»[7] . أي: يضَعُ رأسَه ويَرفعُه سريعًا مِثلَ الغُرابِ الَّذي يَنقُرُ الأرضَ.
عن نقرةِ الغُرابِ»[7] . أي: يضَعُ رأسَه ويَرفعُه سريعًا مِثلَ الغُرابِ الَّذي يَنقُرُ الأرضَ.
من جانب آخر، فإنّ الله تعالى هو الذي يتفضّل عليك بالإمكانات والمال، إذ يعطيك قوة الكسب وقدرة العمل ويسخّر لك ثروات الحياة، ثم يفرض عليك بعض الحقوق المالية المحدودة، كالزكاة والخمس، بعد أن تستكمل كلّ احتياجات حياتك ومصارف معيشتك، فهل من الإنصاف مع الله تعالى أن تبخل بأداء ما عليك من الحقوق الشرعية؟
ويصوّر هذا الموقف المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي في أحد كتبه قائلًا: كان لإنسان عبد، فسافر هو وعبده إلى بلد بعيد، وترك عائلته في بلده، وبعد فترة كتب إليه بعض عياله يقول: إنّ نفقتنا قد انتهت وأننا بأشدّ الحاجة إلى المال، فأعطى السيد لعبده ألف دينار وقال له: اذهب وسلّم المال إلى عائلتي، وهذه عشرون دينار لأجل سفرك، فلما ابتعد العبد قليلاً ناداه سيّده وقال له: إنّ مائتين من الألف أيضاً لك، وسلّم إلى عائلتي ثمانمائة، قال العبد: أيها السيد.. إنّي رهين إحسانك ومنتك، وقد أعطيتني نفقة السفر، فلا حاجة بالزائد، قال السيد: اسمع كما أقول لك، فشكره العبد، وما إن مشى خطوات حتى ناداه السيد وقال له: لك أربعمائة، وسلّم ستمائة إلى عائلتي، فلما ابتعد قليلًا، وذهب غير بعيد، وإذا بالسيد يناديه ويقول له: لك ستمائة ولعائلتي أربعمائة، فكرّر العبد كلامه السابق، وكرّر السيد إصراره، فأكثر العبد من شكره، ولم ينقل خطواته حتى ناداه السيد قائلًا: لك ثمانمائة والبقية لعائلتي، فذهب العبد ووصل إلى بلد السيد، لكنه لم يسلّم المال إلى عائلة السيد، وكلّما طالبوه، وهم في أشدّ الحاجة، لم يعطهم العبد شيئًا!!
ترى كيف يكون هذا العبد؟ وماذا يستحقّ من العقاب؟ إنك إذا غضبت على العبد، وتمنيت أن توجعه لو رأيته، فتعالَ معي لأريك العبد، إنّ ذلك العبد هو أنت بالذات إذا منعت الخمس، لقد تفضّل الله عليك بكلّ شيء، وقال لك اصرف مؤونتك مما منحته لك، فإذا زاد عن سنتك شيء فخذ من كلّ ألف ثمانمائة، وأنفق لعيالي (والفقراء عيالي) مائتين، وإنك أعرضت عن أمر الله، ولم تنفق على عياله حتى الخمس، فاحكم أنت بنفسك على نفسك.. وإذا هزتك هذه القصة فما عليك إلّا أن تحاسب في نفس هذا اليوم، وتؤدي حقوق الله كما أمر الله[8] .
إنصاف الناس
أما الجهة الثانية من الإنصاف، فهي إنصاف الناس الذين تتعامل معهم في هذه الحياة، بأن تحترم حقوقهم المادية والمعنوية كما تحرص على احترام حقوقك من قبلهم.
وهذا ما ينبض به ضمير الإنسان ووجدانه، وما يأمر به ويؤكد عليه الدين، فلا يجوز للإنسان أن ينحاز لذاته أو لأقربائه أو لأحبته على حساب حقوق الآخرين، مهما كانوا مختلفين عنه في الانتماء الاجتماعي والديني، وحتى لو كانوا مخالفين أو معادين له.
يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [سورة النساء، الآية: 135].
فلا يصحُّ أن ينقاد الإنسان لعاطفته، فينحاز لذاته أو لأقرب أقربائه على حساب حقوق الآخرين، بغضّ النظر عن انتمائهم الديني أو مكانتهم الاجتماعية.
ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [سورة المائدة، الآية: 8].
وفي الآية الكريمة تحذير شديد من تجاوز العدل والإنصاف حتى مع المعادين والمبغضين، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ أي لا يدفعكم، ﴿شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ أي عداوتهم وبغضهم، ﴿عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ أي لترك العدل في التعامل معهم.
إنّ الدين يوجه الإنسان إلى أن يكون منصفًا حتى مع من لا يكون منصفًا له، روي عن أمير المؤمنين علي  : «اَلْمُؤْمِنُ يُنْصِفُ مَنْ لاَ يُنْصِفُهُ»[9] .
: «اَلْمُؤْمِنُ يُنْصِفُ مَنْ لاَ يُنْصِفُهُ»[9] .
وفي كلمة أخرى عنه  : «أَعْدَلُ اَلنَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ مَنْ ظَلَمَهُ»[10] .
: «أَعْدَلُ اَلنَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ مَنْ ظَلَمَهُ»[10] .
مشاهد انعدام الإنصاف
إننا نشهد بعض مظاهر انعدام الإنصاف في حياتنا الاجتماعية، ومن أسوأ تجلياتها ما نراه في الخلافات الزوجية حين يضغط أحد الطرفين الزوج أو الزوجة، لنيل كلٍّ حقه من الطرف الآخر، بل وأكثر من حقه، ثم يحيف على حقّ زوجه.
كما نشهد تجليًا آخر في توزيع الإرث بين الورثة، حيث يتعنّت بعض الورثة، فيماطلون في تقسيم الإرث، أو أخذ ما يزيد على حقهم، وكلّ ذلك ظلم وتجاوز للإنصاف.
ومن التجليات الخطيرة لانعدام الإنصاف، جور الخصوم بعضهم على بعض في حالات الخلاف والنزاع، ومحاولات الالتفاف على أحكام الشرع والقانون.
ومن أسوأ مظاهر عدم الإنصاف، ما نراه في حالات الاختلافات الدينية والفكرية بين أتباع المذاهب، أو بين المختلفين فكريًا داخل المذهب الواحد، حيث تحصل حالات الافتراء والطعن بغير حقّ، وتوجيه الاتهامات الكاذبة، وانكار أيّ إيجابية للطرف الآخر، وهذا ما نهى عنه القرآن الكريم، وما يخالف نهجه في الحديث عن المخالفين للدين، فإنه تعالى يقول عن أهل الكتاب: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [سورة آل عمران، الآية: 75]، ففي ظلّ ظروف الصراع مع اليهود تأتي مثل هذه الآية الكريمة، لتمنع صدور أحكام كاسحة سلبية على جميع أهل الكتاب، وأنّهم ليسوا جميعًا يخونون ما اؤتمنوا من مال، بل فيهم أمناء يحفظون الأمانة ولو كانت أموالًا طائلة.
ورد عن أمير المؤمنين علي  : «قَلَّمَا يُنْصِفُ اَللِّسَانُ فِي نَشْرِ قَبِيحٍ أَوْ إِحْسَانٍ»[11] .
: «قَلَّمَا يُنْصِفُ اَللِّسَانُ فِي نَشْرِ قَبِيحٍ أَوْ إِحْسَانٍ»[11] .
الإنصاف مكاسب عظيمة للإنسان
إنّ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تسوّل للإنسان تجاوز الإنصاف مع الآخرين، إحرازًا لبعض المكاسب والمصالح، لكنّ الحقيقة أنّ ذلك يوقع الإنسان في خسائر فادحة في الدنيا ولو بعد حين، وفي الآخرة.
بينما يحقق الإنصاف للإنسان أعلى المكاسب الحقيقية داخل نفسه وفي حياته الاجتماعية، وعند منقلبه في الآخرة.
إنّ سلوك الإنصاف يثري المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان، ويبعده عن عذاب الضمير، ويريحه من تراكمات الحقد والبغضاء على قلبه.
ورد عن أمير المؤمنين علي  : «اَلْإِنْصَافُ رَاحَةٌ»[12] .
: «اَلْإِنْصَافُ رَاحَةٌ»[12] .
كما أنّ الإنصاف ينقذ الإنسان من عناء العداوات والنزاعات الاجتماعية، خاصة مع القريبين منه.
ورد عن أمير المؤمنين علي  : «اَلْإِنْصَافُ يَرْفَعُ اَلْخِلاَفَ وَيُوجِبُ اَلاِئْتِلاَفَ»[13] .
: «اَلْإِنْصَافُ يَرْفَعُ اَلْخِلاَفَ وَيُوجِبُ اَلاِئْتِلاَفَ»[13] .
والأثر الأهم للإنصاف النجاة من عذاب الله، ونيل رضاه وتوفيقه.
ورد عن أمير المؤمنين علي  : «أَنْصِفْ مِنْ نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْتَصَفَ مِنْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجَلُّ لِقَدْرِكَ، وَأَجْدَرُ بِرِضَا رَبِّكَ»[14] .
: «أَنْصِفْ مِنْ نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْتَصَفَ مِنْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجَلُّ لِقَدْرِكَ، وَأَجْدَرُ بِرِضَا رَبِّكَ»[14] .
وعنه  : «إِنَّكَ إِنْ أَنْصَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَزْلَفَكَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ»[15] . أي قرَّبك الله.
: «إِنَّكَ إِنْ أَنْصَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَزْلَفَكَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ»[15] . أي قرَّبك الله.
وعنه  : «أَلَا إِنَّهُ مَنْ يُنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا عِزًّا»[16] .
: «أَلَا إِنَّهُ مَنْ يُنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا عِزًّا»[16] .
قد يسوّل الشيطان للإنسان أنّ في الإنصاف إبداءً لحالة ضعف وتنازل، لكنّ الله تعالى يزيد المنصف عزًّا ومجدًا.