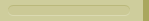تبادل الخبرات والتجارب بين المجتمعات
يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [سورة الحجرات، الآية: 13].
لكلّ مجتمع من المجتمعات الإنسانية خبراته وتجاربه التي تنعكس على أساليب إدارة الحياة، وتشكيل الأعراف والتقاليد في ذلك المجتمع.
وتتنوع تلك الخبرات والتجارب بتنوع ثقافات المجتمعات، واختلاف ظروف حياتها البيئية والاجتماعية.
ولعلّ من أغراض الدعوة الإلهية للتعارف بين الجماعات والمجتمعات البشرية، اطّلاع كلّ مجتمع على خبرات وتجارب المجتمعات الأخرى من أجل الاستفادة المتبادلة فيما بينها.
لتعارفوا
يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [سورة الحجرات، الآية: 13].
إنه نداء وخطاب لجميع الناس على نحو العموم الاستغراقي، بمختلف أعراقهم وقوميّاتهم وثقافاتهم، وفي جميع الأزمنة والأمكنة.
ويذكّرهم الله تعالى بأنهم على تنوعهم يعودون لأصل واحد ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ﴾، فقد تناسل أبناء البشر كلّهم من رجلٍ يقال له آدم، وامرأة يقال لها حواء.
وإنّ حكمة الله تعالى اقتضت تنوعهم، حيث انتشروا في ربوع الأرض ضمن جماعات كبيرة يطلق عليها شعوب، وصغيرة يطلق عليها قبائل، ونظرًا لاختلاف الأجواء والظروف الطبيعية التي عاشوها في أنحاء الأرض، فقد أفرزت حالات من الاختلاف في المظاهر والأشكال بين الجماعات البشرية، وتشكّلت لكلّ جماعة خبراتها وتجاربها.
لكنّ هذا التنوع بين الناس كشعوب وقبائل، واختلافهم في خصائصهم وثقافاتهم وخبراتهم وتجاربهم، لا ينبغي أن يدفعهم للصدام والتّنازع، ولا أن يخلق الحواجز بينهم، فتنغلق كلّ جماعة على نفسها، وينعزل كلّ شعب عن الشعوب الأخرى.
بل المطلوب أن يكون التنوع حافزًا للتعارف، يقول تعالى: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ بأن تتعرف كلّ أمة أو شعب أو مجتمع، على ما لدى الآخرين من خبرات وتجارب، وتأخذ بما يفيدها منها. وذلك لمصلحة الحياة الإنسانية بشكل عام.
وهذا ما ينسجم مع التفكير العقلي المنطقي للإنسان، لكن هناك في كثير من الأحيان عوائق نفسية تحول دون الاستجابة لهذه الدعوة الإلهية والتفكير العقلي، ومن أبرزها المشاعر العنصرية التي توهم كلّ جماعة بالاكتفاء بما لديها، وأنها أفضل وأعلى من الجماعات الأخرى، وأنها أولى منها بالمصالح والمكاسب.
وفي مواجهة هذه المشاعر العنصرية السلبية، يقول تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، فالعرق والجنس والانتماء القومي والقبلي، ليس معيارًا للتفاضل والتمايز، وإنّما الالتزام بالقيم والمبادئ ضمن المعايير والمقاييس الإلهية ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.
إنّ مشكلة كثير من المجتمعات تضخم الذات الجمعية ووهم التميّز على الآخرين.
نقلوا عن كاهن حكيم أنه قال في خطاب لأبناء بلده، إنه يحب أن يعرف لماذا إذا تبجح أحدهم بأنه أذكى وأقوى، وأشجع أو أكثر الرجال موهبة على الأرض، يُعتقد أنه سخيف ومحرج، في حين أنه لو استبدل "أنا" بالقول: "نحن أكثر الشعوب ذكاءً، وقوةً، وشجاعةً وموهبةً على الأرض"، فإنّ مواطنيه سيصفقون له بحماسة ويصفونه بالوطني[1] .
مواقف تجاه الانفتاح على الآخر
حين نرصد مواقف الأمم والمجتمعات تجاه تجارب الآخرين وخبراتهم، نرى ثلاثة ألوان من المواقف:
الموقف الأول: الانغلاق على الذات، والاكتفاء بمخزون التراث، والتمسّك بالأعراف والتقاليد السائدة. ضمن المنطق الذي نقله القرآن الكريم عن المجتمعات التي رفضت رسالات الأنبياء.
يقول تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [سورة المائدة، الآية: 104].
إنّ بعض المجتمعات قد ترفض أو تتردد في الاستفادة من تجارب ناجحة لمجتمعات مجاورة لها، أو شريكة لها في الانتماء الديني، لصعوبة قبول التغيير والتطوير في أوساطها.
الموقف الثاني: فقدان الثقة بالذات والانبهار بالآخر، خاصة حينما يكون في موقع التفوق والتقدم، واتّباعه حتى في نقاط الضعف والأمور السلبية.
يقول ابن خلدون في مقدمة تاريخه: إنّ المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده[2] .
الموقف الثالث: الاستفادة الواعية من تجارب الآخرين، بدراستها وأخذ المفيد منها، واجتناب ما يخالف القيم والمبادئ، وما لا يتناسب مع ظروف المجتمع ومصالحه.
الحكمة ضالة المؤمن
وحسب المصطلح الديني أخذ الحكمة من الآخرين. وهو ما تدلّ عليه النصوص الدينية التي دعت إلى أخذ الحكمة من أيّ مصدر كانت، كالحديث الوارد عن النبي  : «الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»[3] .
: «الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»[3] .
وورد عن أمير المؤمنين علي  : «الحِكمَةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ؛ فَاطلُبوها ـ ولَو عِندَ المُشرِكِ ـ تَكونوا أحَقَّ بِها وأهلِها»[4] .
: «الحِكمَةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ؛ فَاطلُبوها ـ ولَو عِندَ المُشرِكِ ـ تَكونوا أحَقَّ بِها وأهلِها»[4] .
وعنه  : «الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ»[5] .
: «الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ»[5] .
والأصل في معنى الحكمة لغة: هي الإحكام والإتقان في علم أو عمل أو قول، تقول: أحكمت الشيء فاستحكم: أي صار محكمًا. والأمر المحكم: المتقن الذي لا يوجد فيه ثغرة ولا خلل.
ومعلوم أنّ الأمور الدينية، من المعتقدات والتشريعات، لا تؤخذ ولا تطلب إلّا من المصادر والجهات المعتمدة. أما الأمور المرتبطة بإدارة شؤون الحياة فيمكن استفادتها وأخذ النافع منها من تجارب البشر وخبراتهم، بغضّ النظر عن توجهاتهم الدينية والسلوكية، وبهذا يتضح أنّ الحكمة التي هي ضالة المؤمن في هذه النصوص هي ما يرتبط بإدارة الحياة.
وحينما حاصر المشركون واليهود المدينة المنورة وكانوا قوة كبيرة، فيما عرف بالأحزاب، في السنة الخامسة للهجرة، شاور النبي  أصحابه في طريقة الدفاع ومواجهة الأعداء، فاقترح البعض التحصّن والدفاع من داخل القلاع والحصون، لكنّ كثافة جيش الأعداء يغريهم بالهجوم على الحصون والقلاع وهدمها.
أصحابه في طريقة الدفاع ومواجهة الأعداء، فاقترح البعض التحصّن والدفاع من داخل القلاع والحصون، لكنّ كثافة جيش الأعداء يغريهم بالهجوم على الحصون والقلاع وهدمها.
هنا قال سلمان الفارسي  : يَا رَسُولَ اللهِ، إنّا إذْ كُنّا بِأَرْضِ فَارِسَ، وَتَخَوّفْنَا الْخَيْلَ، خَنْدَقْنَا عَلَيْنَا، فَهَلْ لَك يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نُخَنْدِقَ؟[6]
: يَا رَسُولَ اللهِ، إنّا إذْ كُنّا بِأَرْضِ فَارِسَ، وَتَخَوّفْنَا الْخَيْلَ، خَنْدَقْنَا عَلَيْنَا، فَهَلْ لَك يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نُخَنْدِقَ؟[6]
فأعجب النبي  والمسلمون برأيه وحفروا الخندق. وحينما اقترب الأحزاب إلى المدينة فوجئوا به وقالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها قبل ذلك، فقيل لهم: هذا من تدبير الفارسي الذي معه[7] .
والمسلمون برأيه وحفروا الخندق. وحينما اقترب الأحزاب إلى المدينة فوجئوا به وقالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها قبل ذلك، فقيل لهم: هذا من تدبير الفارسي الذي معه[7] .
التشبّه بغير المسلم
هناك مسألة ذكرها الفقهاء بعنوان: التشبه بغير المسلم، أو التشبه بالكفّار، ويقصدون به الظهور بالمظهر المختص بالكفار، حيث اعتبرها بعض الفقهاء حرامًا، وبعضهم رآها مكروهًا.
وذلك بهدف منع الذوبان والانصهار في الأجواء المخالفة للدين، ولا يشمل ذلك أخذ الجوانب الإيجابية التي لا توحي بالانصهار الثقافي والسلوكي.
ويلحظ أنّ لفظ التشبّه الوارد في بعض النصوص من هيئة التّفعْل، تختزن معنى التوجه والقصد، بأن يكون الفعل مقصودًا منه ذلك.
وقد بالغ البعض حتى حرّموا كلّ شيء يمارسه الآخرون من غير المسلمين، وإن كان مباحًا في الأصل، أو كان مفيدًا، ما دام فيه مشابهة لهم، فمثلًا إهداء الزهور والورود للمرضى، صدرت فتاوى في تحريمها، لأنها إسراف وتقليد أعمى للغرب.
وكتب أحد علماء المسلمين كتابًا، بحث فيه الضجة التي حصلت في بعض أوساط الفقهاء، حول تحريم لبس البنطلون سماه (ضجيج الكون من لبس البنطلون) للشيخ سالم بن أحمد بن جندان (1906- 1969م)، وهو محدّث ومؤرخ ونسابة وكاتب ورحالة إندونيسي ذو أصول حضرمية.
والمؤلف لا يتبنّى التحريم بل يعرض ويردّ أدلة القائلين به.
الانفتاح الواعي هو المطلوب
ولا بُدّ من التأكيد أنّ الانفتاح المطلوب على تجارب الآخرين وخبرات المجتمعات المختلفة، يجب أن تصاحبه دراسة واعية لاقتباس المناسب منها لمصالحنا وظروفنا، والمنسجم مع قيمنا ومبادئنا، واجتناب ما لا يكون كذلك.
ففي هذا العصر نعيش في ظلّ حضارة مادية متقدمة تقودها المجتمعات الغربية، وعلينا أن نستفيد من نقاط القوة في هذه المجتمعات، ونأخذ من تجاربهم وخبراتهم في المجال العلمي والإداري، وسائر ما يساعدنا على تطوير أوطاننا ومجتمعاتنا، لكن عندهم نقاط ضعف واضحة، يعترف بها مفكرون وباحثون منهم، فيما يرتبط بالجانب القيمي والروحي والأخلاقي، فلا ينبغي أن نستوردها ونأخذها منهم، تحت تأثير حالة الانبهار وفقد الثقة بالذات الحضارية. والانسياق ضمن إغراءات الدعاية والإعلام.
إنّ هيمنة النزعة المادية الأنانية، والفراغ الروحي، وانحسار القيم الأخلاقية في العلاقات الاجتماعية، وشياع الابتذال الجنسي والميوعة الأخلاقية، تمثل نقاط ضعف في حضارتهم، فلماذا نقتبسها ونستوردها منهم بدل أن نقتبس من نقاط القوة لديهم؟
إنّ الله تعالى يبشر عباده ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [سورة الزمر، الآية: 18].
جعلنا الله منهم، ووفقنا لاجتناب مساوئ الأخلاق، ومظاهر الفساد.