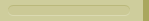ثقافة العيب بين التزمّت والانفلات
يقول تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: 53].
كما يحتاج الإنسان في الحياة الاجتماعية إلى اللغة لتكون أداة للفهم والتفاهم بينه وبين الآخرين، فإنه يحتاج إلى وجود نظام وتقاليد متعارف عليها، لتنظيم السلوك الاجتماعي.
لذلك لا يكاد يخلو مجتمع إنساني، من وجود عادات وأعراف يلتزم بها أفراده في الحياة العامة. ويعتبرون اختراقها ومخالفتها وصمة وخللًا في شخصية من يقوم بذلك.
وهذا هو معنى العيب في اللغة، فهو الوصمة أو الخلل.
وفي المصطلح الاجتماعي: العيب هو التصرف غير الملائم الذي ينظر إليه المجتمع أنه سلوك سيّئ، أو غير لائق.
العيب والحرام
والعيب عنوان مستقل إلى جانب عنوان الحرام في المجتمعات الدينية، وقد تتداخل بعض مصاديقهما، لكنّ مفهوم كلٍّّ منهما يختلف عن الآخر. فالحرام حكم شرعي مخالفته توجب سخط الله تعالى، أما العيب فهو حكم اجتماعي يفقد الإنسان بسببه احترام الآخرين ويناله ازدراؤهم.
وقد ينطبق العنوانان على بعض الممارسات والتصرفات، فتكون حرامًا شرعًا وعيبًا اجتماعيًا، كالسرقة والخيانة مثلًا.
وقد يكون الشيء عيبًا لكنّه ليس حرامًا، كما لو طرد الإنسان ضيفه، أو خرج الرجل للناس دون ارتداء ملابس، إلّا ما يستر عورته.
العيب صناعة مجتمعية
ولأنّ العيب صناعة مجتمعية تختلف مصاديقه في المجتمعات والعصور، لاختلاف الثقافات والعادات، فما يكون عيبًا في زمن أو في مجتمع، قد لا يكون كذلك في زمن ومجتمع آخر.
فمثلًا إلى ما قبل عقود قليلة من الزمن، ما كان يسمح للزوج في مجتمعاتنا أن يلتقي زوجته بعد العقد الشرعي، وقبل ليلة الدخول بها، ويعتبر ذلك عيبًا وقلّة حياء، أما الآن فقد زالت هذه النظرة ولم يعد ذلك عيبًا، وأصبح أمرًا طبيعيًّا يتقبّله المجتمع. بل أصبح مستنكرًا انعدام التواصل، أو ضعفه بين الزوجين فترة الخطوبة.
وكمثال على اختلاف مصاديق العيب في المجتمعات، فإنّ من المشاهد المألوفة في إيران أن ترى معمّمًا ينتمي إلى سلك طلبة العلوم الدينية، يقود (موتر سيكل) ويردف خلفه زوجته، لكنّ مثل هذا المشهد، قد لا يكون مقبولًا في مثل مجتمعنا، ويعتبر عيبًا ومخالفًا للمروءة.
يطالبون بتجاوز ثقافة العيب
في غمرة التحولات الثقافية التي تعصف بالمجتمعات الإنسانية المعاصرة في ظلّ هيمنة الثقافة الغربية، هناك من يطالب بتجاوز ثقافة العيب، لأنها تصطدم مع الحرية الفردية، فلماذا يجد الإنسان نفسه ملزمًا بقيود يفرضها عليه العرف الاجتماعي، وهي متوارثة من زمن سابق؟ فليفعل الإنسان ما يحلو له، وليمارس ما يرغب فيه، وليس عليه أن يبالي ويهتم برأي الآخرين ونظرتهم إليه، فله حقَّ التمرّد على الأعراف والتقاليد، وليس من حقّ الآخرين أن يصادروا حريته، بل عليهم أن يحترموا شخصيات الأفراد وخياراتهم.
إنّ الثقافة الغربية تقدّس الحريات الفردية، ولو كانت على حساب البعد الاجتماعي في الحياة الإنسانية، كتفكيك البناء الأسري العائلي وإضعاف التماسك الاجتماعي.
فليس مهمًّا أن تكون للإنسان أسرة وحياة عائلية، أو أن يورّط نفسه بالإنجاب ورعاية الأبناء، وهو ليس معنيًّا بحياة والديه، أما صلة الرحم فعملة قديمة لا ينبغي أن ينشغل بها الإنسان عن مراكمة مكاسبه المادية، وخدمة مصالحه ورغباته، فضلًا عن حسن الجوار، أو حماية التضامن والتكافل الاجتماعي.
وانطلاقًا من ثقافة الفردانية المتطرفة، لا مكان لثقافة العيب في المجتمعات المادية المعاصرة.
ويُراد لهذه الثقافة أن تنسخ وتلغي ثقافة سائر المجتمعات، لهذا نراها تزحف إلى مجتمعاتنا. ومؤدى هذه الثقافة هو الانفلات القيمي والأخلاقي، وتذويب الهُوية الثقافية للمجتمع.
في المقابل نجد حالة تزمّت في بعض مجتمعاتنا، بالإصرار على بعض الأعراف والعادات التي قد لا تكون مفيدة ولا مناسبة لتطورات الحياة الاجتماعية، وإعلان الحرب على من لا يتمسّك بها، وبعضها قد يكون مخالفًا لهدي الدين وتوجيهاته. مثل الإسراف والمبالغة في الولائم والضيافات، فقد يعاب من لا يقوم بذلك ويتهم بالبخل.
الوظيفة المهمة لثقافة العيب
إنّ الوظيفة المطلوبة من ثقافة العيب في المجتمعات الإنسانية، هي تعزيز الهوية الاجتماعية، واحترام الذوق العام، وضبط الممارسات والسلوك في إطار القيم والأخلاق.
حيث تقوم الأسرة بالدور الأساس في التربية على الالتزام بالذوق العام والآداب الاجتماعية، عبر تفعيل ثقافة العيب في نفوس وسلوك الأبناء، ثم يأتي دور المدرسة ووسائل الإعلام والتوعية الاجتماعية. لتبيين خلفيات هذه الثقافة وآثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع، حتى يلتزم بها الأفراد عن وعي واقتناع، وليس مجرّد أوامر أو قيود مفروضة.
ولأنّ ثقافة العيب لا تنطلق دائمًا من الأحكام الشرعية، وإنّما تعبّر عن آداب وأعراف اجتماعية، لذلك فإنها يجب أن تخضع للمراجعة والتطوير والتغيير، فقد يكون بعضها غير مناسب للظروف الجديدة في الحياة الاجتماعية.
وتأتي في هذا السياق كلمة نسبها ابن أبي الحديد إلى أمير المؤمنين علي  : «لا تُقْسِروا أَوْلادَكُمْ عَلى آدابِكُم، فَاِنَّهُم مَخْلوُقوُنَ لِزَمانٍ غَيْرِ زَمانِكُم»[1] .
: «لا تُقْسِروا أَوْلادَكُمْ عَلى آدابِكُم، فَاِنَّهُم مَخْلوُقوُنَ لِزَمانٍ غَيْرِ زَمانِكُم»[1] .
وهذه الرواية لم ترد في أيّ مصدرٍ من المصادر، بل انفرد ابن ابي الحديد بنسبتها للإمام، دون ذكر سند أو مصدر.
لكنّ بعض الكتب نسبتها إلى أفلاطون الذي عاش بين 427 إلى 347 قبل الميلاد، وبغضّ النظر عن قائل هذه الكلمة، يهمّنا معنى الكلمة ومضمونها، وهو معنى صحيح.
إنه لا يصح التشدد في الالتزام ببعض العادات والتقاليد، ما لم يكن هناك مخالفة للأحكام الشرعية. فلا بُدّ من الفرز والتصفية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
الذوق العام والآداب الاجتماعية
إنّ من الأهمية بمكان تنشئة الأبناء وتوعية الجيل الشاب من الفتيان والفتيات، على رعاية الذوق العام والتزام الآداب والأخلاق الفاضلة، في السلوك الفردي والاجتماعي، لحمايتهم من الانجراف مع تيار الفردانية المتطرفة التي تبشّر بها ثقافة الغرب المادية.
إنه لا يصح أبدًا أن نتجاهل كلمة (عيب)، أو نسقطها من قاموسنا، فذلك يعني قبول الانفلات الأخلاقي، وضياع الآداب الاجتماعية، وفقدان الموروث الإنساني الإيجابي من تاريخنا وثقافتنا.
كما لا يصحّ أن تصبح كلمة (عيب) عنوانًا لحالة بوليسية قمعية متزمتة، فذلك يؤدي إلى النفور والتمرّد على الأخلاق والقيم.
إننا حين نقول للطفل الصغير عن بعض التصرفات (عيب)، يجب أن نقولها بشفقة ومحبّة، مع توجيه يناسب سنّه وإدراكه، من أجل تنشئته على مراعاة ضوابط السلوك الإنساني، ليهتم بذلك في مرحلة مراهقته وشبابه، وحين نقول للكبير إذا ارتكب إساءة، (عيب عليك)، فيجب أن يكون ذلك بلباقة وإبداء حرص على قيمته ومكانته، لدفعه لمراجعة سلوكه الخطأ، لأنّ نتيجته ستكون فقدان الاحترام في المجتمع.
لا بُدّ أن نؤكد أنّ إهمال الوالدين عيب، وأنّ عدم الاهتمام بالأقرباء والأرحام والجيران عيب، وأنّ عدم احترام الكبير عيب، وأنّ عدم الاحتشام في العلاقات بين الجنسين عيب، وأنّ البخل عيب، وأنّ تجريح مشاعر الآخرين عيب، وهكذا سائر الموارد والمصاديق المشابهة.
إذا فُقد الحياء
إنّ عدم مبالاة الإنسان بسمعته واحترامه في محيطه الاجتماعي، يعني فقدان الحياء، والانزلاق نحو الانفلات من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة.
وكما ورد عن رسول الله  : «إنَّ مِمَّا أدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعْ مَا شِئْتَ»[2] .
: «إنَّ مِمَّا أدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعْ مَا شِئْتَ»[2] .
إنّ مشاعر الحياء تشكّل حافزًا لرعاية الآداب الاجتماعية، وحاجزًا عن اختراق الذوق العام، فإذا فُقد الحياء سقطت كلّ الخطوط الحمراء في نفس الإنسان، وأصحب أسير أنانيته، ومنقادًا لشهواته ورغباته.
والآية الكريمة ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: 53].
تشير إلى أنّ النبي  كان يتحمّل أذى ثقل بعض الضيوف الذين يدعوهم لتناول الطعام في بيته، ثم يطيلون الجلوس عنده مستأنسين بالكلام والتحادث فيما بينهم، على حساب وقت رسول الله الثمين، وعلى حساب راحته وبرامجه الخاصة، فلا يطلب منهم الخروج من منزله، لأنّ حياءه كان يمنعه من ذلك، باعتبار أنّ ذلك يخالف أعراف الضيافة ويخدش مشاعرهم.
كان يتحمّل أذى ثقل بعض الضيوف الذين يدعوهم لتناول الطعام في بيته، ثم يطيلون الجلوس عنده مستأنسين بالكلام والتحادث فيما بينهم، على حساب وقت رسول الله الثمين، وعلى حساب راحته وبرامجه الخاصة، فلا يطلب منهم الخروج من منزله، لأنّ حياءه كان يمنعه من ذلك، باعتبار أنّ ذلك يخالف أعراف الضيافة ويخدش مشاعرهم.
وقد تكفّل الوحي بتوجيههم، دون أن يتخلّى النبي  عن الالتزام برفيع أخلاقه، ليعطينا درسًا في أهمية تجذّر الحياء في نفس الإنسان وانعكاسه على سلوكه.
عن الالتزام برفيع أخلاقه، ليعطينا درسًا في أهمية تجذّر الحياء في نفس الإنسان وانعكاسه على سلوكه.
كما تُقدم الآية الكريمة درسًا آخر يتعلّق بضرورة ترشيد الأعراف والآداب الاجتماعية، فإذا كانت الضيافة عرفًا وأدبًا اجتماعيًّا مهمًّا، فإنّ تخليصه من بعض الجوانب السلبية التي علقت به أمرٌ مطلوب، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة، بالتوجيه إلى اختصار وقت الضيافة مراعاة لظروف المضيّف، والآية الكريمة وإن كان مورد نزولها يرتبط بالنبي  ، إلّا أنها توجيه عام يشمل الجميع.
، إلّا أنها توجيه عام يشمل الجميع.