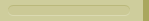مواجهة ثقافة الفقر
يقول تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: 268].
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي تبنّته الأمم المتحدة عام 1992م، وهو اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر، والذي يحتفي به العالم اليوم، نسلّط الضوء على عامل أساس لإنتاج حالة الفقر وتكريسها، وهو العامل الثقافي.
فإنّ البحوث الاجتماعية تؤكد من خلال الدراسة الميدانية لشريحة الفقراء في أكثر من موطن، أنّ هذه الشريحة غالبًا ما تسودها أنماط ثقافية معينة تكرّس حالة الفقر في أوساطها.
وقد ظهر مصطلح (ثقافة الفقر) لأول مرّة في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، في كتابات باحث الأنثروبولوجيا الأمريكي (أوسكار لويس 1914-1970م) الذي اشتهر بتصويره لحياة سكان الأحياء الفقيرة التي يتناقل فيها الفقر عبر الأجيال.
الثقافة وتشكيل الشخصية
لا شك أنّ الثقافة التي ينشأ عليها الإنسان ويتطبّع بها، من خلال تربيته الأسرية وبيئته الاجتماعية، لها دور أساس في تشكيل شخصيته وتوجيه سلوكه.
فهناك ثقافة تعزّز الثقة بالذات وتزرع الأمل وحب الحياة، وتثير الطموح في نفس الإنسان وتدفعه للفاعلية والنشاط، وهذه الثقافة تهيّئ الإنسان للانطلاق والتقدم في ميادين الحياة، ومنها ميدان الاقتصاد، وهناك ثقافة تُشعر الإنسان بالضعف والعجز وعدم الجدارة الشخصية، وتقنعه بعدم أهمية الحياة، ولا جدوى السعي لمكاسبها. ومن الطبيعي أن تُنتج هذه الثقافة حالة التخلف والفقر.
إنّ الثقافة الدينية في منابعها الأصيلة تمنح الإنسان أعلى مستوى من الثقة بالنفس، فهو خليفة الله في أرضه، والمفضّل على سائر مخلوقاته، وقد أودع فيه من القدرات والطاقات ما يمكّنه من تسخير سائر الموجودات في الكون والاستمتاع بخيراته وثرواته.
وما على الإنسان إلّا أن يفتح عينه على آفاق الكون والحياة، وأن يستخدم فكره ويشمّر عن ساعديه، ويسعى لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات والمكاسب من عطاء الله ونعمه.
لكنّ المؤسف تسلل ثقافة سلبية إلى تراث المسلمين، تدعو إلى تقليل الاهتمام بالحياة والزهد في مباهجها ومكاسبها، والاكتفاء بأدنى مستوى من المعيشة فيها.
ثقافة التبشير بالفقر
لقد تشكلت في تراثنا الديني منظومة لثقافة التبشير بالفقر، تتكئ على كثير من الأحاديث والروايات وأقوال العلماء والقصص والنماذج من سير الزهاد والعبّاد، وأُفردت لهذه الثقافة أبواب في كتب الحديث، وفصول واسعة في كتب الأخلاق والآداب.
وفي هذه المنظومة نجد ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: تمجد الفقر ومدحه. فهناك مرويات كثيرة في هذا السياق، منها ما روي عن رسول الله  : «تُحفَةُ المُؤمِنِ فِي الدُّنيَا الفَقرُ»[1] .
: «تُحفَةُ المُؤمِنِ فِي الدُّنيَا الفَقرُ»[1] .
وعنه  : «الفَقرُ خَيرٌ لِلمُؤمِنِ مِنَ الغِنى»[2] .
: «الفَقرُ خَيرٌ لِلمُؤمِنِ مِنَ الغِنى»[2] .
وعن الإمام جعفر الصادق  : «فِي مُنَاجَاةِ مُوسَى
: «فِي مُنَاجَاةِ مُوسَى  يَا مُوسَى، إِذَا رَأَيْتَ اَلْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ مَرْحَبًا بِشِعَارِ اَلصَّالِحِينَ، وَإِذَا رَأَيْتَ اَلْغِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ ذَنْبٌ عَجِلَتْ عُقُوبَتُهُ»[3] .
يَا مُوسَى، إِذَا رَأَيْتَ اَلْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ مَرْحَبًا بِشِعَارِ اَلصَّالِحِينَ، وَإِذَا رَأَيْتَ اَلْغِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ ذَنْبٌ عَجِلَتْ عُقُوبَتُهُ»[3] .
وعنه  : «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النَّبِيِّينَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ
: «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النَّبِيِّينَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ  وَذَلِكَ لِمَا أُعْطِيَ فِي الدُّنْيَا»[4] .
وَذَلِكَ لِمَا أُعْطِيَ فِي الدُّنْيَا»[4] .
الاتجاه الثاني: الاكتفاء بحدّ الكَفاف، وهو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة، وكَفاف بالفتح سمي بذلك لأنه يكفّ عن سؤال الناس ويغني عنهم.
حيث توجه بعض النصوص والروايات إلى أن يكتفي الإنسان في سعيه لكسب المال، بالوصول إلى حدّ الكَفاف، بمعنى توفير ما يحتاجه في معيشته وحياته ولا يسعى للزيادة على ذلك، حتى لا يصاب بآفات الغنى، ولا ينشغل بالكسب عن العبادة، ولا يتحمل مسؤولية الحساب على أمواله وممتلكاته يوم القيامة، فكلّما زادت زاد الحساب.
ورد عن رسول الله  : «طُوبَى لِمَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا»[5] .
: «طُوبَى لِمَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا»[5] .
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله  : «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ اَلدُّنْيَا. يَا بْنَ جُعْشُمٍ، يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ وَإِنْ يَكُنْ بَيْتٌ يَكُنُّكَ فَذَاكَ، وَإِنْ يَكُنْ دَابَّةٌ تَرْكَبُهَا فَبَخٍ بَخٍ وَإِلَّا فَالْخُبْزُ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ حِسَابٌ عَلَيْكَ أَوْ عَذَابٌ»[6] .
: «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ اَلدُّنْيَا. يَا بْنَ جُعْشُمٍ، يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ وَإِنْ يَكُنْ بَيْتٌ يَكُنُّكَ فَذَاكَ، وَإِنْ يَكُنْ دَابَّةٌ تَرْكَبُهَا فَبَخٍ بَخٍ وَإِلَّا فَالْخُبْزُ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ حِسَابٌ عَلَيْكَ أَوْ عَذَابٌ»[6] .
وعن الإمام جعفر الصادق  : «أَنَّ عِيسَى
: «أَنَّ عِيسَى  قَالَ: اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي غُدْوَةً رَغِيفًا مِنْ شَعِيرٍ وَعَشِيَّةً رَغِيفًا مِنْ شَعِيرٍ وَلاَ تَرْزُقْنِي فَوْقَ ذَلِكَ فَأَطْغَى»[7] .
قَالَ: اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي غُدْوَةً رَغِيفًا مِنْ شَعِيرٍ وَعَشِيَّةً رَغِيفًا مِنْ شَعِيرٍ وَلاَ تَرْزُقْنِي فَوْقَ ذَلِكَ فَأَطْغَى»[7] .
قال المجلسي: (ولا يمكن الحكم الكلي من أحد الطرفين (أي الفقر والغنا)، والظاهر أنّ الكفاف أسلم وأقلّ خطرًا من الجانبين ولذا ورد في أكثر الأدعية طلبه وسأله النبي  لآله وعترته)[8] .
لآله وعترته)[8] .
الاتجاه الثالث: هو التوقف في تبني رأي في المسألة، لأنهم رأوها غامضة لاختلاف النصوص والآراء حولها.
ثقالة تخالف القرآن والثابت من السنة
هذه الأحاديث والروايات التي تمجد الفقر، تعارضها آيات قرآنية وأحاديث وروايات تذمّ الفقر وتُحفّز للغنى والثروة، إنّ الآية الكريمة ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: 268]، تشير إلى أنّ الفقر هو ما يعد به الشيطان للإنسان: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾، إنه يخوّف الناس بالفقر إذا اتبعوا الدين وأنفقوا في سبيل الله. بينما يبشّر الله تعالى عباده بالمغفرة والفضل، ﴿والله يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾، والفضل هو الزرق، يقول تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ الله﴾ [سورة الجمعة، الآية: 10] أي من رزق الله ونعمه.
وانحياز الإسلام ضدّ الفقر ومكافحته له، أمرٌ واضح، والنبي  يساوي بين حالتي الكفر والفقر، فكلاهما مرفوض بنفس الدرجة، حيث ورد عنه
يساوي بين حالتي الكفر والفقر، فكلاهما مرفوض بنفس الدرجة، حيث ورد عنه  : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ»[9] ، وفي كنز العمال أنّ رجلًا قال لرسول الله
: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ»[9] ، وفي كنز العمال أنّ رجلًا قال لرسول الله  : أيعدلان؟ قال
: أيعدلان؟ قال  : «نعم»[10] .
: «نعم»[10] .
لذا لا يمكن قبول ما يظهر من هذه الروايات من تمجيد للفقر، بل لا بُدّ من معالجة شأن هذه النصوص. وهي في المجمل ضعيفة السند، وبعضها موضوع، ويحتمل أنّ للسلطات المنحرفة والإقطاعيين في العهود السابقة، دورًا في وضع ونشر هذه الروايات، ليرضى الناس بفقرهم ويسكتوا عليه، ولا يطالبوا بتحسين أوضاعهم.
وبعض هذه الروايات جاءت لمعالجة الآثار النفسية للفقر الاضطراري، الذي يفرض نفسه على الإنسان، ولا يختاره الإنسان، كما لو كان مريضًا أو عاجزًا عن الكسب، أو تعذّرت عليه فرص العمل، حتى لا يكون الفقر دافعًا للانحراف الفكري والمرض النفسي والسلوك الإجرامي.
وبعض هذه الروايات يأتي في سياق التحذير من آفات الغنى وسلبياته، وما قد يحدثه في نفس الإنسان من تكبر وغرور وطغيان وبخل.
التحفيز للثراء
يخلو القرآن الكريم من أيّ آية تمجد الفقر أو تمدحه، بل تتحدث كثير من آياته عن مساعدة الفقراء لتجاوز حالة الفقر.
وفي المقابل يمكن استنتاج إشارات عديدة من آيات في القرآن الكريم، بالنظرة الإيجابية للغنى والثروة، فإنّ الله سبحانه يمنّ على النبي محمد  بأنه أغناه حين أصبح معيلًا.
بأنه أغناه حين أصبح معيلًا.
قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ [سورة الضحى، الآية: 8].
ويعد الله المؤمنين الفقراء بأنه سينقلهم من حالة الفقر إلى الغنى، وأنّ ذلك من فضله، يقول تعالى: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة النور، الآية: 32].
ويصف القرآن الكريم ما يتركه الإنسان من مال بعد موته بأنه خير، يقول تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة، الآية: 180].
ونسب إلى الإمام علي  أنه فسّره بالمال الكثير. وذلك هو الراجح؛ لأنّ المال اليسير لا يحتاج إلى وصية.
أنه فسّره بالمال الكثير. وذلك هو الراجح؛ لأنّ المال اليسير لا يحتاج إلى وصية.
وفي سورة العاديات يقول تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [سورة العاديات، الآية: 8]، وكلّ المفسّرين يقولون إنّ الخير هنا هو المال.
وفي معظم الموارد حين يتحدث القرآن عن صفات المؤمنين، يكون في طليعتها أداؤهم للزكاة، وإنفاقهم للمال في سبيل الله، وبالتأكيد فإنّ من يعيش حالة الفقر أو الكفاف، لا يمتلك نصاب الزكاة، ولا يكون قادرًا على الإنفاق.
فغالبًا ما تكون إقامة الصلاة في الآيات القرآنية مردوفة بإتيان الزكاة، ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [سورة النمل، الآية: 3]، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [سورة البقرة، الآية: 277].
كما يقرن الله تعالى الجهاد بالنفس بالجهاد بالمال، كقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة التوبة، الآية 41].
وقوله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ [سورة النساء، الآية: 95].
مما يؤكد أهمية المال ودوره في نظر الدين، وفي كسب القوة والقدرة للأمة أمام الأعداء.
وعلى ضوء هذه الآيات يمكن القول إنّ مجتمع المؤمنين يفترض أنه مجتمع ثري.
وأنّ فيه أغنياء ذوي أموال وثروات يعتمد عليهم في إرساء كيان المجتمع.
الدعاء والتطلّع إلى الثروة
الدعاء بشي وطلبه من الله، يُعزّز التطلّع إلى تحقيقه والرغبة في حصوله، وحينما تربّينا الأدعية المأثورة على طلب السعة في الرزق والغنى، فذلك يعني أنه أمر مرغوب ومحبّذ.
والقرآن الكريم يأمر الإنسان أن يسأل الله من فضله المزيد من المكاسب، يقول تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [سورة النساء، الآية: 32].
وفي دعاء الإمام زين العابدين  : «اللّهُمَّ أَعْطِنِي السَّعَةَ فِي الرِّزْقِ وَالأَمْنَ فِي الوَطَنِ»[11] .
: «اللّهُمَّ أَعْطِنِي السَّعَةَ فِي الرِّزْقِ وَالأَمْنَ فِي الوَطَنِ»[11] .
وفي دعاء الإمام الباقر  إذا انصرف من الوتر يقول: «يَا غَنِيُّ يَا كَرِيمُ، اُرْزُقْنِي مِنَ اَلتِّجَارَةِ أَعْظَمَهَا فَضْلًا وَأَوْسَعَهَا رِزْقًا وَخَيْرَهَا لِي عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيمَا لاَ عَاقِبَةَ لَهُ»[12] .
إذا انصرف من الوتر يقول: «يَا غَنِيُّ يَا كَرِيمُ، اُرْزُقْنِي مِنَ اَلتِّجَارَةِ أَعْظَمَهَا فَضْلًا وَأَوْسَعَهَا رِزْقًا وَخَيْرَهَا لِي عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيمَا لاَ عَاقِبَةَ لَهُ»[12] .
وفي دعاء الإمام الكاظم  : «وَاُنْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ الْفَقْرِ إِلَى عِزِّ الْغِنَى»[13] .
: «وَاُنْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ الْفَقْرِ إِلَى عِزِّ الْغِنَى»[13] .
الثقافة المجتمعية السلبية
وقد تسود بين أبناء المجتمع ثقافة تدعو إلى الراحة والكسل، واختيار أسهل الأعمال وأخفّ البرامج، ونتائج هذه الثقافة ضعف المستوى المادي، والتقدم الاقتصادي.
نجد هذا مثلًا في اختيارات الطلاب لاتجاه دراستهم، حيث يختار البعض القسم الأسهل، واختيار الجامعة الأسهل، وكذلك في اختيار فرص العمل، فيبحث الأكثرية عن الوظيفة المريحة، ولا يفكر في مشروع عمل استثماري، لأنه يستلزم جهدًا أكبر، ويحتاج الى روح إقدام ومغامرة.
وقد يثبّط المجتمع عزيمة من يمتلك روح ريادة وإقدام، وقد أخبرني أحد رجال الأعمال الناجحين حينما بدأ عمله في الاستثمار العقاري، كيف أنه واجه معارضة وتثبيطًا من أقربائه وأصدقائه، حتى إنهم ضغطوا على أبيه ليثني عزمه عن مشروعه، بحجة أنه قد يعرّض نفسه للخسارة، وأنّ عليه أن يمدّ رجله بمقدار لحافه!!
وضمن هذا السياق يأتي انتشار أخبار الفشل، وحالات التعثر في الأعمال والمشاريع الاستثمارية، دون أخبار النجاحات والإنجازات.
ومن ألوان هذه الثقافة ضعف روح التعاون والمشاركة في الأعمال الاستثمارية والاقتصادية، إنّ قيام التكتلات والشراكات هو طريق النجاح والتقدم الاقتصادي في المجتمع.
ويتحدث الناس في مجتمعنا المحلي، كيف أنّ بعض الجاليات من الوافدين يتعاونون ويتكتلون فيما بينهم، للنجاح والسيطرة في بعض قطاعات الأعمال، وحسنًا ما يصنعون لأنفسهم، أليس المواطنون أولى بانتهاج هذا السبيل؟
يحتاج أبناؤنا وشبابنا إلى الاطلاع على النماذج الناجحة في عملها ومشاريعها، خاصة على المستوى الوطني والمحلي، لتحفّزهم إلى التطلع والطموح والتّحلي بروح المبادرة والريادة، وليستفيدوا من التجارب الناجحة في نقاط قوتها ونجاحها.
وحتى التجارب الفاشلة، لا بُدّ من البحث عن أسباب الفشل فيها لتلافيها، ففي كلّ مجالات الحياة هناك إخفاقات وإنجازات، وفشل ونجاحات، ولا يحدث ذلك اعتباطًا، فللنجاح عوامله وللفشل أسبابه.
إنّ تقدّم التنمية وبناء القوة الاقتصادية للوطن، لا تتحقّق إلّا إذا كانت هدفًا محوريًا في سياسة الدولة، واهتمامات المواطنين.
نسأله تعالى أن يوفقنا ويوفق أبنائنا للجدّ والعمل والفاعلية والنشاط، وأن يوسّع أرزاقنا جميعًا ويزيدنا من فضله إنه ذو الفضل العظيم.