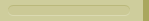ندوة الإنسان والآخر نقد جذور التطرف

المحاور: الشيخ بدر العبري[1]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرّ النادي الثقافي في هذه الليلة السعيدة، أن يستضيف سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار، فحياه الله في بلده الثاني عمان.
سماحة الشيخ ليس مجرد شخصية وحدوية، بل هو مدرسة وحدوية بحد ذاته، يستحق أن تُدرس تجربته الممتدة لأكثر من ستة عقود، باعتباره علماً من الأعلام الكبار، ومن المرجعيات الدينية الوحدوية في المملكة العربية السعودية، وفي الوطن العربي والعالم الإسلامي.
إلى جانب ذلك، هو شاعر وأديب وناقد ومصلح اجتماعي. ولد عام 1958 في مدينة القطيف، وتلقى علومه في النجف الأشرف وقم والكويت وطهران، إضافة إلى نشأته التعليمية الأولى في القطيف.
ارتبطت مسيرة الشيخ الصفار بعُمان منذ عام 1974 وحتى 1978 في مسجد الرسول الأعظم بمطرح، وكان على صلة بعلماء عُمان، مثل سماحة المفتي السابق الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري، وسماحة المفتي الحالي الشيخ أحمد الخليلي، والشيخ الأديب سالم بن حمود السيابي، وابنه الشاعر هلال السيابي. هذه العلاقات لم تنقطع حتى يومنا هذا.
من أبرز جهوده في تلك الفترة نشاطه النهضوي في مسجد الرسول الأعظم، إضافة إلى تأسيسه لمجلة الوعي عام 1977. وللشيخ العديد من الكتب والمقالات والحوارات، منها كتابه المهم ظلال من الذاكرة الذي يُعد تحفة أدبية في سيرته وتجربته.
موضوعنا هذا المساء سيكون عن الإنسان والآخر: نقد جذور التطرّف.
وسنبدأ من قضية التعددية، لما لها من صلة وثيقة بالإنسان.
سماحة الشيخ، هل التعددية حالة طبيعية في حياة البشر؟ أم أنها تتناقض مع الفكر الديني الذي جاء لتأصيل الأحادية، لا لإقرار التعددية، مما يجعل البعض يخشى من أي تعددية قد تتعارض مع الدين أو المذهب؟
الشيخ الصفار:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.
السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته.
في البداية، أعرب عن سعادتي وسروري، وأنا أزور هذا البلد العريق الأصيل، وأعتبره وطني الثاني. لقد عشت بين ظهراني أهله الكرام الطيبين، ولمست فيهم كل صفات الخير والنبل والصلاح. أسأل الله تعالى أن يمنّ على هذا البلد الكريم وأهله بكل خير وتقدّم.
كما يسعدني أن أقضي هذا الوقت في مؤسسة ثقافية رائدة، عرفت من خلال إصداراتها وفعالياتها، أنها منبر ينشر ثقافة التسامح، ويبشّر بفكر الانفتاح والنهوض.
أشكر أخي الكريم الشيخ بدر على كلماته الطيبة، وما ذكره عني هو من حسن ظنه ومبالغته، فهذه عادة الكرام أن يفيضوا على الآخرين من طيبهم وكرمهم.
حول سؤال التعددية:
القضية التي طرحها الشيخ بدر حول التعددية، أؤكد أنها ليست مجرد ظاهرة بشرية طبيعية، بل هي ظاهرة كونية. القرآن الكريم يحدثنا عن التعددية في كل جوانب الحياة: في اختلاف الثمرات، ألوان الجبال، ألسنة البشر وألوانهم.
يقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾[سورة الحجرات، الآية: 13]
جمال الكون قائم على هذا التنوع والتعدد، كما أن الحديقة تزداد بهاءً بتعدد أزهارها وألوانها. وبالنسبة للبشر، فإن منح الله لهم نعمة العقل، يجعل من الطبيعي أن يختلفوا في أفكارهم وآرائهم. فإذا أردنا منع التعددية بين الناس، فعلينا أن نسلبهم عقولهم، وهذا خلاف الطبيعة وسنة الله.
القرآن الكريم ـ مع كونه يقرّ بالدين الإلهي الأخير ـ إلا أنه يعترف بوجود الأديان الأخرى، ويتحدث عنها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾[سورة البقرة، الآية: 62] وهذا اعتراف بواقع التعددية الدينية. إنكار التعددية هو مصادمة للطبيعة والسنن الإلهية، ومن يزعم غير ذلك فعليه أن يثبت دعواه بالعقل والمنطق، وهو أمر متعذر، فلا يبقى أمامه سوى القوة والقهر.
المحاور: لكن سماحتكم، هناك دائمًا إسقاط لثنائية الإيمان والكفر، حتى على مستوى الدولة القُطرية: هذه دولة إسلامية وتلك دولة كافرة. كما أن هناك نصوصًا فقهية تتعامل مع "الكافر" كمصطلح يحمل أحكامًا خاصة، مثل النجاسة أو كونه في درجة ثانية. كيف نتعامل مع هذه المصاديق والنصوص، إذا أقررنا بالتعددية من حيث الأصل الإنساني؟
الشيخ الصفار:
القرآن الكريم يقرّ بوجود هذا التصنيف: مؤمنون، كافرون، منافقون. لكنه إقرار بالواقع، لا رفض له. وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿َمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[سورة الكهف، الآية: 29] وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾[سورة الكافرون، الآية: 6] هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى سمح بوجود الكفر إلى جانب الإيمان، وإلا لما أمكن وجوده.
أما الحكم الأخروي فهو شأن آخر يرتبط بعلم الله وحكمته، ولا يلغي حقيقة الإقرار بوجود التعددية في الدنيا.
حول مسألة نجاسة الكافر:
هذه قضية فقهية خلافية بين العلماء: هل النجاسة معنوية أم مادية؟ وهي مسألة تشريعية جزئية، لا ينبغي أن تُستغل للإساءة لحقوق الإنسان، أو الانتقاص من كرامته.
فالقرآن صريح في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾[سورة الإسراء، الآية: 70] هذا التكريم الإلهي يشمل كل بني البشر، وهو الرأي السائد بين المفسرين والعلماء، على خلاف من حاول قصره على المؤمنين فقط. وعليه، فإن كرامة الإنسان محفوظة من حيث كونه إنسانًا، بغض النظر عن انتمائه الديني.
المحاور: سماحة الشيخ، في السابق كانت الدولة وأنظمتها تتسم بشيء من السَّعة، أما اليوم فقد تطورت إلى مفهوم الدولة الوطنية. وهذه الدولة قد تضم تعددية واضحة: دينية أو مذهبية. وحين يسود دين أو مذهب على آخر، يثار السؤال: هل تُربط الدولة الوطنية بالدين أو المذهب السائد؟ أم أنها تُبنى على أساس المواطنة بغضّ النظر عن الانتماء الديني والمذهبي؟ وبصياغة أخرى: هل يمكن اليوم أن نصف هذه الدولة بأنها إسلامية، أم هي دولة وطنية فحسب؟
الشيخ الصفار:
عند التأمل نجد أن هذه التوصيفات (الدولة الإسلامية/الدولة الدينية) لم تكن مطروحة في العصور الإسلامية الأولى. لم يكن يُقال: هذه دولة إسلامية أو دينية. كانت ببساطة دولة المجتمع الذي يعيش في ظلها. وبما أن الغالبية كانوا مسلمين، فهي تطبق الإسلام في حياتهم العامة، لكن العنوان لم يكن مستعملًا بهذا الشكل.
حتى في تلك الدولة التي كانت تحكم بالشريعة، نجد أنها اعترفت بحقوق المواطنة لغير المسلمين.
فالصحيفة التي أقرها رسول الله  عند قدومه إلى المدينة، تضمّنت اعترافًا صريحًا بحقوق اليهود، وأن لهم دينهم وحقوقهم، وأنهم جزء من أهل الصحيفة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذا أوضح دليل على مبدأ المواطنة والتعايش.
عند قدومه إلى المدينة، تضمّنت اعترافًا صريحًا بحقوق اليهود، وأن لهم دينهم وحقوقهم، وأنهم جزء من أهل الصحيفة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذا أوضح دليل على مبدأ المواطنة والتعايش.
وفي عهود الخلفاء الراشدين استمر هذا النهج. بل ورد عن رسول الله  قوله: «مَنْ آذى ذِمِّيّاً فَأَنَا خَصْمَهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[2] . وهذا أبلغ تعبير عن حماية حقوق غير المسلمين.
قوله: «مَنْ آذى ذِمِّيّاً فَأَنَا خَصْمَهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[2] . وهذا أبلغ تعبير عن حماية حقوق غير المسلمين.
أما أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، فقد تحاكم بنفسه مع يهودي أمام القاضي في قضية الدرع المشهورة، رغم أنه الخليفة وأمير المؤمنين. كما أنه (عليه السلام) لما رأى رجلاً غير مسلم يستجدي في الطرقات، غضب وقال لمسؤول بيت المال: «اِسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَعَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ، أَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ»[3] .
إذا كانت الدولة ذات الطابع الديني قد احترمت حقوق المواطنة لغير المسلمين، فمن باب أولى أن تقوم الدولة الوطنية الحديثة ـ التي بُنيت على أساس الجغرافيا لا الدين ـ بحماية هذه الحقوق. فالدولة الوطنية الحديثة تقوم على ثلاثة أركان معروفة: الشعب، الأرض، والنظام. وهذا يستلزم صون حقوق المواطنين جميعًا.
المحاور: جميل، ولعل من الجدليات المهمة التي تحتاج إلى مراجعة مسألة الولاء والبراء. ففي السابق كان الولاء يُربط بالدين أو المذهب، بينما اليوم أصبح الولاء للدولة الوطنية أو للأرض. لكن مع وجود التعددية، إذا ظل الولاء للمذهب مثلًا، ألا يؤدي ذلك إلى انتقال الولاء من الوطن إلى ولاءات خارجية مرتبطة بالانتماء الديني أو المذهبي؟
الشيخ الصفار:
الإنسان شخصية متعددة الأبعاد، وانتماءاته تتوزع على دوائر مختلفة: فهو ينتمي إلى أسرة، إلى قبيلة، وإلى قوم، وإلى وطن، وإلى دين، وإلى فكر. هذه الدوائر يمكن أن نصورها متداخلة، لكنها لا تتصادم بطبيعتها.
حبّ الإنسان لقبيلته أو لعائلته لا يتعارض مع حبه لدينه أو لوطنه أو قوميته. ولذلك روي أن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) سُئِلَ عَنِ اَلْعَصَبِيَّةِ، فَقَالَ: «اَلْعَصَبِيَّةُ اَلَّتِي يَأْثَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا، أَنْ يَرَى اَلرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَيْراً مِنْ خِيَارِ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلَيْسَ مِنَ اَلْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبُّ اَلرَّجُلُ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ مِنَ اَلْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ قَوْمَهُ عَلَى اَلظُّلْمِ»[4] .
لا يوجد تعارض حقيقي بين هذه الانتماءات، والتصادم بينها تصادم مفتعل. كما أن الإنسان قد يُظهر ولاءً للمؤسسة التي يعمل فيها، كما في اليابان حيث يُعرف المواطن بولائه للشركة التي يعمل لديها. هذا نوع من الولاء لا يتنافى مع بقية دوائر الانتماء.
المشكلة تظهر فقط إذا طغى أحد هذه الانتماءات على بقية الدوائر، بحيث يصبح على حسابها. وهذا أشبه بالغذاء: إذا اختلّ التوازن وزاد عنصر على آخر سبّب ضرراً، أما إذا وُجد التوازن فالنتيجة صحية وسليمة.
أما عن مصطلح "الولاء والبراء"، فهو من المصطلحات المستنبطة، وليست هناك أحكام شرعية تدور مدار هذا المصطلح بشكل مباشر، وإنما جرى استنتاجه في بعض الكتابات والتوجهات.
المحاور: إذا كنّا قد أقررنا بالتعددية واعتبرناها مقبولة عقلاً وشرعًا، ويلزم الإقرار بها في الدولة الوطنية، فهل يمكن ـ كإسلاميين، إن صحّ التعبير ـ أن نتقبّل التعايش مع العلمانيين، أو مع الإنسانويين (Humanists) الذين لهم توجهات خارج الإطار الديني، أو حتى مع من يختلف معنا في النظر إلى المسائل الإلهية؟
الشيخ الصفار:
التعايش أمر مطلوب وضروري، ورسول الله  مارس حالة التعايش مع اليهود والنصارى.
مارس حالة التعايش مع اليهود والنصارى.
من الطبيعي أن يرى الإنسان آخرين يختلفون معه في الدين أو المذهب أو الرأي، وأن يدخل معهم في حوار ونقاش. وهذا يدخل في إطار قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾[سورة الحجرات، الآية: 13]، فالتعارف لا يلغي الاحترام، بل يقوم على أساسه.
القرآن الكريم يقدّم مثالًا واضحًا في حادثة المباهلة مع نصارى نجران: جاءوا إلى النبي  ، فطرح عليهم الرؤية الإسلامية في شأن السيد المسيح، ودار نقاش بينهم. ثم أمر الله تعالى نبيه بقوله: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾[ سورة آل عمران، الآية: 61]
، فطرح عليهم الرؤية الإسلامية في شأن السيد المسيح، ودار نقاش بينهم. ثم أمر الله تعالى نبيه بقوله: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾[ سورة آل عمران، الآية: 61]
هذا الموقف يوضح أن الخلافات الدينية لا تُحسم في الدنيا، وإنما تُترك مرجعيتها إلى الله يوم القيامة: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[سورة الأنعام، الآية: 108]
التعايش ليس خيارًا ثانويًا، بل هو ضرورة للحياة. ولو ربطنا التعايش بالموافقة في الدين، فسنُضطر لاحقًا إلى ربطه بالموافقة في المذهب. وإذا قُلنا لا نتعايش إلا مع من يوافقنا في المذهب، سنصل إلى عدم التعايش إلا مع من يوافقنا في المدرسة الفقهية، بل وحتى المرجعية الدينية التي نتبعها. وهذا يؤدي إلى صراعات لا تنتهي، وهو خلاف طبيعة الحياة ومصلحة الإنسان التي أرادها الله تعالى.
المحاور: العَلمانيّة في الدولة حلّت هذه القضيّة نوعًا ما، وأعطت مساحة واسعة، بمعنى أن الوطن للإنسان مع احترام الاتجاهات الأخرى أيًّا كانت. فهل يمكن اليوم ـ ونحن في إطار الدولة الوطنيّة ـ أن نحقّق الجانب العَلماني في صورته الدينيّة المعاصرة؟ وإذا كان عبد الوهاب المسيري قد صاغه في صورته الجزئيّة، فهل يمكن أن نصل اليوم إلى ما يمكن وصفه بالعَلمانيّة الدينيّة؟
الشيخ الصفار:
بعيدًا عن المصطلحات، في مجتمعنا الإسلامي السابق كان الناس يعيشون هذه الحالة. نحن نتحدث عن مجتمعات كانت تعيش حالة من الانفتاح، وكانت تدور ضمنها مختلف الآراء والنظريات.
مثلًا، في تاريخنا: الإمام المعروف للمذهب الشيعي، الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، في سيرته وحياته، كان يتحاور مع الزنادقة الذين ينكرون وجود الله، وكانوا يحضرون مجلسه. لم يطردهم ولم يرفضهم، بل كان يتحاور معهم. ومنهم ابن أبي العوجاء الذي قال في رده على المفضل بن عمر: (إن كُنتَ مِن أصحابِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ فَما هكَذا يُخاطِبُنا، ولا بِمِثلِ دَليلِكَ يُجادِلُنا! ولَقَد سَمِعَ مِن كَلامِنا أكثَرَ مِمّا سَمِعتَ، فَما أفحَشَ في خِطابِنا، ولا تَعَدّى في جَوابِنا. وإنَّهُ لَلحَليمُ الرَّزينُ العاقِلُ الرَّصينُ؛ لا يَعتَريهِ خُرقٌ ولا طَيشٌ ولا نُزقٌ. ويَسمَعُ كَلامَنا، ويُصغي إلَينا، ويَستَعرِفُ حُجَّتَنا، حَتَّى استَفرَغنا ما عِندَنا وظَنَنّا أنّا قَد قَطَعناهُ أدحَضَ حُجَّتَنا بِكَلامٍ يَسيرٍ وخِطابٍ قَصيرٍ، يُلزِمُنا بِهِ الحُجَّةَ، ويَقطَعُ العُذرَ، ولا نَستَطيعُ لِجَوابِهِ رَدّا)[5] .
وكان هذا هو الحال القائم في المجتمع. لدينا عالمان كبيران، الشريف الرضي (ت: 406هـ) والشريف المرتضى (ت: 436)، لكل منهما قصيدة في رثاء أحد الصابئة ـ وهو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي، يقول الشريف الرضي:
أعَلِمتَ مَن حَمَلوا عَلى الأَعوادِ… أَرَأَيتَ كَيفَ خَبا ضِياءُ النادي؟
قصيدة من عالِم فقيه مسلم شيعي يرثي بها أديبًا من الصابئة، وكانوا أصدقاء يجالسونه ويجالسهم.
لكن في الزمن المتأخر صارت عندنا حالة من التشنج والتشدّد. وبغضّ النظر عن التسميات: إنسانويّة أو عَلمانيّة، هؤلاء بشر، عندهم آراء وأفكار. الأفكار الإيجابية نستفيدها منهم، والأفكار التي نختلف فيها معهم نناقشهم فيها.
هذه الحالة من التشدّد والتشنّج لا نجدها في سيرة الأئمة والأولياء، إنما طرأت لاحقًا على مجتمعنا الإسلامي، وإن حاول البعض أن يثبت لها جذورًا في التراث. لكن في المقابل نجد في تاريخنا أيضًا ما يناقضها: فهناك فلاسفة قُتلوا لاعتبارات دينيّة، وهناك فتاوى ضيّقت، مثل حكم قتل المرتد، وتطليق زوجته، وحرمانه من الميراث، وهي حالة غير إنسانيّة.
إذن في تراثنا خطّان: خطّ التسامح والانفتاح، وخطّ التشدد والانغلاق. وعلينا اليوم، ونحن نعيش ظروفًا معاصرة ومع تطوّر الفكر، أن ننتقي من تراثنا ما هو أقرب إلى روح الدين.
لقد حصلت في تاريخ الإسلام ممارسات مخالفة للدين، وكيف نعرف أنها مخالفة أو غير مخالفة؟ عندما نقرأها على ضوء القيم الدينيّة الأساسيّة التي يحملها القرآن الكريم. فنحن غير معنيين بالحالات الشاذة والمنحرفة في تراثنا وتاريخنا. حتى وإن احترمناها كوجهات نظر، لا نجد أنفسنا ملزمين بها. علينا أن ننفتح على روح الدين وقيم القرآن، لا على الممارسات التاريخيّة التي كثير منها خالف تلك القيم.
المحاور: داخل المدارس الإسلاميّة نفسها، بعيدًا عن الجانب الإنساني، نجد دعوة "التقريب" التي هي إقرار بالمذاهب الثمانية أو التسعة الموجودة داخل البيت الإسلامي. بعضهم يرى أنّ دعوة التقريب، بعد ستين سنة تقريبًا من إبرازها، قد فشلت أمام دعوات التكفير والإقصاء، ولا زال هذا باقيًا. على سبيل المثال: ما حدث في حرب غزّة الأخيرة كشف عن انقسام طائفي شديد لا يزال حاضرًا في العالم الإسلامي.
الشيخ الصفار:
المساوئ الأخلاقيّة والسلوكيّة لا تنتهي ولا تُستأصل من المجتمعات الإنسانيّة. أنا دائمًا أقول في بعض اللقاءات والجلسات: ينبغي أن ننظر إلى "الصحة السلوكيّة" كما ننظر إلى "الصحة الجسميّة".
اليوم هناك تطوّر هائل في علم الطب: أطباء، جامعات، مراكز أبحاث، مختبرات، نظريات علميّة… ومع ذلك الأمراض الجسميّة لم تُستأصل. قد نقول: لدينا كذا مستشفى وكذا طبيب، لكن الناس ما زالوا يمرضون، وسيبقون يمرضون، لأن الأجسام بطبيعتها معرّضة للأمراض.
كذلك الحال في الصحة السلوكيّة والفكريّة: إذا رأينا مشاكل سلوكيّة أو فكرية، فهذا لا يعني التشكيك في جدوى العمل المعرفي والفكري. العمل الفكري يقوم بدوره، لكن هناك دائمًا عوامل أخرى تسبّب المساوئ السلوكيّة والفكريّة.
لا ينبغي أن نقلّل من قيمة فكرة التقريب بين المسلمين، لمجرّد ظهور زوابع من التمزق والتفرّق. هذا يشبه أن نشكك في قيمة المستشفيات حين ظهر مرض مثل "كورونا" الذي أصاب أغلب الناس.
عندما تتضارب المصالح السياسيّة، أو تتدخّل القوى الطامعة بمجتمعاتنا، تظهر مثل هذه الزوابع. وفي تراثنا أيضًا نجد ما يغذّي هذه النزعات: من أنانيات مقيتة أو تنافس غير شريف.
لكن برأيي: كل من يقرأ تجربة "التقريب بين المذاهب الإسلاميّة" التي انطلقت في القاهرة، يُكبِر هذه التجربة. لسنوات طويلة كان العلماء من مختلف المذاهب يصدرون مجلّة بعنوان "رسالة الإسلام"، وقد استمرّت عدّة سنوات، وجُمعت مؤخرًا في مجلدات. كان الحوار بينهم راقيًا وجميلاً ومؤثّرًا، عرّف الناس على بعضهم البعض.
قد تأتي موجات ـ مثل "كورونا"، أو مشاكل سياسيّة واجتماعيّة ـ فتُربك المشهد. لكن هذا أمر طبيعي لا يُلغي قيمة التجربة في ذاتها.
المحاور: لعلّي أطرح آخر سؤال في هذا المحور، وهو ما يتعلّق بـ "أنسنة" النص الديني. لا أقصد أنسنة النص نفسه حتى لا ندخل في جداليّة، وإنما أقصد أنسنة تنزيلات وتأويلات النص الديني. فمن المعلوم أنّ النص الديني نزل في ظرفيّة معيّنة في القرن السابع الميلادي كشريعة. أمّا نحن فنعيش اليوم في القرن الحادي والعشرين. فهل يمكن أن نُؤنسِن ما يتعلّق بالنص وفق إنسان القرن الحادي والعشرين، لا وفق إنسان القرن السابع أو العاشر الميلادي؟
الشيخ الصفار:
هذا أمر لا بدّ منه. وأساسًا إنما فُتح باب الاجتهاد في الدين لمراعاة هذا التطوّر الذي يحصل في حياة البشر.
نزول الرسالات السماويّة المختلفة في تشريعاتها كان أيضًا بالنظر إلى هذا الأمر. فنحن نعتقد أنّ رسالة الأنبياء رسالة واحدة وجوهرها واحد، ولكن كلّما تطوّر الزمن كان الله تعالى يبعث رسالة جديدة تتناسب مع تطوّر العصر والزمن، حتى جاء الإسلام كرسالة خاتمة. لكن في داخله آليّة يُفترض أن تستوعب تطوّر البشر، وهي آليّة الاجتهاد.
فتح باب الاجتهاد إنما هو من أجل مراعاة التطوّر الذي يحصل في حياة البشر. مشكلتنا أنّ الفقهاء والمجتهدين لم يمارسوا صلاحيتهم كما هو المطلوب. مع أنّ عندهم هذه الصلاحيّة، لكن لأسباب مختلفة لم يمارسوها كما ينبغي، بل اعتبروا أنفسهم امتدادًا تحت سقف العلماء السابقين، وبقوا رهائن للآراء التي كانت في القرون والعصور الماضية. وهنا تكمن مشكلتنا.
المحاور: جميل، سماحتك. نطلب الآن أن نفتح المجال للأخوة، ولكن باختصار سأقرأ عليك بعض النصوص من كتبك وأرجو أن تعقب عليها. قلتَ في كتاب العقلانية والتسامح: "إن بعض الأفكار والآراء المنسوبة إلى الدين تدفع إلى التطرف بشكل واضح ومباشر، وبعضها تؤسس لحالة التطرف في نفس المؤمن بها، وتهيّئه لممارسة السلوك المتطرف". كيف يكون ذلك؟
الشيخ الصفار:
هناك بعض الأفكار مثل فكرة "تكفير منكر الضروري". وشرحها قد يحتاج إلى وقت، لكن في القضايا العقدية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام:
أصول الدين: وهي التوحيد والنبوة والمعاد، وهي معيار الدخول في الإسلام.
أصول المذهب: ولكل مذهب أصول يختص بها.
ضروريات الدين: وهي مفاهيم يرونها بديهية وواضحة عند جميع المسلمين، فمن ناقشها أو شكّك فيها أو أنكرها عُدّ كافرًا.
مع العلم أنه ليس عندنا نص ديني بعنوان "ضروريات الدين"، وإنما هو اصطلاح أُنشئ لاحقًا.
المحاور: هل يمكن أن تضرب لنا أمثلة؟
الشيخ الصفار:
نعم. مثلًا: عصمة النبي  في التبليغ؛ خاتمية الرسالة؛ الفرائض الأساسية كالصلوات الخمس والحج.
في التبليغ؛ خاتمية الرسالة؛ الفرائض الأساسية كالصلوات الخمس والحج.
هذه اعتُبرت من "ضروريات الدين". فمن أنكرها عُدّ كافرًا خارجًا من الدين. لكن المشكلة أنهم توسّعوا في ذلك، فأدخل كل مذهب كثيرًا من الأمور الخاصة به واعتبرها "ضرورية".
والمشكلة أن هذه "الضروريات" تتغير من زمن إلى زمن، فما يكون معروفًا في عصر قد لا يكون كذلك في عصر آخر. هذا أدّى إلى مشاكل كثيرة، أبرزها تكفير "منكر الضروري"، وخاصة مع اختلاف المذاهب.
ومن الأفكار أيضًا: فكرة احتكار الجنّة، أي أن الجنّة لا يدخلها إلا المسلم، ثم لا يدخلها إلا جماعة مذهبي، ثم لا يدخلها إلا أتباع مدرستي. وهكذا يضيق نطاق النجاة حتى قال أحد القساوسة المسيحيين في القرن السابع عشر: إن من يدخلون الجنّة نسبتهم واحد من كل مائة ألف فقط، والباقون مصيرهم إلى نار جهنم. وهذا منطق يتجاهل أن الجنة والنار بيد الله، وليست بيد الناس.
كذلك من الأفكار: الإساءة إلى رموز المذاهب المختلفة، واعتبار ذلك واجبًا دينيًا. هذه كلها أسّست لحالة من التطرف داخل المجتمع الإسلامي.
المحاور: ذكرتَ أيضًا في موضع آخر: "إن رفض الاعتراف بمشروعية الرأي الآخر، والسعي لفرض رأي واحد على الناس، هو الأرضية الخصبة للتطرف ونمو توجهات القمع والعنف. وهو ما أوصل الساحة الإسلامية إلى تفريخ حركات العنف والإرهاب"، كيف توضّح ذلك؟
الشيخ الصفار:
حينما يعتقد الإنسان أن رأيه هو المعبّر عن رأي الله، ويعتبر نفسه ناطقًا باسم الرب، يرى أن الآراء الأخرى خارجة عن الدين. مع أن هذه مسائل ظنيّة واجتهاديّة: هو يجتهد في فهم آية، وغيره يجتهد فيها أيضًا.
المشكلة حينما يصل الإنسان إلى مستوى الوصاية على الدين والمجتمع، فيعتبر أن كل من خالفه ضال أو مبتدع أو كافر. هذه العقلية هي التي فرّخت التطرف والإرهاب.
في البداية ظهر هذا في تكفير أتباع المذاهب الأخرى. ونحن في المملكة عشنا هذه التجربة: بعض السلفيين المتشددين اعتبروا أن من يتبع مذهبًا غير مذهبهم فهو مبتدع، بل أحيانًا مشرك أو كافر. تربّى جيل على هذا، ثم مع مرور الوقت صاروا يكفّرون المخالف لهم داخل المدرسة السلفية نفسها.
بل ألّفوا كتبًا في تكفير الدولة مثل: "الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية"، فصاروا يكفّرون الدولة كلها وكبار العلماء والمفتي نفسه. لأنهم اعتادوا على تكفير أتباع المذاهب الأخرى، ثم تعمّقت هذه العقلية فيهم، فوسّعوا دائرتها لتشمل أقرب الناس إليهم.
واليوم نشهد هذا بأعيننا: جماعات تكفيريّة تحارب بعضها بعضًا، وتُصفّي بعضها بعضًا، كما حدث في سوريا والعراق ومناطق مختلفة.
المحاور: طيب، العبّاد له كتاب بعنوان: "رفقًا بأهل السنة"، في نفس الاتجاه. ولك أيضًا رؤية خاصّة على بعض المتدينين، حيث قلتَ: "حينما تناقش بعض المتدينين حول آرائهم وأفكارهم وممارساتهم على ضوء العقل والمنطق، يغلقون باب النقاش والحوار على أساس أن قضايا الدين تعبّدية، وأن دين الله لا يُصاب بالعقول. ولهذا تدور في أوساط بعض المتدينين أفكار تخالف العقل والمنطق، وهي أشبه بالأساطير والخرافات". كيف تفسّر ذلك؟
الشيخ الصفار:
نعتقد أن دين الله إنما يُدرَك بالعقول، ولا يُدرَك بغير العقل. فالإنسان عن طريق عقله وفطرته يهتدي إلى الإيمان بوجود الله.
أما النص الذي يستشهدون به: ((إن دين الله لا يُصاب بالعقول))، فهو نصّ مبتور. والرواية عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام): «إِنَّ دِينَ اَللَّهِ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ»[6] . وهذه صفة للتقييد، فالعقل الناضج لا مشكلة فيه، لكن العقل الناقص الذي يغلب عليه الهوى لا يدرك به دين الله.
الآيات الكريمة في القرآن الكريم تدعو إلى التفكّر والتعقّل: ﴿ِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾[سورة آل عمران، الآية: 190]، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾؛ إذن الدين يُدرَك بالعقل.
أما تفاصيل الأحكام الشرعية، فهي محلّ اجتهاد. العلماء يتأملون في النصوص ويستنبطون منها بعقولهم. وإلا فكيف يستنبط العالم الأحكام من الكتاب والسنة إن لم يكن يفكر بعقله؟
الذين يقولون: القضايا الدينية تعبّدية، كلامهم يحتاج إلى تفصيل. فالقضايا الدينية أصناف. وهناك رأي لكبار الفقهاء أن القضايا القطعية الثابتة لا تتجاوز 5 – 6 % من الدين، أما أكثر من 94 % فهي قضايا نظرية اجتهادية قابلة للنقاش.
هذا ما أكّد عليه السيد محمد باقر الصدر في كتابه (اقتصادنا)[7] ، وذكره المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض في كتابه عن المسائل المستحدثة[8] .
فإذا كانت أكثر من 95 % من القضايا الدينية محل نقاش، فكيف يقال إن الدين كلّه تعبّدي لا يقبل النقاش؟! كما أنك لا تكاد تقرأ آية من القرآن إلا وتجد اختلافًا بين المفسّرين في تفسيرها، ولا تمرّ بمسألة فقهية إلا وهناك عدّة آراء حولها.
إذن القول بأن الدين قضايا تعبّدية لا تقبل النقاش هو نوع من التشدد والانغلاق.
المحاور: طيب قلت أيضًا في الموضع ذاته: "من مظاهر تهميش العقل في أوساط المتدينين الجمود على فهم الأسلاف للدين، ولا شك أن الظروف متغيرة والحياة متطورة، والأسلاف فهموا الدين حسب مستواهم وضمن ظروف عصرهم وبيئتهم، ونجد أن منهجية الدين قائمة على مراعاة التطور لذلك تجددت الشرائع عبر الأنبياء مع أن الدين في جوهره واحد". أنا سأسألك وقد يكون السؤال جدل يُطرح: البعض يقول إن التوراة جاءت ثم بعد قرون الإنجيل ثم بعد ذلك القرآن، ونحن اليوم نعيش بعد أكثر من ألف سنة والحياة تطورت جدًا، فهل بمعنى هذا نقول اليوم بأهمية تاريخية النص الديني نفسه؟
الشيخ الصفار:
النص الديني قسمان:
قسم يتحدث عن القِيم والحقائق الدينية الأساسية؛ هذا ثابت.
والقسم الآخر يتحدث عن قضايا الحياة وأمور الحياة؛ هذا بالتأكيد قابل للتطوير.
الفهم الذي نفهمه للنص قد يختلف عما فهمه السابقون. أذكر هنا كلمة للشيخ محمد مهدي شمس الدين -رحمه الله- يقول فيها: أنا أعتقد أن الأصل في العبادات الثبات، والأصل في المعاملات بين الناس التغيير. فأي مورد من الموارد شككنا هل يكون فيه تغييرٌ أم لا، يمكننا أن نغير أم لا؟ الشيخ يقول: الأصل في قضايا المعاملات — ما يرتبط بقضايا الحياة — الأصل فيه هو التغيير. لذلك الثوابت لها مكانها وهي ما يرتبط بالقيَم والحقائق الأساسية والقضايا العبادية (كالصلوات الخمس)، أما الأحكام التي ترتبط بإدارة الحياة فلا شك أنها مفتوحة أمام التغيير والتطوير.
المحاور: طيب باقي لي ثلاث دقائق؛ اكتفي بنص واحد. قلت في كتاب آخر: "كل التراث سواء كان ما عند السنة أو ما عند الشيعة يحتاج إلى بحث، لكن اللافت أننا نهرب من النقد الذاتي، وكل واحد يوجه نقده للآخر وليس لذاته. فالشيعي ينتقد ما في تراث أهل السنة لكنه لا يتحلّى بالجرأة لكي ينقد تراثه هو، والسني أيضًا ينقد ما في تراث الشيعة ولا يتحلّى بالجرأة لينقد ما عنده من تراث أيضًا ويُعيد النظر فيه. وفي الحقيقة كل تراث السني والشيعي بحاجة إلى إعادة نظر."
الشيخ الصفار:
لأن هذا التراث القسم الأكبر منه جانب بشري: روايات ونصوص منقولة. ومن الثابت عند جميع المسلمين أنه فُتح باب الكذب على رسول الله  حتى في حياته؛ وقد ورد عنه
حتى في حياته؛ وقد ورد عنه  : «قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[9] ؛ وكُذب على أئمة أهل البيت أيضًا. وهذه النصوص التي نُقلت، قسم كبير منها تدوينها كان متأخّرًا فكيف لنا أن نتأكّد من هذه النقولات؟
: «قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[9] ؛ وكُذب على أئمة أهل البيت أيضًا. وهذه النصوص التي نُقلت، قسم كبير منها تدوينها كان متأخّرًا فكيف لنا أن نتأكّد من هذه النقولات؟
وأيضًا قسم كبير منها نُقل لنا بالمعنى وليس باللفظ، لأن علم الحديث يقول إن من المقبول من الراوي أن ينقل بالمعنى، ولا يُشترط أن ينقل باللفظ. هذا طبيعي أن يفتح الباب على كثير من الإشكالات والثغرات ومواقع الخلل في هذا التراث المنقول. فعلينا أن نجتهد في تنقيح هذا التراث وغربلته في كتب السنة وكتب الشيعة وكتب الإباضية والزيدية وكلُّ التراث. المجتمع الحيوي هو الذي يتمتّع بعقلية النقد وعقلية الدراسة والملاحظة، وليس بالتبعية العمياء.
لكن إذا كان إنسانٌ ضمن مذهبٍ وانتقد المذهب الآخر (أنا شيعي وأسلّط الأضواء على ثغرات مذهب أهل السنة)، يصبح بطلاً عند قومه: "أرَأَيْتَ ماذا يقول فيهم!"، أما إنه إذا انتقد في مذهبه فإنه سيُحارب ويُعتبر توهينًا للعقيدة أو تمييعًا؛ وهذا موجود لدى السنة ولدى الشيعة. وقد وجدنا اتهامات لعلماء كبار من السنة بأنهم "تأثروا بالشيعة" أو "مالوا إلى الشيعة"، ووجدنا كذلك علماء من الشيعة يُتهمون بتأثرهم بالمخالفين. الجرأة في النقد داخل المذهب تكون منعدِمة أو ضعيفة جدًا، ومن يمارس الجرأة فعليه أن يستعد لاستقبال الشتائم والرماح و"يرجمونه بالحجارة".
أسئلة الحضور
المحاور: سماحة الشيخ حسن الصفار، شكرًا جزيلًا لك على هذه الإضاءات. الآن سنفتح المجال للأخوة الكرام. حبّذا لو يكون السؤال مع ذكر الاسم، بعيدًا عن المداخلات المطوّلة، لأن لدينا نصف ساعة فقط لأسئلة الجمهور.
الدكتور علي بن حسن اللواتي:
شكرًا شيخنا العزيز. سعداء بوجود هذه القامة التي عرفتها عُمان في مطالع نهضتها المتجددة.
سؤالي: كنتم من الروّاد في طرح تجربة الحوار الوطني داخل المملكة، وأعتقد أنكم من أوائل من طرح موضوع الحوار مع التيار السلفي، وكانت الفكرة في ذلك الوقت جريئة وقد يُنظر إليها كفكرة متقدّمة جدًا.
بعد هذه العقود الطويلة، كيف تُقيّمون هذه التجربة؟ هل ما زلتم على نفس الأفكار التي بدأتم بها؟ أم ترون أن التحديات كانت أكبر مما كنتم تتصورون؟ أم تعتقدون أن التجربة حققت جوانب نجاح يمكن الإشارة إليها؟
محمود الصفار (من العراق):
السلام عليكم. أول لقاء لي مع سماحتكم كان قبل 24 سنة، والحمد لله أنني ألتقيكم مرة أخرى اليوم.
تحدثتم عن إيجابيات قبول الآخر والتنوع في المجتمع. سؤالي: متى يكون تقبّل الآخر والانفتاح عليه نقمة على المجتمع؟
جاسم بن عرابة:
السلام عليكم شيخنا، شكرًا على هذه الجلسة الرائعة. لدي سؤال واحد لكنه يتشعّب إلى عدّة محاور:
أعتقد أن من موانع التعددية في التاريخ الإسلامي إلى اليوم هو استخدام العلاقة بين السياسة والدين: أحيانًا تُستخدم السياسة باعتبارها دينًا، وأحيانًا يُستخدم الدين باعتباره سياسة.
منذ السقيفة، مرورًا بمعاوية، ثم العباسيين (المأمون والمتوكل)، وصولًا إلى العصر الحديث.
مثال ذلك: الحرب العراقية الإيرانية حين سماها صدام حسين "قادسية جديدة"، أي استحضار إسقاط تاريخي ديني على معركة سياسية معاصرة.
سؤالي: كيف يمكن أن نخرج من هذه العلاقة المتضاربة بين الإسقاط السياسي على الدين والإسقاط الديني على السياسة؟ لا أقصد العلمانية وفصل الدين عن الدولة، بل أقصد أن لا تُستغل السياسة لتُقدَّم كدين، ولا الدين ليُستغل كسياسة.
الحبيب سالم المشهور:
ذكرتم سماحتكم نظرية الاختيار. هناك من قد يتهمها بأنها تشبه "التشهي": كأنني أمام مائدة آخذ ما طاب لي أو ما يناسب الواقع. فما هي الضوابط التي تضعونها لهذه النظرية؟
في موضوع الثابت والمتحول: الشيخ شمس الدين قال "الأصل في العبادات الثبات، وفي المعاملات التغيير". لكن التخوف عند الكثير من المتدينين أن يؤدي هذا الانفتاح إلى ضياع ثوابت الدين.
لدينا أمثلة لأقليات دينية كالإسماعيلية الآغاخانية، حيث اختُزلت الصلاة عندهم إلى قراءة الفاتحة والأدعية والتسبيح. فكيف نمنع أن ينتهي الانفتاح إلى مثل هذا المصير؟
وكيف نُعالج موضوع "الضروري" في الدين؟ لأننا نبقى غالبًا في العموميات، بينما التفاصيل تثير إشكالات كبيرة.
نقطة أخرى: ذكر الأستاذ بدر مرارًا قضية العلمنة والظرفية. في العموميات القرآنية الصورة جميلة جدًا، لكن في تفاصيل الفقه هناك أمور لا يمكن تجاوزها. إذا اعتنقنا النظرة "الإنسانوية" الحالمة، ألن نواجه صعوبات في تفسير النصوص الدينية، خصوصًا بعض آيات القرآن الكريم؟ هذه تبدو معادلة صعبة.
المحاور: الدكتور علي يسأل: كيف تقيّمون تجربة الحوار في السعودية؟
الشيخ الصفار:
التجربة ـ والحمد لله ـ أعتبرها رائدة، وكلما مرّ الوقت تتعزّز عندي الفكرة والتوجّه، والآثار كانت إيجابية.
أعتقد أننا في المملكة تجاوزنا كثيرًا من حالة التشدد والتشنج، لأن الدولة اتخذت قرارات وإجراءات مناسبة في هذا الاتجاه. لكن هذا كان بناءً أيضًا على ما جرى من مخاض في الحالة الاجتماعية بعد أن طُرحت هذه الأفكار.
ولا أدّعي أني وحدي من طرحها، فقد تبنت الدولة فكرة "الحوار الوطني" في عهد الملك الراحل عبد الله، وكانت لقاءات مهمة جدًا. وهذا ما قاد المجتمع إلى أن يصبح أكثر تقبّلًا لهذه الفكرة.
فلا تزال علاقاتي، وعلاقات بعض من أعرف من المهتمين بهذا الجانب ـ مع مَن يُحسبون على المدرسة السلفية قائمة ومستمرة. والوضع في تحسّن، والتجربة جيدة.
لكن: قد تأتي موجات معينة، إعلامية أو سياسية، وتترك آثارها على المجتمع. غير أن الأصل أن المسار جيد والنتائج طيبة. وأنا أحمد الله تعالى على ما تحقق على هذا الصعيد، ونأمل المزيد إن شاء الله.
المحاور: محمود الصفار يسأل: متى يكون تقبّل الآخر نقمة؟
الشيخ الصفار:
لا أعرف كيف يمكن أن يكون تقبّل الآخر نقمة، إلا إذا كان الآخر سيئًا، غير ملتزم أو غير منضبط. هنا تأتي الإجراءات الطبيعية: فكل دولة لها أنظمتها وقوانينها، ومن يتجاوز الحدود تُتخذ بحقه إجراءات مناسبة.
لكن كفكرة، تقبّل الآخر لا يكون نقمة، بل دائمًا هو نعمة. ولنا في أنبياء الله، وفي نبينا محمد  ، وفي الأئمة (عليهم السلام) قدوة حسنة في كيفية تقبّل الآخر على عِلاته.
، وفي الأئمة (عليهم السلام) قدوة حسنة في كيفية تقبّل الآخر على عِلاته.
فإذا أساء الآخر أو اعتدى، فالأمر يعود إلى النظام الحاكم لاتخاذ الإجراءات. لكن الأصل أن تقبّل الآخر نعمة، لأنه حينما تتقبله تستطيع أن تؤثر عليه وتغيّره. أما إذا رفضته وابتعدت عنه، فإن فرصة التأثير تضيع.
وهذا ما أكّد عليه القرآن الكريم: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾[سورة فصلت، الآيتان: 34-35]. ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾[سورة البقرة، الآية: 83]. ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[سورة الإسراء، الآية: 53] ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[سورة النحل، الآية: 125]
فهذا هو المسار الطبيعي الذي يراهن عليه الدين: التعامل بالحسنى مع الطرف الآخر. أمّا الحالات الاستثنائية، فتُعالج ضمن النظام العام للدولة وفي حدودها.
المحاور: الأستاذ جاسم يتحدّث ويقول: إشكاليتنا هي عدم التمييز بين ما هو سياسي وتاريخي وبين ما هو ديني، ولا زال هناك ازدواجية في هذا الجانب.
الشيخ الصفار:
هذه المشكلة قائمة. سيبقى العامل السياسي عاملاً مؤثِّرًا في المجتمعات.
علينا أن نحتكم إلى القيم وإلى المبادئ، لكن الطرف الآخر أو الناس المصلحيين يحاولون أن يقوموا بإسقاطات. علينا أن نسلط الأضواء على الإسقاطات غير الصحيحة وغير السليمة.
فتارة تكون الإسقاطات لتوضيح الفكرة؛ يعني أن أستشهد بحدث في الزمن الماضي لكي أضيء فكرة معيّنة، وأقول إن هذه الفكرة كانت مقبولة في زمن النبي  أو الأئمة أو الصحابة. هذا ليس أمرًا سيئًا.
أو الأئمة أو الصحابة. هذا ليس أمرًا سيئًا.
وتارةً أخرى أريد من هذه الإسقاطات أن أبرر بها بطريقة غير سليمة وغير صحيحة. وهنا لا بد أن تكون العقول منفتحة، ويكون هناك مجال للنقد، وتسليط الأضواء على مواضع الخلل.
المحاور: سؤال حبيب سلام واضح، وهو يتحدث عن قضية ضوابط نظرية الاختيار، وقضية الثابت والمتحول. والتخوف عند بعض المتدينين هو أن يكون "المتحول" في جانب المعاملات سائِبًا، بلا ضوابط.
الشيخ الصفار:
لا بد من الضوابط. لا ندعو إلى التطوير والتجديد من دون ضوابط. نؤمن أن هناك ضوابط لا بد أن تكون قائمة، حتى نُميّز بها بين الثابت والمتغير، وتكون معالجتنا للمتغير ضمن المسار العلمي الصحيح.
لهذا ندعو العلماء والفقهاء أن يأخذوا زمام المبادرة. فالتأخر في أخذ زمام المبادرة هو الذي يُحدث فراغًا في الساحة، ويعطي الفرصة للآخرين. لأن العلماء حين يقصّرون في القيام بدورهم على هذا الصعيد، يجد الناس أنفسهم أمام تحدٍّ وفراغ، فتكون الفرصة متاحة أمام الطروحات غير الموزونة وغير السليمة.
وأريد أن أضيف: كل مجال من مجالات الحياة فيه احتمالات خطر. حتى قيادة السيارة فيها احتمالات خطر. لا تستطيع أن تمنع قيادة السيارة، لكنك تؤكد على الالتزام بالنظام وتجنّب المخاطر.
في هذا الموضوع، غالبًا ما يُقال: هذا يسبب مخاطر. حسنًا، إذا كان يسبب مخاطر، هل نترك الطريق كله؟ لا، بل نسير فيه مع أخذ المخاطر بعين الاعتبار.
إن مبدأ "سدّ الذرائع" حين يتضخم في أذهان بعض العلماء والفقهاء يصبح سببًا للجمود والركود.
إرشاد اللواتي:
سماحة الشيخ، تغطيتكم للتعددية كانت جميلة جدًا، وبيّنتم مدى مساعي نجاحها. وكما تفضلتم، التعددية تُبنى أساسًا على الحوار وتقبّل الآخر، وهذا يمر بعدة مراحل:
الحوار مع اللادينيين والملحدين، ثم الحوار بين الأديان، ثم الحوار بين المذاهب، وأخيرًا الحوار داخل المذهب الواحد.
الآن، إذا كانت الحواجز والجدران عالية ضمن المذهب الواحد نفسه، ألا يتطلب ذلك جهودًا خاصة تُبذل لكسر هذه الحواجز؟
أنا معرفتي بالمذاهب الأخرى محدودة، لكن حتى ضمن المذهب الشيعي نجد الجدران الفاصلة عالية جدًا. وهذا قد يستدعي توجهًا خاصًا. فما تعليقكم على ذلك؟
الأستاذ حمود الطوقي:
شكرًا جزيلًا سماحة الشيخ، وشكرًا أيضًا للدكتور بدر على هذه الإدارة الجميلة.
في الحقيقة، السؤال الأخير الذي طرحه الدكتور بدر كان محور تساؤل للكثيرين، وقد أجبتم عليه بشكل جيد. لكن لدي مجموعة أسئلة سريعة أود طرحها:
ما رأيكم في مشروع المؤتلف الإنساني الذي أطلقه السلطان الراحل قابوس بن سعيد (طيّب الله ثراه)، وكان آخر مشروع أطلقه؟ المشروع كان هدفه التعايش بين الأمم، وخلق نوع من التعارف وزرع المحبة بين شعوب العالم، وما زالت عُمان تحتفي به في ديسمبر من كل عام. ما هي نظرتكم لهذا المشروع، خاصة وأن عُمان دائمًا ما سعت لترسيخ التآلف بين الشعوب والعلاقات الإنسانية؟
كمسلمين نتحدث دائمًا عن أن الإسلام هو دين الحق، ونستشهد بآيات عديدة، ومنها الآية الجدلية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[سورة آل عمران، الآية: 5]
هل المقصود هنا بالإسلام "الدين والشريعة الخاصة"، أم أن الإسلام بمعناه العام أي "السلام والخضوع لله"؟ وهل هذه الجدلية ما زالت قائمة؟
تحدثتم عن المذاهب الإسلامية واختلافاتها، وكيف أدّت إلى صراعات منذ الخلافات الأولى حتى اليوم. لكننا نرى أيضًا أن الغرب يتقدّم بفعل تسييس المذاهب، بينما المسلمون يتناحرون فيما بينهم حول من الأصح ومن الأحق. كيف تقيمون هذا الواقع؟
أشرتم في أكثر من مداخلة إلى التشنّج والتشدّد. برأيكم: من هو الذي يسوّق لهذا التشنج بين المسلمين؟ وهل ما زلنا حتى اليوم نتلقى رسائل تدفعنا إلى هذه المرحلة من التشدد؟ ولماذا أصبح التعايش في عُمان أنموذجًا يُحتفى به؟ وهل هناك في عُمان تجربة مشرفة خاصة؟
ولماذا عندما يُطرح موضوع التعايش نسمع من الآخرين أن في عُمان تعايشًا متميزًا، بل ومحبة بين المذاهب، وحتى زواجًا بين الشيعة والإباضية وأهل السنة؟ وهل هذا الفكر يمكن اعتباره أنموذجًا يُحتذى بالفعل؟
الأستاذ محمود اللواتي:
أحسنتم شيخنا العزيز. تفضلتم في حديثكم أن هناك 5 إلى 6% من الأحكام هي توقيفية، والبقية ـ أي أكثر من 95% ـ هي مسائل مختلفة.
السؤال: لماذا إذن هذا السجال العنيف، والحروب الكلامية التي تصل إلى التفسيق والتضليل، سواء داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب المتعددة؟ ولمن تكون الغلبة في النهاية؟
أحمد الحارثي:
المصطلحات التي طُرحت الآن مثل "الأنسنة" و"العلمَنة"، في داخل الدائرة الإسلامية تقابلها مصطلحات قديمة مثل "الضلال" و"الكفر" و"البدعة". هذه المصطلحات بقيت تحمل مدلولها القديم الثقيل.
السؤال: لماذا لا نعيد صياغة مدلولها ليكون بمعنى: "أنا على صواب وأنت على خطأ"، دون أن تعني أن الآخر خرج من الإسلام أو خرج من الإيمان؟
توفيق اللواتي:
شكرًا سماحة الشيخ. نحن نتحاور ونتعايش ونتقبل الآخر، لكن أحيانًا الآخر غير المسلم يأتي ليميّعنا. مثلًا: يطرح "الديانة الإبراهيمية"، أو يحاول إخراج الإسلام من مضامينه، أو يطالب بحذف آيات الجهاد، أو صياغة الإسلام بما يريده هو.
فهل يكون هذا حوارًا متكافئًا بين ندّين؟ أم أننا نقبل بأي حوار وبأي شروط ونتنازل عن ثوابتنا؟
وعلى المستوى الداخلي: هناك اليوم من ينشر قيمًا مرفوضة مثل المثلية وغيرها. فهل نقبل أن يعيش بيننا ويدعو إلى هذه الأفكار تحت شعار الآية: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾[سورة الكافرون، الآية: 6]؟
أين الحد الفاصل بين الأبيض والأسود في هذه القضايا؟
الدكتور أحمد الصفار (من العراق):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ مرحبًا بكم.
سؤالي عن بعض الأحكام الإسلامية التي تُعيق العلاقة مع الآخر، مثل: مسألة بناء الكنائس أو ترميمها في بلد مسلم، حيث يمنعها بعض الفقهاء. وكذلك حكم المرتد، وهو موضوع شديد الحساسية. كيف يمكن التعامل مع هاتين المسألتين إذا أردنا أن ننفتح على الآخر ونقبل التعددية؟
عمر الزعابي:
سماحة الشيخ، عندي سؤالان:
هل يجوز للإنسان أن يعتقد أنه على صواب، وأن رأيه هو الصحيح؟
ما تفسيركم أو رأيكم في الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[سورة البقرة، الآية: 62]. هل هذا الوعد يشمل الدنيا والآخرة معًا؟
سعيد جمعة البلوشي:
السلام عليكم. هناك بعض الكتّاب من يحصر سبب المشاكل بين المسلمين فيما يُسمى بـ "العقيدة الجدالية أو التخمينية"، وهي قضايا فوق التصوّر البشري. ويقولون إن النقاش في هذه القضايا أدّى قديمًا إلى نزاعات شعبوية في أحسن الأحوال، ولا يزال الأمر مستمرًا حتى اليوم.
فما رأيكم شيخنا العزيز في هذا الطرح؟
الأستاذ كمال اللواتي:
سماحة الشيخ، لدي سؤالان:
الخطوط العريضة التي نظّر لها فقهاء التقريب ظلت تواجهها تفاصيل فكرية وعقدية وفقهية وحديثية في التراث. وهذا التراث لم يتغير الموقف منه رغم كل التنظير العام. فأنتم من جهة تنظّرون للتقريب بمديات بعيدة، لكن في المقابل لا تُبدون موقفًا واضحًا تجاه الحمولات الكبيرة الناقضة للتقريب داخل تراثكم، بل تستمرون بالتعامل معها بوصفها حقائق ثابتة. ما تعليقكم؟
الإعلام التقريبي ـ كما يُقال ـ يعتمد على ركيزتين: الصمت والسكوت، والتناول النخبوي. وقد ذكرتم أن 5% من المسائل ثابتة، والباقي متغيرة. لكن حسب فهمي المتواضع: الاختلاف يكون في النتائج، لا في أصل المسائل. وبعض هذه النتائج قد تُعتبر "تعبدية" غير قابلة لفهم العقل. ومع ذلك، هذا لا يعني التوقف عن مناقشتها. كيف تفهمون هذه الإشكالية؟
المحاور: شيخنا العزيز، الأستاذ علي يتكلم عن جدران الحواجز بما يتعلّق بالحوار داخل المذهب الشيعي نفسه.
الشيخ الصفار:
في الواقع، العقلية واحدة. من يتربى على الحوار ويؤمن بالحوار، يمارسه في مختلف الساحات والميادين: داخل عائلته، في عمله التجاري، في نشاطه الاجتماعي، وفي الجانب العقدي أيضًا. فهي عقلية واحدة يتربى عليها الإنسان.
المفترض أن يقتنع الإنسان بما يقوله الدين، وما توحي به الفطرة، وما يأمر به العقل، وهو أن العلاقات بين الناس لا تنتظم إلا عبر منهج الحوار، وأن البديل هو الصراع والعداء والتشنج. فهي عقلية واحدة في مختلف الميادين والساحات: داخل المذهب، بين المذاهب، بين الأديان، وبين الحضارات.
اليوم يُطرح موضوع "صدام الحضارات" أو "حوار الحضارات"، وهو في جوهره عقلية واحدة. والغريب أننا حين نقرأ التعاليم الدينية نجدها تركز على هذا الأمر في كل الدوائر:
في العلاقة العائلية، يؤكد الدين على الحوار، يقول تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾[سورة البقرة، الآية: 233]
وفي وصايا لقمان لابنه: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾[سورة لقمان، الآية: 13]
وفي قصة نبي الله نوح مع ابنه حين قال له: ﴿يَٰيَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ﴾[سورة هود، الآيتان: 42-43]
نلاحظ أن النبي نوح  لم يضرب ابنه ولم يجبره على ركوب السفينة، بل راهن على الإقناع فقط.
لم يضرب ابنه ولم يجبره على ركوب السفينة، بل راهن على الإقناع فقط.
وفي العلاقة مع الآخر الديني، يقول القرآن: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[سورة العنكبوت، الآية: 46]
إذن، الدين يربي الإنسان المسلم على أن ينتهج منهج الانفتاح والحوار مع الآخر، في مختلف الدوائر والساحات.
المحاور: الأستاذ حمود سأل سؤالين سأدمجهما: ما رأيكم في مشروع المؤتلف الإنساني الذي أطلقه السلطان قابوس رحمه الله؟ ولماذا برأيكم أصبح التعايش العُماني اليوم أنموذجًا يُحتذى، خصوصًا وأنكم تنظرون من الخارج؟
الشيخ الصفار:
لا شك أن التجربة في عُمان تجربة ثرية. وأنا شخصيًا عشت هذه التجربة في بداية حياتي الفكرية والعملية، وأعتقد أنها كانت مؤثرة في مسيرتي. فقد كانت أول تجربة اجتماعية لي في عُمان، في مسقط ومطرح، وقد كتبت عن ذلك. استفدت منها وتأثرت بها كثيرًا، لأنني جئت من جوٍّ لم يكن يتوفّر فيه مثل هذا الفضاء التسامحي. وحين عشت في عُمان، بالفعل أثرتني هذه التجربة، وكان لها دور في التوجّه الذي أسلكه اليوم.
هي تجربة رائدة، اشتركت فيها ثلاثة عناصر أساسية:
الدولة: كان لها دور محوري في تعزيز حالة التسامح والمساواة بين المواطنين.
العلماء والفقهاء: دعموا ورفدوا هذه الحالة. وأنا شخصيًا في تلك الفترة كانت لي علاقات مع المفتي السابق الراحل الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري رحمه الله، ومع بقية العلماء.
المجتمع: فقد حمل من طيب النفس وكرم الأخلاق، ما جعله ينسجم مع سياسة الدولة، وتوجيه العلماء.
لذلك فهي تجربة ثرية، ينبغي أن تُحتذى. ونأمل أن لا يجد الأعداء أو الحمقى والمسيؤون طريقة لتخريبها. ما حصل في ليلة العاشر من المحرم هذا العام أثار قلقًا كبيرًا عندنا، حتى لا نفقد هذه التجربة الرائدة أو تتشوّه وتتشوّش. ولهذا تابع الجميع الحدث بقلق، وبرجاء أن يتغلب الشعب الطيب، وقيادته، وحكومته، وعلماؤه على هذه المحاولات.
ونأمل إن شاء الله أن تواصل سلطنة عُمان ـ حكومةً وقيادةً وشعبًا ـ السير في هذا الاتجاه المشرق.
المحاور: الأستاذ حمود سأل سؤالين أدمجهما معًا، يتعلقان بالتعددية: إذا كان هناك أديان متعددة، فمن هو الدين الحق؟ هل الإسلام هو دين الحق أم اليهودية أو غيرها؟ وكذلك ماذا تعني الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾[سورة آل عمران، الآية 85] هل الإسلام هنا بمعنى "السلام"، أم الإسلام بمعناه الخاص كديننا المعروف؟
الشيخ الصفار:
من الطبيعي أن كل صاحب دين أو مذهب يعتقد أن دينه ومذهبه هو الحق، وإلا لما اعتنقه. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[ سورة الأنعام، الآية: 108]
الحالة الطبيعية أن يرى الإنسان أن مذهبه ودينه هو الحق. ونحن كمسلمين نعتقد أن ديننا هو الحق، كما يعتقد غيرنا أن دينه هو الحق، وهذا لا نقاش فيه.
النقاش الحقيقي هو: هل اعتقادك بأن دينك هو الحق يُسَوِّغ لك العدوان أو الإساءة لمن يعتنق دينًا آخر يراه هو الحق؟ الجواب: لا. فكما ترى دينك حقًا، هو أيضًا يرى دينه حقًا، ومن الواجب أن تحترمه ولا تُسيء إليه.
أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾﴾[سورة آل عمران، الآية: 19] وقوله تعالى: ﴿وَموَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[سورة آل عمران، الآية: 85]، فإن الإسلام قد يُفهم بمعناه الخاص أي الشريعة المحمدية، أو بمعناه العام أي التسليم لله والخضوع له، وهو ما شملتْه جميع الرسالات السماوية في أصلها الصحيح قبل أن يلحقها التحريف.
لكن المهم أن هذه الآية تتحدث عن الآخرة: ﴿فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.
هذا الحكم عند الله تعالى، وليس لنا نحن. الله سبحانه هو الذي يقرر في الآخرة، وهو أعلم بعباده وأرحم بهم.
أما نحن في الدنيا، فمسؤوليتنا أن نتعايش وأن يحترم بعضنا بعضًا. أنا أعتقد أن ديني هو الحق، والآخر يعتقد أن دينه هو الحق، لكن التعامل يجب أن يبقى قائمًا على الاحترام المتبادل، لا على العدوان والإقصاء.
المحاور: آخر سؤال طرحه: ألا ترون أن الإشكالية تكمن في تسييس المذاهب الإسلامية؟ ومن الذي يسوِّق للتشنج اليوم بين المسلمين؟
الشيخ الصفار:
أنا لا أحبّذ أن نُلقي بالمسؤولية دائمًا على الخارج. كثيرًا ما نقول "الأعداء"، نعم هم يحاولون استغلال الوضع، لكن في النهاية نحن بشر، ونقاط ضعف البشر موجودة فينا. هذه النقاط هي التي تجعلنا نختلف ونحترب.
وهذا ليس أمرًا جديدًا، بل حصل منذ البداية في قصة ابني آدم، كما يقول تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾[سورة المائدة، الآية: 27]
هنا لم تكن هناك مؤامرة أمريكية ولا صهيونية هي التي فرّقت بينهما؛ بل هو جانب من الطبيعة البشرية التي تميل أحيانًا إلى الشرّ والفساد إذا لم يردعها الإنسان بعقله، وباهتدائه بالوحي.
هذه الحالة طبيعية في المجتمعات البشرية، لكن واجبنا أن نواجهها بالمزيد من الوعي، وبالمزيد من اليقظة، وأن نتواصى فيما بيننا بالحق وبالصبر، حتى لا تتحول هذه النزعات إلى صراعات مدمرة.
المحاور: لا شك أن كثيرًا مما طرحه الإخوة يحتاج إلى تفصيل أكبر، لكن الوقت لا يسمح. الأستاذ محمود اللواتي يسأل: بما أنكم ذكرتم أن أغلب الدين ليس توقيفيًا، فلماذا هذا الجدل بين المسلمين؟ ولمن تكون الغلبة؟
الشيخ الصفار:
أولًا أود أن أصحح ما ذكره الأستاذ كمال أبو يوسف: الشيخ الفياض لم يقل إن 95% من الدين متغير، بل قال إن الأشياء القطعية التي لا جدال فيها لا تتجاوز 5 إلى 6%، وأما بقية المساحة فهي محل نقاش وجدال. فهذا بعيد عن مسألة الثابت والمتغير، بل المقصود أنها مجالات اجتهادية قابلة للاختلاف.
فلماذا إذن هذا التشنج؟ هذا هو السؤال.
لقد وقع الاختلاف حتى في زمان رسول الله  ، حول قضية عبادية، حين قال: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»[10]. فجماعة من الصحابة صلّوا في الطريق قبل أن تغيب الشمس، ورأوا أن القصد المسارعة لا تفويت الصلاة في وقتها، بينما جماعة أخرى لم يصلّوا حتى بلغوا بني قريظة وإن غابت الشمس.
، حول قضية عبادية، حين قال: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»[10]. فجماعة من الصحابة صلّوا في الطريق قبل أن تغيب الشمس، ورأوا أن القصد المسارعة لا تفويت الصلاة في وقتها، بينما جماعة أخرى لم يصلّوا حتى بلغوا بني قريظة وإن غابت الشمس.
والنبي  أقرّ الطرفين، مع أن المسألة تعبدية. وهذا يبين أن الاختلاف في فهم نصٍّ أو في تطبيق حكم لا يستوجب تشنجًا ولا انفعالًا.
أقرّ الطرفين، مع أن المسألة تعبدية. وهذا يبين أن الاختلاف في فهم نصٍّ أو في تطبيق حكم لا يستوجب تشنجًا ولا انفعالًا.
فالسبب فيما نراه اليوم يعود إلى أمرين: سوء فهمٍ للدين، أو سوء خُلقٍ عند الإنسان يجعله لا يتسع صدره لوجود الرأي المختلف.
المحاور: أحسنت. الأستاذ أحمد الحارثي يسأل: لماذا لا نسمح لمفهوم الضلال أن يكون له مفهوم جديد؟
الشيخ الصفار:
الضلال في القرآن الكريم يُستخدم بالمعنى اللغوي أيضًا، فالإنسان إذا ضل الطريق ولم يعرف المسلك الصحيح يُقال له: ضلّ. لكن مع كثرة الاستخدام صار لهذه الكلمة ظلال معينة في نفوسنا وأذهاننا.
كثير من الكلمات تتشكل ظلالها مع مرور الزمن. مثلًا كلمة هلك: إذا تحدثت عن شخصية محترمة وقلت: "الشيخ فلان هلك في سنة كذا"، قد لا يقبل الناس منك؛ لأن كلمة "هلك" في ثقافتنا المعاصرة توحي بأنك غير آسف على رحيله. مع أن القرآن الكريم استخدمها مثلًا في قصة نبي الله يوسف: ﴿حَتَّى إِذَا هَلَك﴾[يوسف، الآية: 101]
إذن، الكلمات تتأثر بالزمن والثقافة، فتأخذ ظلالًا سلبية أو إيجابية. أما في أصلها فالضلال يعني: عدم معرفة الطريق الصحيح.
لكن مشكلتنا أننا إذا اختلفنا مع الآخر في الرأي، أسرعنا إلى الحكم عليه بالكفر والخروج من الدين. مع أن الاختلاف المقبول ينبغي أن يُقاس على ميزان الصواب والخطأ، لا على ميزان الكفر والإيمان.
الإنسان قد يكون صائبًا أو مخطئًا، وليس بالضرورة أن يكون مؤمنًا أو كافرًا.
المحاور: الأستاذ توفيق اللواتي يسأل: إذا تقبّلنا الآخر، فماذا لو أراد أن يُميّع الدين، مثل الدعوات حول الديانة الإبراهيمية، أو التوسع في العلاقة مع اليهود، أو تجاوز آيات الجهاد، أو نشر الرذيلة في المجتمع؟
الشيخ الصفار:
كل منحى يسلكه الإنسان له إيجابيات وله سلبيات. فالانغلاق سلبياته كبيرة، والتحجر سلبياته عظيمة، والانفتاح أيضًا فيه سلبيات وتحديات. لكن لا يصح أن نقول: نرفض الانفتاح لأن فيه سلبيات، بل نقبل الانفتاح مع اليقظة والوعي.
نحن نسير في هذا الطريق، ولكن بضوابط وبحذر. صحيح أن الجهات المعادية قد تحاول استغلال الجمود لتُفرّخ لنا المتشددين، وقد تحاول استغلال الانفتاح لتُميع ديننا وقيمنا. لكن الحل ليس في إغلاق الأبواب، بل في الانفتاح المسؤول، والانفتاح الواعي، الذي يراقب سلبياته ويعالجها.
المحاور: الدكتور أحمد الصفار سأل: هناك بعض القضايا الإسلامية التي تُعيق التعارف أو العيش مع الآخر، وضرب مثالًا بمسألة بناء الكنائس أو ترميمها، وكذلك حكم المرتد.
الشيخ الصفار:
هذه كلها محل نقاش، وليست من الثوابت. فمسألة قتل المرتد مثلًا ليست حكمًا ثابتًا عند جميع الفقهاء، خاصة في زماننا، هناك من كتب ونظّر وأعطى آراء جديدة لإعادة البحث في هذا الموضوع.
أما موضوع الكنائس أيضًا، فهو محل بحث ونقاش، وليس من القضايا القطعية الثابتة. لذلك من المهم أن تُبحث مثل هذه القضايا وتُعالج من أجل تجاوز هذه الإشكاليات.
وأنا متفائل أننا نعيش في وقت أصبحت فيه العقول أكثر نضجًا، والأجواء أقرب لمعالجة هذه المسائل بروح منفتحة وواعية.
المحاور: الأستاذ عمر الزعابي يسأل: هل يجوز لأي إنسان أن يعتقد أن منهجه وما يراه هو الصحيح، وهل له الحق في ذلك؟ وأيضًا الآية الكريمة في سورة البقرة التي تتحدث عن أهل الأديان الأخرى وتختم بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[سورة البقرة، الآية 62]، هل هي منسوخة أم مازالت باقية؟
الشيخ الصفار:
في الفكر الديني هناك قاعدة معروفة، هي أن الإنسان لا يكون معاقبًا ولا مؤاخذًا إلا إذا اتضحت له الحقيقة وعاندها وجحدها. أما إذا كانت الحقيقة غير واضحة أمامه، وكان قاصرًا عن معرفتها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على ذلك. يقول تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[سورة الإسراء، الآية 15]، ويقول تعالى: ﴿لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾[الأنعام، الآية: 149]
وعليه، فإن العلماء والفقهاء قرروا في علم الأصول قاعدة معروفة: "قبح العقاب بلا بيان".
فأتباع الديانات المختلفة، إذا نشأ الواحد منهم في بيئة لم تمكنه من التعرف على الدين الحق، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تتسع لهم. وهو جل شأنه أرحم الراحمين.
المحاور: الأخ سعيد البلوشي سؤاله حول ما يتعلق بالعقيدة الجدلية، إذ يرى أنها لا زالت هي التي ولّدت المشكلة بين المسلمين.
الشيخ الصفار:
نحن المسلمين بدلًا من أن يكون الدين عندنا منهجًا للحياة، أصبح شُغلاً لنا عن الحياة.
انشغلنا بالتفاصيل العقدية والفقهية، وتضخمت عندنا هذه القضايا المختلفة، حتى نسينا جوهر الدين وهو الحياة الطيبة.
وهذا أشبه بإنسان تُعطيه "كتالوج" يشرح وظائف السيارة وأجهزتها، فيظل يتأمل في الكتالوج ويعجب به، لكنه يترك السيارة جانبًا ولا يقودها!
الدين منهج لإدارة الحياة، لكنه صار عندنا وسيلة للانشغال عن الحياة.
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله دخل المسجد فرأى جماعة من الصحابة يتنازعون في القضاء والقدر، فغضب حتى بان الغضب في وجهه كحبّ الرمان، ثم قال لهم: «أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَبِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟»[11]؛ يعني أنتم بُعثتم لتقيموا حضارة وحياة جديدة في المجتمع، فإذا بكم تنشغلون بالجدل والنقاشات التي لا تنتهي.
هذه من مشكلاتنا الكبرى: أننا شُغلنا بالدين عن الحياة.
المحاور: طيب، لعلك أجبتَ على تعقيب الأستاذ كمال اللواتي. نختم الآن مع سؤال الأستاذة زهور عبد الخالق: ما هي العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تساهم في ظهور التطرف؟ وكيف يساهم التأثير الديني أو السياسي لبعض الزعماء في تعزيز هذا التطرف؟
الشيخ الصفار:
التربية عبر العائلة والبيئة هي العامل الأهم. حينما ينشأ الإنسان في عائلة تُربيه على الهدوء، وعلى العقلانية، والحكمة، وعلى حسن العلاقة مع الآخرين، وحينما يعيش في بيئة تسودها ثقافة التسامح، فإنه يتكوّن إنسانًا متسامحًا.
نحن نرى اليوم بعض المجتمعات التي يعيش فيها الناس متعايشين متآلفين، لأنهم تربوا في بيئة صنعت لهم هذا المسار، ووجّهتهم عوائلهم نحو هذا النهج.
أما إذا كان الطفل يعيش في بيئة مشحونة بالكراهية، ومدارس تزرع التعصب، فإن النتائج تكون مختلفة. على سبيل المثال، نرى أحيانًا بين طلاب المدارس حالات من التنمر المذهبي أو الطائفي، فقط لاختلاف الانتماء أو المذهب، وهذا مؤشر على أن التربية هي الأساس.
تبقى الطبيعة البشرية تحمل الاستعداد للخير والشر، لكن يبقى دور التربية هو الحاكم الأبرز في تحديد مسار الإنسان، نحو التسامح أو نحو التعصب والتطرف.
المحاور: في الختام، نشكر سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار على هذه الإضاءات الجميلة، وهذه الرؤية المنفتحة والرائعة. ونشكر جميع الحاضرين والإخوة الذين شاركوا بأسئلتهم.
شكرًا لكم جميعًا، وليلة سعيدة.
لمشاهدة الندوة:
https://www.youtube.com/watch?v=QdpUpQrQvys