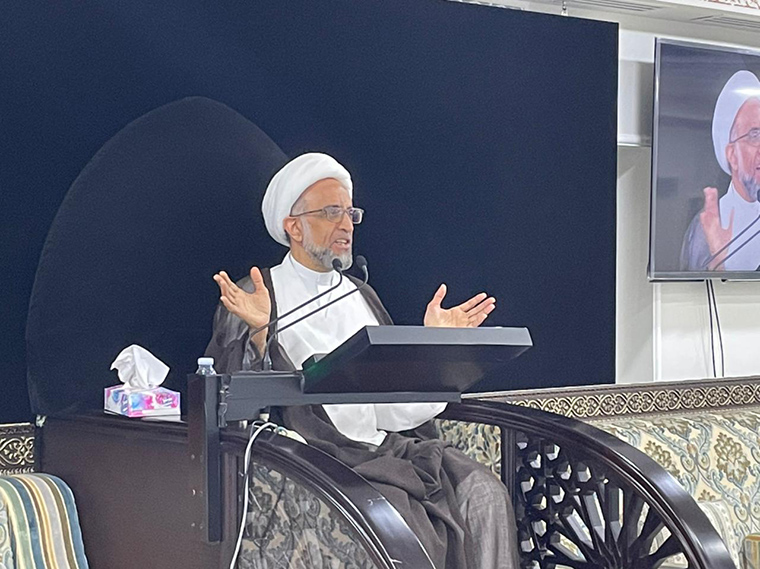موقعية حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي

لا يحتاج الباحث في القرآن الكريم إلى مزيد جهد وعناء ليكتشف ريادة القرآن الكريم في إعلان حقوق الإنسان، والتأسيس لمنظومة متكاملة من المبادئ والمفاهيم والإجراءات التي تقرر تلك الحقوق، وتعزز تحقيقها وحمايتها.
فكرامة الإنسان منحة من الله تعالى، مرتبطة بذات خلقته الإنسانية، دون أي إضافة أخرى، من عِرقٍ أو دينٍ أو مكانةٍ، حيث يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [سورة الإسراء: الآية70].
والإنسان في القرآن الكريم هو سيّد هذا الكون بإذن الله تعالى، حيث سخر الله له كل ما في الوجود ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سورة لقمان: الآية20]. وأمر تعالى الملائكة أن يؤدوا مراسيم التحية والإكرام للإنسان احتفاءً بولادته، يقول تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ*فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ*فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [سورة صّ: الآيات 71-73].
كما قرر القرآن الكريم مبدأ المساواة بين أفراد البشر ذكوراً وإناثاً على اختلاف انتماءاتهم، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [سورة الحجرات: الآية13].
وقرر القرآن الكريم حق الحياة، وحماية هذا الحق لكل فرد، بأعلى درجة من الاهتمام والتأكيد، فاستهداف حياة أي فرد من البشر هو اعتداء على البشرية جمعاء، يقول تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [سورة المائدة: الآية32].
وكذلك حق التمتع بالحياة، وإشباع الرغبات والحاجات من خيراتها، يقول تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [سورة الأعراف: الآية32].
وبسط القرآن الكريم القول حول تقرير حرية الاعتقاد والرأي للإنسان، حيث تناولته عشرات الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [سورة البقرة: الآية 256] وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [سورة الكهف الآية 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة يونس: الآية 99).
كما أكد القرآن الكريم على الحق في العدل بين البشر، يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ﴾ [سورة النحل: الآية90]، ويقول تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [سورة النساء: الآية58].
كما قرر القرآن الكريم شراكة الناس في الاستفادة من موارد الطبيعة، واستخدام ثروات الحياة، يقول تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [سورة الرحمن: الآية10]. وكذلك حق الناس في المشاركة في الإدارة السياسية وتسيير شؤون الحياة، يقول تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [سورة الشورى: الآية38] ويأمر الله نبيه محمداً  بقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [سورة آل عمران: الآية159].
بقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [سورة آل عمران: الآية159].
هكذا يُرسي القرآن الكريم معالم منظومة متكاملة من المبادئ والمفاهيم والأحكام لتشمل كل أبعاد حقوق الإنسان، مما لم يكن مفكراً فيه قبل هذا العصر.
وكانت السنة النبوية الشريفة وخاصة في بعدها العملي المتمثل في الممارسة القيادية لرسول الله  ، انعكاساً وترجمة فعلية لإعلان حقوق الإنسان في القرآن الكريم.
، انعكاساً وترجمة فعلية لإعلان حقوق الإنسان في القرآن الكريم.
حيث كان رسول الله  يبدي الاحترام والتكريم لكل إنسان، صغيراً كان أو كبيراً، رجلاً كان أو امرأة، وإن كان مشركاً رافضاً لدعوته، ما لم يأخذ موقف الظلم والعدوان، كما تؤكد ذلك الكثير من شواهد السيرة النبوية، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [سورة الممتحنة: الآية8].
يبدي الاحترام والتكريم لكل إنسان، صغيراً كان أو كبيراً، رجلاً كان أو امرأة، وإن كان مشركاً رافضاً لدعوته، ما لم يأخذ موقف الظلم والعدوان، كما تؤكد ذلك الكثير من شواهد السيرة النبوية، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [سورة الممتحنة: الآية8].
وحينما وجّه أحد الصحابة كلاماً بذيئاً لأحد المشركين في محضر رسول الله  ، نهره رسول الله
، نهره رسول الله  قائلاً: (مه، أفحشت على الرجل، ثم أعرض عنه)[1] كما جاء في حوادث غزوة بدر.
قائلاً: (مه، أفحشت على الرجل، ثم أعرض عنه)[1] كما جاء في حوادث غزوة بدر.
ويقوم  حينما تمر به جنازة يهودي مجيباً على تساؤل أصحابه كيف تقوم لجنازة يهودي بقوله: (أليست نفساً؟)[2] . أي أن كون المتوفى إنساناً يكفي لإظهار الاهتمام بجنازته، بغض النظر عن أي صفة أخرى.
حينما تمر به جنازة يهودي مجيباً على تساؤل أصحابه كيف تقوم لجنازة يهودي بقوله: (أليست نفساً؟)[2] . أي أن كون المتوفى إنساناً يكفي لإظهار الاهتمام بجنازته، بغض النظر عن أي صفة أخرى.
وتؤكد السيرة النبوية الشريفة على ممارسة الرسول  منهج الشورى في إدارته لأمور الأمة، في مختلف المجالات، في قضايا الحرب وشؤون السلم، فكانت عبارته المشهورة (أشيروا عليّ) حتى قال بعض صحابته: (ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله
منهج الشورى في إدارته لأمور الأمة، في مختلف المجالات، في قضايا الحرب وشؤون السلم، فكانت عبارته المشهورة (أشيروا عليّ) حتى قال بعض صحابته: (ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله  )[3] .
)[3] .
وكان  يحكم بين الناس بالعدل، ويساوي بينهم في العطاء، وفي تكافؤ الفرص، حيث قلّد زيد بن حارثة منصباً عسكرياً رفيعاً، وكان في الأصل مولى مستعبداً، وكذلك قلّد ابنه أسامة بن زيد، كما جعل بلال الحبشي المؤذن الداعي للصلاة والاجتماعات، وعيّن عبدالله ابن أم مكتوم كفيف البصر إماماً يخلفه في صلاة الجماعة، وعيّن أم ورقة أماماً لصلاة جماعة النساء، وكسر أعراف التفاوت القبلي والطبقي في الزواج، فزوّج ابنة عمه ضبيعة بنت الزبير بن عبدالمطلب من مقداد بن الأسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال
يحكم بين الناس بالعدل، ويساوي بينهم في العطاء، وفي تكافؤ الفرص، حيث قلّد زيد بن حارثة منصباً عسكرياً رفيعاً، وكان في الأصل مولى مستعبداً، وكذلك قلّد ابنه أسامة بن زيد، كما جعل بلال الحبشي المؤذن الداعي للصلاة والاجتماعات، وعيّن عبدالله ابن أم مكتوم كفيف البصر إماماً يخلفه في صلاة الجماعة، وعيّن أم ورقة أماماً لصلاة جماعة النساء، وكسر أعراف التفاوت القبلي والطبقي في الزواج، فزوّج ابنة عمه ضبيعة بنت الزبير بن عبدالمطلب من مقداد بن الأسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال  : (أردت أن تتضع المناكح)[4] ، أي أن لا يتعالى أحد على أحد في موضوع التزاوج.
: (أردت أن تتضع المناكح)[4] ، أي أن لا يتعالى أحد على أحد في موضوع التزاوج.
ولم يقمع المعارضة الداخلية، في وسط ما أطلق عليه مصطلح (المنافقين)، رغم إساءاتهم المتكررة، إلا أنه لم يلجأ في التعامل معهم إلى القوة والعنف، ولم يصادر شيئاً من الحقوق المدنية لأحد منهم، بل كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة كسائر المسلمين، يحضرون المسجد، ويدلون بآرائهم في قضايا السياسة والمجتمع، ويأخذون نصيبهم من الغنائم وعطاء بيت المال.
وحين كان ينفعل بعض الصحابة تجاه استفزازات أحد من هؤلاء المنافقين، ويطلب الإذن من الرسول  لردعه وقمعه، كان
لردعه وقمعه، كان  يجيب: (دعه. لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)[5] .
يجيب: (دعه. لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)[5] .
ويمكن القول إن سيرة رسول الله  تقدم أفضل نموذج تطبيقي في تاريخ البشرية لمبادئ حقوق الإنسان.
تقدم أفضل نموذج تطبيقي في تاريخ البشرية لمبادئ حقوق الإنسان.
وإذا كنا كمسلمين نفخر بريادة قرآننا الكريم في إعلان حقوق الإنسان، وبنموذجية الممارسة السياسية والاجتماعية الملتزمة بحقوق الإنسان في العهد النبوي الشريف، فإننا يجب أن نشعر بالأسف والأسى لتخلف معظم واقعنا التاريخي والحاضر عن مستوى الالتزام بحقوق الإنسان.
ذلك لأن تاريخنا الإسلامي السياسي في معظمه، وكذلك حاضرنا، قد ابتلي بداء الاستبداد، فانعدمت فيه المشاركة السياسية للأمة، وتقلصت الحريات العامة، وسادت لغة القمع، وتلاشت قيمة الإنسان، وأهدرت حقوقه.
وانعكس هذا الواقع السيئ على الجانب الثقافي المعرفي، حيث تم تجاهل وتغييب ما صدع به القرآن من إعلان حقوق الإنسان، وما ورد في السيرة النبوية، وجرى تأويل كل ذلك وتفسيره بما يمنع تفعيله في واقع الحياة، ليبقى مجرد آيات كريمة تتلى لطلب الثواب، وسيرة شريفة تحكى للتبرك والفخر.
وتشكلت للأمة ثقافة بديلة تبرر التخلف والاستئثار بالسلطة، وتشرّع القمع ومصادرة الحريات، وتبارك إهدار حقوق الإنسان، وتخلق حالة من الممانعة للإصلاح والتغيير في أوساط الأمة باسم الدين.
وقد تأثر الفقه الإسلامي بهذا الواقع المتخلف، فتوسعت وتضخمت فيه أبواب العبادات، بينما تقلصت وتضاءلت أبواب السياسات وما يرتبط بإدارة الشأن العام للأمة.
فقد ألغى معظم الفقهاء أبواب السياسات من دراستهم وبحوثهم الفقهية، حتى لا يصطدموا بواقع الاستبداد السياسي، واختاروا الابتعاد والانكفاء عما يرتبط بالشأن العام، حتى على المستوى المعرفي، والبحث العلمي الفقهي.
وخضع بعض الفقهاء لواقع الحال السياسي، وتشكلت آراؤهم في الفقه السياسي على أساسه، وربما كان ذلك من بعضهم استجابة للترغيب أو الترهيب.
ومن يقرأ كتب الأحكام السلطانية، ومباحث السياسات في الكتب التي تناولتها، تصدمه فتاوى وآراء واضحة التباين مع مفاهيم القرآن، وتطبيقات السنة النبوية، ومبادئ حقوق الإنسان.
إن خمسة أفراد يمكنهم أن يصادروا إرادة الأمة كلها، فيبايعون أحدهم ليكون إماماً للأمة، وتنعقد إمامته، ويصبح حاكماً شرعياً تلزم طاعته، بهذا أفتى طائفة من الفقهاء، بينما أفتى آخرون بكفاية اتفاق ثلاثة أشخاص على تقرير مصير الأمة بدلاً عن الأمة كلها.
كما نقل الماوردي في الأحكام السلطانية، قال: (وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة... وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين، ليكونوا حاكماً وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بوليٍّ وشاهدين. وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد)[6] .
وهناك رأي فقهي بشرعية اغتصاب السلطة بالقوة، كما ينقل القاضي أبو يعلي الحنبلي في الأحكام السلطانية، مسنداً هذا الرأي للإمام أحمد بن حنبل في أحد النقلين عنه قال:( وقد روي عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل (في الخليفة)، فقال في رواية عبدوس بن مالك القطان: (ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه، براً كان أو فاجراً، فهو أمير المؤمنين) وقال أيضاً في رواية المروزي: (فإذا كان أميراً يُعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه إنما ذاك له في نفسه)... وقد روي عنه ما يعارض هذا)[7] .
الفقه الإسلامي هو الفتاوى والآراء، التي تحدد الأحكام الشرعية الفرعية لأبناء الأمة، والتي يستنبطها الفقهاء من الأدلة التفصيلية.
ومع أن الكتاب والسنة هما المرجع الأساس للفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، يليهما الإجماع والعقل عند الشيعة، ويقابل العقل القياس عند السنة.
إلا أن عملية الاستنباط تتأثر إلى حدٍ كبير بذهنية الفقيه وظروف بيئته. صحيح أن العمل الاجتهادي نشاط علمي له قواعده وأدواته، لكن المجتهد الذي يؤدي العمل الاجتهادي إنسان له خلفيته الفكرية ومشاعره الاجتماعية، وليس جهازاً آلياً.
وقد تحدث الشهيد السيد محمد باقر الصدر عن تأثير الجانب الذاتي في العملية الاجتهادية، مشيراً إلى أن عملية الاجتهاد يحف بها خطر العنصر الذاتي وتسرب الذاتية إليها، خاصة حينما يعالج الفقيه قضايا الواقع الاجتماعي، بما فيه من تصادم وتباين مع مؤدى نصوص شرعية، فهنا يكون خطر دخالة العنصر الذاتي أشد منه في حال معالجة القضايا العبادية الفردية.
وأشار رحمه الله إلى أربعة منابع لخطر الذاتية في الممارسة الاجتهادية:
أولاً: تبرير الواقع: حيث يندفع الفقيه بقصد أو بدون قصد، إلى تطويع النصوص، وفهمها فهماً خاصاً يبرر الواقع الفاسد.
ثانياً: دمج النص ضمن إطار خاص، قد يكون منبثقاً عن الواقع المعاش، فيختار الفقيه من النصوص ما ينسجم مع الإطار الذي سيطر على ذهنه، متجاوزاً النصوص الأخرى.
ثالثاً: تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه، خاصة في التعامل مع دليل (التقرير) والذي هو مظهر من مظاهر السنة الشريفة، ويعني سكوت النبي  أو الإمام
أو الإمام  عن عمل معين يقع على مرأى منه ومسمع، سكوتاً يكشف عن سماحه به وجوازه في الإسلام.
عن عمل معين يقع على مرأى منه ومسمع، سكوتاً يكشف عن سماحه به وجوازه في الإسلام.
لكن استنتاج الحكم من هذا السكوت يتوقف على التأكد من عدم صدور النهي من الشريعة عن ذلك السلوك، كما يتوقف على أخذ جميع الصفات والشروط الموضوعية في ذلك السلوك بعين الاعتبار، لأن من الممكن أن لبعضها دخلاً في السماح بذلك السلوك وعدم تحريمه.
رابعاً: اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص: والمقصود منه الاتجاه الذهني والنفسي للفقيه، فإن الفقيه الذي يتجه إلى تحكيم الشريعة في الحياة على المستوى الاجتماعي، يختلف في اختياراته الفقهية عن الفقيه الذي يتعامل مع الشريعة ضمن دائرة تكاليف الفرد المسلم فقط[8] .
كما تناول الشهيد مطهري هذه المشكلة بوضوح أكبر، فقال في بحث له عن (الاجتهاد في الإسلام) تحت عنوان: أثر شخصية الفقيه في فتاواه، ما يلي:
(عمل الفقيه والمجتهد هو استنباط الأحكام الشرعية، إلا أن معرفته وإحاطته وطراز نظرته إلى العالم تؤثر تأثيراً كبيراً في فتاواه. على الفقيه أن يكون محيطاً إحاطة كاملة بالموضوع المطلوب منه إصدار فتوى فيه. فإذا افترضنا فقيهاً دائم الانزواء في بيته أو مدرسته، ثم نقارنه بفقيه آخر يعايش حركة الحياة حوله، نجد أن كليهما يرجعان إلى الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم، ولكن كل منهما يستنبط حكمه على أساس وجهة نظره الخاصة.
لو أن أحداً أجرى مقارنة بين فتاوى الفقهاء، وتعرف في الوقت نفسه على ظروف حياة كل فرد منهم وطريقة تفكيرهم في مسائل الحياة، لعرف كيف أن المنظورات الفكرية لكل فقيه ومعلوماته عن العالم الخارجي المحيط به تتأثر بها فتاواه، بحيث أن فتوى العربي تفوح منها رائحة العرب، ومن فتوى العجمي رائحة العجم، ومن فتوى القروي رائحة القرية، ومن فتوى المدني رائحة المدنية)[9] .
من هنا فإن نقد الفقه الإسلامي ليس نقداً للشريعة ولذات الدين، وإنما هو نقد لما استنبطه وفهمه هذا الفقيه أو ذاك من المصادر الدينية، فالشرع المقطوع به من قبل الله تعالى كامل حق لا يصح التردد في قبوله، أو توجيه النقد إليه، لكن ما يفهمه ويستنبطه الفقيه من الشرع، هو جهد بشري محتمل للصواب والخطأ.
لذلك يختلف الفقهاء فيما بينهم في أصول الاستنباط ومبانيه، كما يختلفون في الآراء والفتاوى الفقهية، وديدن الفقهاء نقدهم لبعضهم بعضاً في مسائل الاختلاف، وهي أكثرية مسائل الفقه، لأن المتفق عليه والمقطوع به لا تزيد نسبته على خمسة في المائة من مجموع مسائل الفقه.
وللنقد دور كبير في إثراء علم الفقه وأصوله، وهو لا يعني التقليل من عظمة هذا العلم الأصيل، ولا الاستهانة بالجهود الكبيرة التي بذلها الفقهاء في تحقيق أبحاثه ومسائله. فإن من يطلع على كنوز الفقه ويقرأ عن إخلاص الفقهاء وصرف أعمارهم وحياتهم في مدارسة العلم وغمار البحث، يدرك قيمة تلك الجهود الجبارة العظيمة.
لا شك أن مجمل مسائل الفقه الإسلامي تستهدف حماية الحقوق بين الناس وإقامة العدل ، ورفض الظلم والجور.
إلا أن هناك تفاوتاً واضحاً وبوناً شاسعاً بين مستوى الاهتمام القرآني بحقوق الإنسان، وبين موقعيتها في الفقه الإسلامي، ذلك لأن نتاج العملية الاجتهادية للفقهاء، كان في الغالب محكوماً بالبيئة السياسية والثقافية السائدة في مجتمعات الأمة، تلك البيئة الخاضعة لواقع الاستبداد والتخلف.
ويجب الاعتراف بأن قضية حقوق الإنسان لم يظهر الاهتمام بها على المستوى العالمي، إلا في أعقاب الإعلان الأمريكي للاستقلال سنة 1776م، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، المنبثق من حركة الثورة الفرنسية عام 1789م، حيث كان نقطة الانطلاق لصياغة نظرية عامة متكاملة للحريات العامة.
ثم تكرّست موقعية حقوق الإنسان عالمياً بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة عام 1948م.
واللافت للنظر عدم مواكبة الفقه الإسلامي لتطور مسيرة حقوق الإنسان في هذين القرنين الأخيرين، مع ما حققته هذه المسيرة من تقدم على الصعيد المعرفي في أوساط المفكرين الغربيين، وكذلك تتابع التقدم السياسي باعتماد مواثيق حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ثم تصاعد الاهتمام بحقوق الإنسان إعلامياً وشعبياً، بتكوين منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
بينما لم تبد حركة الفقه الإسلامي أي تفاعل يذكر مع هذه المسيرة الصاعدة لقضية حقوق الإنسان.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته، لم يحظ بدراسة علمية ناقدة تؤصل موادّه وفق موازين الفقه الإسلامي.
ولم يتبنَّ الفقهاء حقوق الإنسان كعنوان لباب من أبواب الفقه يبحثون فيه ما يرتبط بجوانب هذه الحقوق من مسائل شرعية.
كما لم تجر مراجعة الفتاوى والآراء الفقهية التي يبدو منها التصادم مع ما أقرّته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على صعيد حرية المعتقد، والعلاقة مع الآخر الديني، وفي مجال الإدارة السياسية، وحول دور المرأة ومشاركتها العامة.
ولا يصح لنا أن نتجاهل بعض المبادرات التي قام بها بعض العلماء والمفكرين لمقاربة موضوع حقوق الإنسان على ضوء الشريعة الإسلامية، وكذلك انعقاد بعض المؤتمرات واللقاءات العلمية المهتمة بهذا الموضوع إلّا أنها لم ترقَ إلى مستوى الاهتمام العالمي بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن قصورها عن مقاربة الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه أغلب المجتمعات الإسلامية في مخالفته لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ولم تصل إلى حد تركيز هذا الموضوع في منهجية ومنظومة البحث الفقهي.
وأتفق هنا مع ما ذكره الأستاذ الشيخ حيدر حب الله من أن الفقه الإسلامي، كسائر العلوم البشرية، يحتاج إلى إعادة هيكلة وتبويب كل فترة، لأن تبويب الفقه وتقسيم مباحثه ليس أمراً جزافياً أو اتفاقياً عادةً، وإنما يلعب دوراً في مسيرة العلم، أو يكشف عن تصوّر له، فقد يعيق حركته، وقد يدفعه إلى الأمام، كما قد يجعله مواكباً للواقع وقد يصيّره أعجز من أن يؤثر فيه أو يصاحبه، من هنا تحتاج العلوم ـ عادةً ـ إلى هيكلة تستجيب لطبيعة التطورات من جهة، كما تدفع العلم نفسه نحو المزيد من الإنتاج من جهة أخرى[10] .
وللفقيه الراحل السيد محمد الشيرازي تجربة رائدة على هذا الصعيد، حيث أفرد في موسوعته الفقهية، أجزاء لعناوين مستحدثة في البحث الفقهي مثل: فقه البيئة، فقه المرور، فقه العولمة، فقه الاجتماع، فقه السياسة، فقه الإدارة، فقه الحقوق، وغيرها من الأبواب الجديدة التي لم يسبق إفرادها بعناوين مستقلة في الكتابات الفقهية.
إنني أتمنى على الحوزات والمراكز العلمية الدينية: بأن تضع مقرراً لتدريس حقوق الإنسان ضمن برامجها الدراسية، وأن يشرع الفقهاء بتناول موضوع حقوق الإنسان في أبحاثهم العالية، (بحث الخارج) كما يبحثون سائر أبواب الفقه، وأن تضم الر سائل العملية التي يصدرها الفقهاء متضمنة لفتاواهم فصلاً حول حقوق الإنسان، ومن الأهمية بمكان إعادة بحث المسائل الفقهية التي يبدو منها التعارض مع مواثيق حقوق الإنسان بجرأة وشجاعة، تلتزم ضوابط الشرع، وتتجاوز تحفظات الأجواء الفقهية السائدة والخاضعة لرأي الأسلاف.
والحمد لله ربّ العالمين.